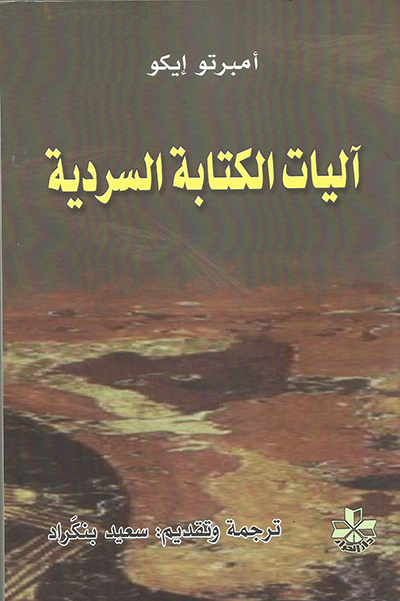سعيد بنگراد
قدم أندري لوروا-غورهان (1)، وهو من كبار المتخصصين في ما قبل التاريخ، تأويلا جديدا لما خلفه الإنسان من رسوم وخربشات ظلت لقرون طويلة تُزين جدران كهوفه وصخوره. فلم تكن التعبيرات الغْرافية الأولى، في تصوره، تجسيدا لواقعية متأصلة في وجدان الإنسان، كما اعتقد الداعون إلى الواقعية الاشتراكية، بل كانت من طبيعة تجريدية. ومن المحتمل أنها كانت موجهة للتعبير البصري عن بعض الإيقاعات الصوتية ذات القصد التواصلي الصريح. لقد شكلت هذه التعبيرات في أغلبها معادلا إيمائيا لما يمكن أن تفرزه النفس التواقة إلى معرفة محيطها والكشف عن طبيعة ظواهره ومظاهره. فلم يكن أمام الإنسان القديم سوى اليد، بكل طاقات الإيماء فيها، لكي يكتب قلقه كما يمكن أن تلتقطه العين وتحتفي به.
وقد كان ذاك هو الرابط عنده بين الوجه والإيماءة، أو ما يمكن أن يُشكل حالات تواطؤ داخل “زوج وظيفي”، بتعبيره، ه الأساس الذي يبنى عليه ال”الحجم الإنساني”، إنه يشد اللغة إلى التمثيل البصري الذي ينوع من إيقاعها التعبيري والدلالي، ويمنح العين، في الوقت ذاته، قدرة على الانفصال بذاتها ويمكنها من بلورة طاقاتها التعبيرية الخاصة خارج وظيفة الإبصار فيها. يتعلق الأمر بمضافات منتشرة في العين واليد والصوت في الوقت ذاته.
لقد كان هذا الزوج يتشكل من ثنائيتين هما مصدر طاقات الخلق والإبداع عند الإنسان: اليد/ الأداة والوجه/اللغة. إنهما النافذة والامتداد وسبيل الذات المدرِكة نحو عالم لا يمكن أن يوجد إلا من خلال وعي يستوعبه ويمنحه معنى. وهذا الترابط هو الذي يُعبر عنه عادة بالقول إن التشكيل أخرس، فهو مادة ناطقة في المفاهيم الدالة عليها، أما الشعر فأعمى، إنه لا يقود إلى استثارة مباشرة للأحاسيس التي تنبعث من الأشياء التي يتحدث عنها.
استنادا إلى هذا الزوج تشكلت، في تصوره، لغتان، لغة “السمع” المرتبطة بالحقول التي تُنسق بين الأصوات، ولغة البصر المرتبطة بالحقول التي تُنسق بين الإيماءات. يتعلق الأمر من جهة بالتباشير الأولى التي ستعلن عن ميلاد “كلام” هو حاصل المفصلة الواعية لكم “هوائي” بلا معنى. وهذا الكلام هو الذي سيطور اللغة والفكر التحليلي ويربطهما بالطولية الزمنية. ويتعلق، من جهة ثانية، بالسيرورة التي قادت إلى استقلالية الإيماءة وتحولها إلى أداة ” واعية” هي التي ستكون أساس التعبير البصري، كما يمكن أن تستوعبه العين وتجسده اليد بعد ذلك ضمن الممتد الفضائي الذي يتخذ شكل واجهة مضافة. وتلك هبة أخرى من هبات الثقافة، لقد تعلم الإنسان من مضافاتها كيف يتأمل حزنه وفرحه في ما تبدعه يداه وتفجره طاقات صوته.
وهي صيغة أخرى للقول، هناك نوع من التوازي بين البعد الوظيفي لليد وبين البعد الوظيفي للوجه، ما يشكل نوعا من التكامل بين ما يفكر فيه الوجه وبين ما تنفذه اليد. وسيقود هذا التوازي تدريجيا إلى الربط الكلي بين البصري والشفهي، أي بين الامتداد الخطي الذي تمثله اللغة الشفهية ( الامتداد الزمني) وبين التخطيط الطباعي المرتبط باليد( الامتداد الفضائي). فاليد هي التي قادت الإنسان إلى اكتشاف وسيلة جديدة للتعبير هي التخطيط الطباعي المسؤول عن ظهور الكتابة لاحقا (الرسم على جدران الكهوف مثلا والتخطيطات الموازية لها التي ستكون أصل الكتابة)، أما الوجه فهو مصدر اللغة الطبيعية.
وهذا ما يبيح لنا القول إن البصري لا يمكن أن يكون مجرد رديف للسان، كما توهم النفس طويلا، أي مضافا عرضيا يمكن الاستغناء عنه، بل هو لغة مستقلة بذاتها وقادرة على بلورة “حقيقتها” الخاصة استنادا إلى إواليات لا يمكن الخلط بينها وبين التمفصل اللفظي (نقول اليوم لغة الصورة ، أي مجمل التقنيات التي نؤولها باعتباره دالة على هذا المعنى أو ذاك).
لا فاصل إذن بين ما يأتي من العين واليد وبين ما تُعبر عنه النفس في كلمات مصدرها التمفصل الرمزي للصوت. نحن أمام نسقين الغاية منهما الجمع بين رموز مختلفة من حيث الاشتغال ومن حيث المادة، ولكنهما يقودان إلى الكشف عن الطاقة الدلالية ذاتها. لذلك ربطت بينهما كل الحضارات الإنسانية ربطا وثيقا دون أن تخلط بينهما. ففي الحالتين معا كانت هناك رغبة في التعبير عن الخبرة الإنسانية في تنوعها وغناها، يتم ذلك من خلال طاقة “التجريد” كما توده اللغة، ومن خلال “حسية” توجه الانفعال وتمنحه معنى لقد تعلم الإنسان كيف يمشي فأطلق يديه. ولكنه في الوقت ذاته أنطق الطبيعة وجعلها دالة في ثقافته. إننا نقرأ مظاهر الطبيعة وظواهرها استنادا إلى خبرة إنسانية هي حاصل التفاعل بين الإنسان ومحيطه.
وقد تنبه بعض الفيلولوجيين العرب القدامى إلى هذا الترابط وتحدثوا عن الدلالة التي تتم عن طريق اللفظ، وفصلوها عن تلك التي مصدرها الإيماءة وحدها، “فالدلالة تكون بالإشارة والرأس والعين والحاجب والمنكب، بل قد تكون في حالة التباعد بالثوب وبالسيف، وذلك في حالات المنع والزجر والوعيد والتحذير” (الجاحظ) .لذلك كان الحديث في الظلام عند بعضهم دائما ناقصا (ابن جني). فالكلمات “صامتة” بلا مرفقات في الوجه أو الإيماءة.
فكما لا يمكن الحديث عن تجربة لسانية خالية من الإيماءات، وإن وجدت فستكون ناقصة، لا وجود أيضا لتجربة بصرية خالصة، فكل عنصر من عناصر اللوحة أو الصورة مثلا محدد داخل سجل رمزي، لا يمكن في غيابه أن نلتقط سوى مثيرات بصرية بلا معنى، “فالصورة دالة في حدود وجود خزان من المواقف المسكوكة” (بارث). وهذا معناه أن السامع لا يلتفت إلى مادة الأصوات، بل يلتقط تمفصلاتها الدالة في وعيه، أي ما تحيل عليه من مدلولات، والعين لا ترى اللون بل تستنطق الانفعالات الدالة عليها( حقيقة الصوت في معناه لا في مادته، ومعنى اللون موجود في الثقافة لا في مادة تشكله).
ولم يكن هذا التقاطب أمرا طارئا في تاريخ الإنسان، بل هو حدث وجودي موغل في القدم، يشهد على ذلك كل التراث البصري الذي وصلنا منذ عهود ما قبل التاريخ بدءا بالخطوط والرسومات التي كانت تشير إلى البدايات الأولى التي تَشَكل فيها الوعي المجرد ( رسوم مغارات لاسكو في جنوب فرنسا وغيرها )، وانتهاء باللقى الطينية التي كشفت عنها الحفريات الحديثة في الكثير من الأقطار، وانتهاء بكل التماثيل الوثنية التي احتمى بها الإنسان خوفا من موت لا يخطئ موعده أو تزلفا إلى الله.
وذاك عصر من عصور النظرة في تاريخ التجربة البصرية عند الإنسان، كما يعتقد ذلك ريجيس دوبري. لقد كان المرئي في العين سبيلا ضروريا إلى اللامرئي في الوجود، وكان سبيلا أيضا إلى الوعي المجرد في النفس. لقد رفض إبراهيم أن يعبد الكوكب لأنه صغير سريع الزوال، ورفض أن يعبد القمر أيضا فهو كبير ولكنه يختفي مع التباشير الأولى لأشعة الشمس. والشمس ذاتها لا يمكن أن تكون أهلا للعبادة لأن حقيقتها ليست كلية، إنها لا تستطيع مقاومة الظلام. إن الله أبعد من كل هذا، إنه لا يمكن أن يظهر ويختفي فهو الظاهر الدائم، إنه موجود في كل مظاهر الطبيعة وكائناتها.
بعبارة أخرى، لقد كان مصدر هذه النظرة هو البحث، في هذا المرئي ذاته، عما يسمو بالإنسان عن وجود محكوم بفناء لا راد لقضائه، فكانت التماثيل هي التعويذة التي يمكن أن تقيه من الضياع في زمنية ممتدة في خَلْف وَلَّى إلى الأبد، وإلى أمام بلا أفق أو نهاية. لقد كانت الطاقة البصرية في هذه التمثيلات هي النافذة التي يستطيع من خلالها التسلل خارج الملكوت المحدود للذات. لذلك صُنِّفت الأوثان التي عبدها الناس في كل مكان، ومنها التماثيل اليونانية وتماثيل عشتار وكل أصنام الجزيرة العربية، ضمن هذه النظرة. إنها لا تحل محل الله، إنها تذكر به فقط.
وهذه الطاقة التعبيرية هي التي حولت اليد من مجرد عضو موجه لتنفيذ برنامج بيولوجي مشترك بين كل الكائنات، إلى أداة تعبيرية لا يمكن أن توجد إلا من خلال ما توحي به العين وتدعو إلى إنجازه. لقد لعبت هذه اليد ذاتها دورا مركزيا في ظهور الأداة التي ستقود إلى خلخلة العلاقة بين الإنسان والطبيعة وإدراج التوسط كمبدأ مركزي في الإدراك، لا من حيث علاقة الإنسان المباشرة مع أشيائه فحسب، بل أيضا من حيث التمثيل الرمزي لها وإعادة إنتاجها وفق قصديات جديدة. إن أي تعديل لوضع الشيء في الذاكرة معناه إدراج سياق دلالي يحيل على الرمزي فيه، أي الاستعمال المضاف. وهذا المضاف هو الذي يشكل “الحجم الإنساني” في الجسد، فما يصدر عنه هو سلسلة من “البرامج” المسبقة لن يُدركها المتلقي إلا استنادا إلى ما تعلمه من المحيط الاجتماعي والثقافي. لم تعد اليد تمسك أو تقي من شر داهم فقط ، ولم تعد أدة للحمل، إنها تعلمت من الثقافة كيف تشتم وكيف تسخر وكيف تنتج “ملفوظات إيمائية” تعبر عن أشد الانفعالات تجريدية. لقد أصبحت لغة.
وهكذا، وكما هو الشأن مع الصوت في الإرساليات اللغوية حيث إن رقة الصوت أو خشونته، الصراخ أو الهمس، يدل على حالة نفسية معينة ( دلالة مثبتة داخل السنن اللساني)، فإن الوحدات الإيمائية تُولد، انطلاقا من طرق تنفيذها أولا، ثم انطلاقا من نمط تشكلها ثانيا، تنويعات دلالية هي في الأصل أحكام ثقافية تُصنف ضمن الدلالات الإيحائية، أي الاستعمالات المضافة التي تنزاح بالعضو المنفذ عن وظيفته البيولوجية لكي يصبح حاملا لدلالة.
لذلك أمكن الحديث عن ملفوظ إيمائي موجه نحو إنتاج الدلالة والإسهام في التواصل، كما نتحدث عن الملفوظ اللساني باعتباره مصدرا للمعنى الذي تجليها المفاهيم. وتلك صيغة أخرى للقول إن الإيمائية ليست تجميعا لمجموعة من الحركات الهوجاء، بل نسق إبلاغي يتمتع بتركيب صارم ينطلق مما أودعه التسنين الإنساني في كل الإيماءات، وذاك شرط الدلالة فيها. فما يجمع بين الدوال المتراكبة فيها ليس حركية أصلية في الجسد، بل نسق ثقافي وفقه نفسر ونصنف ما يصدر عن الإنسان. إنها، بعبارة أخرى، تحيل على مدلولات تامة هي ما يلتقطه الوعي.
———
1- André Leroi-Gourhan
Le geste et la parole, éd Albin Michel