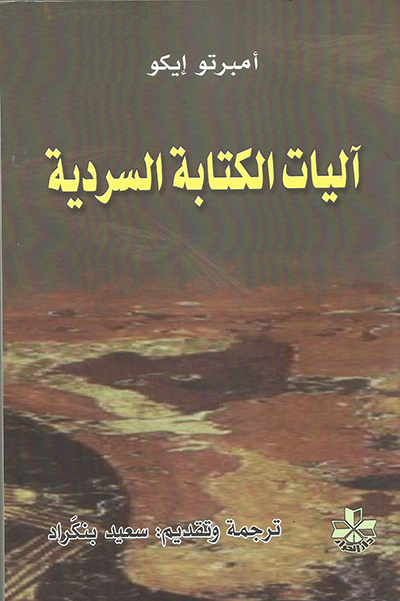شعرية التفاصيل
قراءة في رواية ” كل الأشياء” لبثينة العيسى
سعيد بنگراد
يتمتع السرد بقدرة كبيرة على نقل عوالم “حقيقية” مصنوعة من أفعال مدرجة ضمن زمنية من طبيعة خطية إلى ما يمكن أن يُبنى في الممكن من حياة تصوغها الكلمات وحدها. فالعين هي التي ترى وتميز بين الأشياء وتفصل بينها، ولكن اللغة هي الذاكرة التي تستوعب ما يحدث وما يُرى. وهو ما يعني أن التجربة الفعلية تُنتج دلالاتها استنادا إلى ما تقوله وقائعُ “موضوعية”، وهي بذلك تُصنَّف ضمن سجل يتحكم فيه تتابع زمني لا يتوقف أبدا؛ أما التخييل السردي فيلتقط صورة تُلملم أطراف انفعال جمالي يقوم على التأجيل والحذف وخلق حالات توتر هي البؤرة التي تستوعب مآلات الفعل وتُوِجهُه نحو نهاياته المحتملة. وتلك قاعدة مركزية في بناء النص السردي، فالسرد لا يقول الحقيقة، ولكنه لا يكذب أبدا.
استنادا إلى هذا التفاوت في صيغ التمثيل تُبنى الرواية، واستنادا إليها بُنيت العوالم الممكنة في رواية بثينة العيسى “كل الأشياء”. فهذه الرواية تسرد، على غير العادة، تفاصيل “وصف” هو السجل المباشر الذي تتحقق داخله أفعال الشخصيات. فليس الحدث في الرواية شيئا آخر غير حضور هذه “الأشياء” في النسيج السردي والوصفي. يتعلق الأمر باستراتيجية سردية تهب السارد مساحات كبيرة في القول هي أداته الأولى من أجل تسريب “كَمِّ معرفي” يوضع مادة للتسريد.
ومن هذه البانوراما الوصفية يستمد سلطته الشاملة في الرواية. فهو يعرف كل شيء ويتوقع كل ما يمكن أن يحدث أو ما لا يمكن أن يحدث على الإطلاق. لا يتعلق الأمر بضمير محايد يمثله “هو”، يأتي إلى الرواية من خارجها، بل هو صوت مركزي منخرط في القضايا التي تدافع عنها. فهو لا يكتفي بوصف الخراب الذي لحق كل شيء في محيط الشخصية الرئيسية فحسب، إنه يعرف مصدر هذا الخراب أيضا، ذلك أن أخطاء البطل، في وعي الرواية، ليست متأصلة فيه، بل هي وليدة نظام اجتماعي وسياسي أفسد البلاد والعباد، حسب قناعات السارد. فليس الأب وحده من يُعد فكرة، كما تردد ذلك الرواية كثيرا، إن الابن أيضا فكرة خالصة، إنه صوت آت من خارج النظام القيمي الذي تصف الرواية تفاصيله بدقة.
وهو ما يعني أن التلفظ في الرواية، أي طريقة تصريف المعرفة الملفوظية في الفضاء التخييلي، خاصية من خاصيات السارد، فهو لا يروي أحداثا فحسب، بل يسرب قناعات تخصه وتخص البطل الفاعل في الرواية، إنه صوت “العامل الجماعي” الذي ينتشر في النص باعتبار واجهاته القيمية، لا باعتبار وظيفته، فهو محفل سردي شامل يضم كل الممثلين الذين يتحركون ضمن دائرة الإيجاب القيمي كما تبنيه الرواية ( جاسم ونايف ودانة).
والعنوان مدخل مركزي إلى استجلاء دلالات التمثيل السردي، أي ما يمكن أن يوجه الأفعال ويتحكم في مضامينها. إن الرواية تضع “الأشياء” في الواجهة بحكم انتمائها إلى عالم الحياة حيث يودع فيه جزءٌ من انفعالات الشخصيات، لا بحكم موقعها في الطبيعة. فحقيقة الأشياء ليست مستقاة من خصائصها، وليست أيضا حاصل ما يحيط بنواتها من مظاهر حسية، وهي أيضا ليست جزءا من مادة تُجليها الأشكال. إن الرواية لا تدعي الواقعية ولا تكترث لإحالاتها المرجعية.
إن هذه الأشياء تنتمي في الرواية إلى مكان آخر، ذاك الذي يمكن أن تستثيره عندما تصبح مستودعا لنظام قيمي، أي عندما تتخلص من كل الحجب لتصبح مدخلا إلى تمثيل حقائق واستيهامات منتشرة في الفضاء التخييلي، بما يشمل الشيء الفعلي وأفعال الشخصيات ومواقفها وكذا الطقوس والمباني، أي الحياة بكامل عنفوانها: “كيف يمكنك أن تكفر بفكرة الوطن ثمّ تعشق تفاصيله”؟ (ص 189). وهذا لا يعني أن الرواية تقول كل شيء، بل معناه فقط أنها لا تُخفي أي شيء. فقد لا يكون جوهر الصراع هو استرداد ما ضاع، بل قد يكون فقط ألا يعطي المرء مزيدا منه.
وهذا أمر بيِّن، فبناء عالم تخييلي، كما يفعل ذلك السرد، استنادا إلى “حقائق موضوعية”، معناه الرقي بما يبدو في التجربة الإنسانية العادية عرضيا وزائلا، إلى مصاف القيم الثابتة التي يتكفل الوعي المركزي في الرواية بتخليصها من سمات الخاص والمفرد والمؤقت، ليضعها بعد ذلك للتداول باعتبارها قيمة إنسانية عامة تتجاوز فعل الأفراد ومصائرهم المحدودة. فجاسم في الرواية لا يحيل على فرد مخصوص يمشي في الشوارع، بل هو فاعل تُكثف فيه الرواية مضمون كل الفاعلين الذين ينتمون إلى الدائرة القيمية نفسها. يجب التخلص من حالات التشخيص، فذاك شرط الإمساك بالمفاهيم الدالة عليها. فالرواية معرفة مزيفة تخفي الحقيقة.
تفعل الرواية ذلك استنادا إلى مفصلة أولية تُقابل بين لحظتين في الحاضر والذاكرة. ما تُشير إليه “العودة” أولا. والعودة تُذكِّر، كما يقع ذلك في كل الحكايات، برحيل البطل الهارب من عدو أو الباحث عن “قيمة” تخص الذات أو تعود إلى الضمير الجمعي. والرحيل كان في الرواية “خدشا في الباب وصدعا في القلب” (ص11)، يحيلان كلاهما على الداخل في الذات وخارجها في الوقت ذاته، أي ما يتعلق بالصراع العائلي الذي يضع الأب غريما مباشرا للابن، وما يحيل على مواجهة نظام سياسي تصفه الرواية بأنه متخلف عن طموحات شبابه. يتعلق الأمر بالخارج ( السلطة) وبالداخل ( العلاقات الاجتماعية والصراع بين الأجيال).
لقد عاد جاسم بعد غربة طوعية في لندن ليدفن جزءا من ماضي لا يريد أن يموت، ولكنه سيستعيد زمنيته الأولى، زمنية الكتابة والنضال، الزمنية التي ستقوده من جديد إلى الزنزانة، وفي ذلك دلالة على أننا لا يمكن أن نهرب من ماضينا أبدا: ” كان قلبه يدوي، لكنه فكر بأنها فرصته الوحيدة لقتل أبيه وأنه إذا فرط بها الآن فسيبقى مطوقا بحبل مشنقة إلى الأبد” (ص 63 ). إن السلطة هنا غريم عرضي قياسا على ما يمكن أن يمثله ثقل الموروث الاجتماعي. لقد سجنه أبوه قبل السلطة، فهو لم يمنعه من القول، بل كان عليه فقط أن يقول ما يقوله هو. فلا يمكن للابن أن يكون غير ما يأتي من إرث الوالدين، تماما كما يجب على المواطن أن يتماهى مع تشريعات السلطة ومع النظام القيمي الذي يقع تحت حمايتها.
يعود البطل كالعادة بلا موعد، لا أحد في استقباله. وتلك لحظة قوية في الرواية، وفي كل الحكايات أيضا. يدخل جاسم السرد واقفا أمام بوابة الفيلا، وهي إشارة إلى فضاء البين بين: الخارج / الداخل، أو هي “البراني” الذي يتأمل “الجواني” في الأشياء الموصوفة لفظا: هناك صمت كثيف يلف الشارع والفيلا والبيوت المجاورة، ” حتى كلبُ الجيران لم ينبح” (ص11). وهو أيضا العطب المعمم: الصنبور العاطل، والزجاج المكسور والنخلة التي جف جذعها والحشائش الذابلة والأب الذي فارق الحياة.
وسيحاول عودة عكسية أيضا، ولا أحد في توديعه، وهذه العودة ستقوده، على عكس الأولى، إلى مستقره الأول داخل زنزانة السلطة وزنزانة النفس الحائرة، لقد أصبح وحيدا و”عندما يصبح المرء غريبًا عن نفسه بالكامل ينتصر النّظام” (ص 99). حينها نكون مرة أخرى أمام فضاء البين بين، ما يفصل بين عالمين. فالمطار، حيث سيُلقى القبض على جاسم، حد فاصل افتراضي بين الخارج: الحرية /السفر، وبين الداخل العودة / السجن.
يتعلق الأمر بكناية عن رحيل لم يُثمر، أو عن عودة فاشلة. هناك نوع من التوازي بين فضاء البداية وفضاء النهاية، ولكنه تواز يتم على مستوى التشخيص الاستعاري، ما يضع السرد، في البداية والنهاية، ضمن حالة إشباع لا تستتبع أي شيء، فالبطل سجين لذكرياته. ففي الماضي مستقر تُدفن فيه الأحلام: “فما يؤلمنا ليس الماضي، بل المستقبل الذي لن يحدث”(ص99). لم يكن جاسم مسلحا ببرنامج سردي يحث على الفعل السياسي في المقام الأول، إنه على العكس من ذلك، يرث برنامجا يدعوه إلى التخلص من عبء اجتماعي. لقد عاد فقط للاشتراك في مراسيم دفن والده. وذاك برنامج حصري يتحقق في المألوف، إنه يتضمن أهلية ( بالمفهوم السردي للكلمة)، ولكنها لا تُكتسب بالتمرين، بل تحصل بالوراثة وحدها.
أما اللحظة الثانية في هذه المفصلة فتشير إلى ما يمكن أن يقدمه سرد خالص يَعِد بأحداث مصدرها الماضي وحده، وهي صلب الرواية ومبررها. لم يتخلص جاسم من ذكرى هزيمته أو ذكرى هزيمة جيل بأكمله. عاد ليتذكر ويفكر ( تَرِد كلمتا تَذكر وفكر بكثرة في الرواية) ويتحرك ضمن حاضر تتردد أصداؤه في أحداث دونتها ذاكرة لا تريد أن تنسى، إنها لا تستحضر من الماضي سوى ما يشير إلى التضييق على الأحلام والرغبات. وهي الحالة التي يؤكدها مستهل الرواية. لقد اختارت الرواية نهايتها، حين حاصرت البطل بالذكريات ووجهت السرد نحو استِحْلاب الذاكرة وحدها. لذلك لا يمكن أن تكون النهاية مختلفة عن بداية تنشر الخراب والحزن في كل مكان: “وهو يعرف معنى أن يكون الإرث الذي تركه والده خرابا” ( ص223). فعندما يتقلص حجم الحاضر أو ينتفي يصبح الماضي هو الملاذ الأخير، وهو الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية الذات من التمزق والتلاشي والانهيار الكلي.
إنها إحالة أيضا على عَدَم ينتشر في جميع الاتجاهات: لقد كان من قبل “يشك في صواب الصواب وخطأ الخطأ، وصار يشك في وجود الصواب والخطأ أصلا ( ص 26). إنه يقدم نفسه في الرواية: ” جاسم عبد المحسن العظيمي، كاتب ابتلعه نفق الحبس الاحتياطي، متهم بقلب نظام الحكم وازدراء الأديان وإشاعة الأخبار الكاذبة، وتهم أخرى تتعلق بالتحريض والتقويض وهدم هيبة الدولة وأشياء لم أظن نفسي للحظة قادرا على اجتراحها ” (ص57). وبهذه الصفة /التهمة دخل السجن وخرج منه وعاد إليه.
إن الرواية تُدين السلطة، ولكنها تشكك في أحلام شباب لا يعرف كيف يتمرد. يقول جاسم عن نفسه: “فلماذا من بين جميع المعارك الّتي خاضها ضدّ الجدران والحكومة والمعارضة ووالده، لماذا جبُن عن المعركة الوحيدة ضدّ نفسه؟ لماذا تركها تنسلّ خارج حياته كما لو أنّ الأمر “أكبر منه”، وكأنّ كلّ الأشياء أكبر منه؟” (ص 287). وتلك هي مفارقات كل ثورة تبدأ في الافتراضي، إن الخصم فيه يضيع في أصوات الـمُبحرين، لذلك تتشظى الآمال في كثرتها. فهذه الثورة شبيهة بحب جاسم لدانة، لقد أحبها ولكنها لم تكن حبيبة ولا زوجة ولا جزءا من مستقبل، لقد كانت حقيقة تعيش في الافتراضي وحده. لقد ظلت هذه المرأة خارج أحلامه، كانت حاضرة في الرواية، ولكن في أصوات الآخرين، إنها بطلة بلا بطولة، رغم ما نُسب إليها من أفعال. وبذلك يكون جاسم أحد قتلتها. لا يمكن للمرء أن ينتصر على عدوه إذا كان لا يعرف نفسه.
يتعلق الأمر في الحالتين معا، بتشخيص استعاري يستعيد زمنية ولت هي ما يشكل جزءا من معارك جاسم ضد السلطة والباترياركية، ويُسقط صوتا ينتمي إلى الحاضر ويسرد مباشرة أفعالا تمتد ظلالها إلى الماضي. إن عوالم الحاضر عابرة في تفاصيل حياتية بلا معنى، أما عوالم الزمن الماضي فتُشكل الأفق الممكن للرواية. لا يعود البطل إلى الحاضر، إنه يستحضر لحظات من زمن ولى. لم تكن عودته إلى الكويت عودة إلى الحاضر، بل فرصة لاستعادة ما مضى.
فكما لم يسقط النظام تحت ضربات اندفاع الشباب، فإن موت الأب يُصبح بلا معنى أيضا، فهو لم ينهزم، لقد مات فقط. ” لقد عاد ليتمم هزيمته وحتى بعد وفاة والده مازال يشعر أنه يعيش في مملكته، لأن عبد المحسن العظيمي هو فكرة أكثر من كونه رجلا ولأن جاسم حتى بعد أربع سنوات ما زال مردما”( ص 227). فقد يكون جاسم قادرا على معاداة السلطة إلى الأبد، ولكنه لا يستطيع الوقف في الوجه النظام القيمي، لقد اضطره الموروث الاجتماعي والديني إلى أن ينغمس من جديد في طقوس الدفن، رغم كل ما يقوله السارد عن تضارب مشاعره وتوزعها على حب أب لم يختره، وعلى رفض تقاليد تأبى التغيير.
وحضور المردم في الرواية بالغ الدلالة. إنه الطائر الأليف الوديع المسالم، إنه سهل الاصطياد. ولكنه يُعد، في الوقت ذاته، تعبيرا عن البله والغباء وسوء التصرف. ولكن الاستعارة تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تنشيط ذاكرة الطائر نفسه، فحسب ما يقوله الكويتيون، يدخل المردم المصيدة طوعا، فهو يتسلل إلى البيوت الطينية، ولا يعرف كيف يخرج منها ويسهل على الصبية اصطياده. واستنادا إلى سلوك الطائر يمكن تعميم هذه الصفة على شباب بأكمله، فهو يعرف مصدر مآسيه، ولكنه لا يعرف إلى أين يمضي. يتساءل جاسم لحظة العودة: “إن كان المردم يعود إلى قفصه للمرّة الثانية؟ لم غادر القفص أصلًا ؟ أي قفص منهم” (ص 15). هو يدرك إذن أن الداء في الداخل وليس في السلطة وحدها.
هل هي عودة إلى الذات أم عودة إلى الوطن أم هي في واقع الأمر إقرار باستحالة الهروب من نظام قيمي يحيط بحياة الناس من كل الجوانب. إننا أمام صورة كلية لهزيمة مستمرة في التاريخ يحاول الشباب إيقاف نزيفها. كل شيء يدل على استنفار لطاقات هووية تقود الذات إلى الانتشاء بانتصار عابر ( موت الأب): ” ترى هل مازال يريد دفن أبيه كما لو أنه يريد قتله ” ص 62)، ولكنه يفعل ذلك بإحساس من يرى عدوه يُقتل بيدي غيره ( الإسقاط الرمزي لانتصار الدولة) “: تقول الأم “سبحان الله هو راح وأنت جيت” ( ص 27). يتعلق الأمر بإحباط داخلي لا يمكن أن يتخذ كامل أبعاده إلا من خلال نشره في محيط الشخصية. لقد جفت جذور النخلة، ولكنها لن تسقط من تلقاء نفسها أبدا.
وهي صيغة أخرى للقول إن الماضي لا يمكن أن يُستعاد إلا من خلال انسحاب طرف في معادلة لا يمكن أن تستقيم من خلال حديها. إن السرد محجوز منذ اللحظات الأولى، إنه لا يتقدم إلا من خلال استعادة ما وقع، وهو كثيف، لأنه يمتزج بالوصف إلى حد يصبح فيه اللاقط البصري هو السبيل الوحيد للإمساك بالخيط السردي ( التوقف طويلا عند جنازة الأب). وعندما يُطلق من إساره ويعود البطل إلى ممارسة هوايته الأولى، يتوقف الحكي، وتنتهي الرواية. وهذه هي معادلة الرواية، علينا البحث عن الحبكة في الوصف لا في السرد، فهو الذي يقودنا إلى بناء حدث لا نرى منه سوى الآثار.
وهذا معناه أن الشخصية في الرواية تكتفي بتنفيذ برنامج يقع خارجها. يقف جاسم، في الكثير من الحالات، ليرى ما يحيط به، وتنساب كلمات السارد لتصف ما يراه ويسمعه. وبذلك توازي الرواية بين ما يوده الفعل السردي الذي يسير بالرواية إلى مآلها الحتمي، وبين ما يقتضيه وصف يشير في العادة إلى الفضاء الذي يحتضن أفعال كل الشخصيات. لا تتحقق السردية من خلال حدث بعينه، كما يمكن أن نتصور ذلك، بل يُستوعب الحدث ضمن فيض تذكري يتضمن السردية ويوجهها إلى ما يوده الوعي المركزي في الرواية. لا يستطيع القارئ في الكثير من الحالات فصل صوت جاسم عن الصوت الذي يحدثنا عنه.
ومن هذه الزاوية يمكن الإمساك بالتقابل بين ما يقوله ظاهر الرواية، صراع بين السلطة وشريحة واسعة من شباب يحس نفسه خارجها، وهي معرفة مرئية في الحدث ذاته، وبين الظلال الرمزية التي توجه هذا الصراع ليشمل النظام القيمي كله: تتحدث الرواية بالضمن عن شباب يعرف كيف يعارض، ولكنه لا يعرف ما يريد. إنه يعرف مم يهرب، ولكنه لا يعرف إلى أين يمضي. لم يكن الأب وحده من رأى في هؤلاء الشباب صبية لم يتخلصوا من بامبرس، هم أنفسهم أدركوا ذلك فمشروعهم بل كان أحلاما بلا أفق سياسي يوجهها.