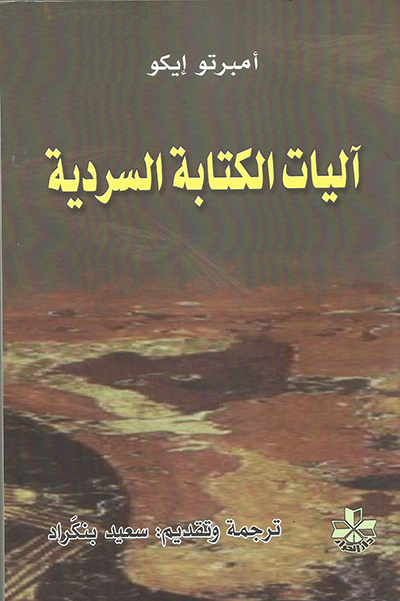9_ ستعرف السنة الدراسية المقبلة اعتماد نظام جامعي جديد أهم ما فيه أن الإجازة ستصير أربع سنوات بعد أن كانت ثلاثا؛ وستسمى الباكلوريوس عوض الإجازة وسيكون تقويم المعارف على ما يسمى الأرصدة القياسية…كيف تتلقى هذا بالنظر إلى الوضع الجامعي الحالي؟ وفي نظرك متى يمكن أن نقول إن الجامعة المغربية قد أخذت فعلا سكة صحيحة؟
ج-لا أعرف تفاصيل هذا الإصلاح الجديد، ولكنه لن يكون مختلفا عن الصيغ الإصلاحية السابقة، فالذين يفكرون في الإصلاح لا علم لهم بواقع الجامعة المغربية ولا يعرفون ما يجري في مدرجاتها وفصولها، ولا علم لهم بالكفاءات التي تدرس فيها. وربما سأكرر ما قلته أعلاه: كل إصلاح لا ينطلق من تفكيك دقيق لواقع الحال في الجامعة المغربية لا يمكن أن ينجح. فالوصفات الآتية من الخارج لا يمكن أن تنجح لأن نجاحها في موطنها لا يعني بالضرورة إمكان نجاحها عندنا. هناك تفاوت كبير بيننا وبينهم في كل شيء: هناك فساد معمم في الجامعة المغربية وصلت آثاره الآن إلى هيئة التدريس نفسها. فهل نذكر بقلة الموارد البشرية والمادية وبالتفاوت في العقليات، فنحن نشكو من خصاص حضاري كبير على المستوى اللغوي والاجتماعي والسياسي(مازال المغاربة يختارون ممثليهم بالقفل والسيارة والبراد…). هناك تدني في المستوى المعرفي لطلبتنا. وهناك بالإضافة إلى ذلك المحسوبية والزبونية التي تتحكم في كل شيء بما فيها التوظيفات والشهادات.
10-انشغلتَ خلال هذه المسيرة بتحليل أنواع مختلفة من الخطاب.. وكثيرون يلاحظون اليوم عودة الخطاب الشعبوي للساحة السياسية المغربية. ما أهم ما يمكن أن تسجله على الخطاب التواصلي السياسي المتداول عندنا؟
ج-الشعبوية ظاهرة عالمية، إنها من مخلفات عولمة بخست العمل الفكري والسياسي، إنها جواب خاطئ عن مشاكل حقيقية، إنها تقسم المجتمع إلى طرفين: نخبة مرتشية وفاسدة في مواجهة شعب يتميز بالطهرانية والتقديس. وهي بذلك حالة مَرَضية في تاريخ الإنسانية، لأسباب عدة منها أنها تبسيطية وتكره الفكر المركب، فهي تنطلق، كما ذكرت أعلاه، من مشاكل حقيقية، ولكنها تقترح حلولا تتناقض على المدى المتوسط والبعيد مع طموحات معتنقيها( كل الفاشيات القديمة كانت شعبوية). وهي مرضية أيضا لأنها تعتمد الشوفينية وكراهية الأجنبي والتمجيد المثالي للوطن، بل وتسخر من الفعل السياسي ذاته، فهي معادية للإيديولوجيا بمفهومها السياسي، لا بمفهومها التضليلي. وما ساعد على نموها وتطورها سقوط الوسيط السياسي والنقابي أو تراجع أهميته في المجتمع، فالدولة لم تعد تحاور مؤسسات تتمتع بصفة التمثيلية، بل تصطدم بشعب يعرف كيف يحتج، ولكنه لا يعرف كيف يفاوض أو يحدد أولويات نضاله، ويكون بذلك عرضة للتضليل. بل قد تتخذ الشعبوية مظهرا طائفيا أو عرقيا، يلغي الوطن ويدعو الناس إلى العودة إلى الطائفة أو إلى تمجيد انتماء عرقي أثبت العلم الحديث والممارسة الإنسانية بطلانه.
وقد اتخذت الشعبوية في المغرب مظاهر متعددة منها الانتماء الفئوي الذي يتردد الكثيرون في تصنيفها ضمن هذه الظاهرة، ومع ذلك فهي كذلك لأنها تمتح الكثير من عناصرها وممارساتها من هذه الظاهرة. فلم يعد العمل النقابي مؤسسا على مطالب وطنية تخص فئات من الشعب توازي بين الحقوق والواجبات والممكن والمستحيل، بل على احتجاج مرتبط بمصلحة تخص فئة معيّنة دون اعتبار لكل التقاطعات مع فئات أخرى أو مع المصلحة العامة (خلق التنسيقيات التي حلت محل النقابات). حدث هذا عند الأساتذة والأطباء والكثير من المهن والفئات الشعبية. يتعلق الأمر بشعبوية ذات بعد احتجاجي يمجد الانتماء إلى الفئة لا إلى الجسم الاجتماعي العام.
ويحتاج الأمر للحديث عنها في السياسة إلى مساحات أوسع مما هو متاح لنا هنا، ومع ذلك هناك مثال يمكن الإحالة عليه؛ فظاهرة بنكيران يمكن تصنيفها بهذا الشكل أو ذاك ضمن نوع من الشعبوية، من حيث طبيعة خطابه السياسي الذي تخلص من التاريخ الوطني لكي يستحضر تاريخ العقيدة، ومن حيث الفئات المستهدفة حيث حلت محل الموظف والعامل والفلاح والطالب، مقولات جديدة هي المسكين والفقير واللي ما في حالوش وغيرها. فهذه تتضمن موقفا مسبقا يستمد قوته من الانفعال لا من الدور الاجتماعي. فالخطاب السياسي عنده لا يتحدد من خلال يسار أو يمين أو وسط، بل من خلال الانحياز إلى الفقراء.
11- على ذكر مخلّفات تبخيس العمل الفكري والسياسي… قلتَ مرة إنه مقابل تراجع خطاب المثقف هناك ميلاد لخطاب الخبير الذي نراه يوميا للتعليق على الأحداث.. هل الأمر يتعلق بسطو على الألقاب ولعب بالمفاهيم أم هو مسألة موضوعية ونتيجة لتغير الواقع وتغير طريقة معالجته؟
ج-لا يتعلق الأمر بسطو، فالثنائيات التي تحدثت عنها كانت موجودة دائما، فالخبير كان موجودا وكذلك الإنسان المستهلك ورديفه المحتج والمواطن والمناضل. ولكن بعد أن سقطت أو تراجعت مجموعة من المحكيات، وقد كانت أصلا أحلاما قادت أجيالا من الرجال والنساء إلى الانخراط في معارك من أجل مجتمع أكثر إنسانية وأكثر حفاظا لكرامة الناس، لم يعد المجتمع في حاجة إلى المثقف، كما تراجعت قيمة المواطن قياسا على المستهلك. وعوض أن نناضل، أي نختار قيما ومبادئ ندافع عنها، اكتفينا بالاحتجاج. يعتقد كل الناس، في الزمن الراهن الذي يطلق عليه الكثيرون “الزمن الحاضر” (أو اللحظة الأبدية) -حيث الاحتفاء باللحظة مفصولة عن دفق يشد ماضيا إلى مستقبل- أنهم “يعرفون” ويفهمون كل شيء. وهذا ما يتضح من وجود وفرة في ” الخبراء” الآن في الإعلام المغربي، وهم في الكثير من الحالات لا يقولون أي شيء، ولكنهم يختفون وراء يافطة الخبير المختص في كل شيء، لكي يقولوا ما توده السلطة في الغالب. وقد كنت قد شرحت هذا في مقال سابق أوضحت فيه أن الخبير في أوروبا كان نتاج تحول من المثقف “الكوني” صاحب الوظيفة الاجتماعية، إلى ما يسميه ميشيل فوكو “المثقف المختص” الذي يبيع معرفة، وهي معرفة حقيقية، ولكنها تخلصت من الاجتماعي والإنساني فيها. وهذا ليس حال الكثير من خبرائنا.
12- تقصد ان الخبير بالمعنى السائد حاليا هو شخص تتوفر لديه المعلومات، لكنه يفتقر للمعرفة –في الغالب-وفي خلو من أية وظيفة اجتماعية كما كانت لدى المثقف؟
ج- هو كذلك في الغرب، وفي المغرب جزئيا، فهناك خبراء في المغرب يعرفون موضوعاتهم جيدا، ولكنهم ليسوا معنيين بالسياسة والأخلاق والقيم. فلا موقع لليسار واليمين والوسط في خبرتهم، فالأساسي هو الاستجابة لما يطلبه صاحب الخبرة.
13- لكن هل مازال للثقافة من معنى في الزمن الراهن أو هذه اللحظة التي وصفتها بالأبدية، حيث الذي يحتل الوجاهة هم البلوغرز واليوتوبرز والفلوغرز؟
ج-بالتأكيد ما زال للمثقف موقعه داخل الفضاء الاجتماعي. وسيظل كذلك في المدى المنظور والبعيد أيضا. وهذا ما تؤكده الكتب التي صدرت في الفترة الأخيرة، وكلها تحذر من خطر “الشهرة” المزيفة ومن الشعبوية ومن الميل إلى الاستهلاك المفرط، ومن الانغماس في تواصل مفرط يخفي في حقيقته أزمة في التواصل، وذاك دليل على أن المقاومة موجودة وستتخذ أشكالا متنوعة. نحن لسنا ضد التقدم ولسنا ضد منافع التكنولوجيا، ولكننا ضد أن يفقد الإنسان نفسه وروحه ولغته. فقد يشكك الناس في اليسار واليمين وفي الإيديولوجيات وكل أشكال الاعتقاد، ولكنهم سيظلون مع ذلك يميزون بين الخير والشر وبين الصدق والكذب. ربما لم تعد مقولة المناضل تغري كما كانت، بل لم تعد دليلا على خلق أو مبدإ فعلي، ولكن الشرفاء موجودون ويخترقون كل التصنيفات القديمة.
14- هذه المقاومة موجودة فعلا وبأشكال متنوعة، في هذا الصدد ألا ترى أن كل ما أفرزته ثورة التقنيات والاتصال سيبدأ في أكل نفسه بنفسه.. وسائل التواصل الاجتماعي مثلا التي قلبت كل المعايير وأتاحت الفرصة للجميع سرعان ما بدأت تصيب الناس بالفزع والكثيرون اليوم يريد الفرار واستعادة حياته خارجها؟
ج-لا أحد يستطيع إيقاف التقدم، ولا يمكن أن نُلغي من حسابنا ما جاءت به الرقمية بمحاسنها ومساوئها. فنحن أسرى ما تبدع أيدينا. ومع ذلك بإمكاننا ترشيد استعمالها، فالمشكلة في المجتمعات، وخاصة المتخلفة منها؛ ليست الرقمية في ذاتها بل في الكثير من الأمراض التي يعيشها الناس ومنها النرجسية والرغبة في الاعتراف وحب الظهور والميل إلى الفرجة التي تجعل الناس يحتفون بالظاهر ضدا على ما يمكن أن يُبْنَى في الكينونة. والذين يستهجنون ما نقوله لا يدافعون عن مبدإ في واقع الأمر بل يبررون سلوكا. والحال أن نقاش مبدأ ما يجب ألا يتنكر للحقائق، بل يجب أن ينطلق منها، فهي أساس التحليل. وهذا ما يقوم به الكثيرون الآن في الغرب، فقد دق الكثيرون هناك ناقوس الخطر، وحذروا الناس من الأخطار التي تهدد كينونتهم وحميميتهم. ومن هؤلاء ما يطلق عليه “الهاكر المناضلون”، وأصحاب الضمير (إدوارد سنودن الذي تمرد على جهاز المخابرات الأمريكية وفضح أساليبها في التجسس على كل الناس). ومن بين هؤلاء أيضا مارك دوغان وكرستوف لابي اللذين صاحبا “الإنسان العاري”، وإلزا غودار صاحبة “أنا أوسيلفي إذن أنا موجود” وغيرهم كثير.
15- إذا عدنا إلى السرد وهو مجال اشتغالك الأول أكاديميا وأيضا من خلال حضورك مؤخرا في لجان تحكيم جوائز أدبية مرموقة في العالم العربي؛ ما الذي يثير انتباهك أو ملاحظتك في السرد الذي يكتب الآن بالعربية خاصة من الأجيال الجديدة؟
ج-في الواقع لم أطلع على الكثير من هذا السرد. ولكنه يشكل في جميع الحالات تجربة تستحق المتابعة. وما يمكنني قوله هو أن كتابة القصة أو الرواية ليست امتلاك كفاية سردية تتحقق في تقنيات قابلة للحفظ، بل هي في المقام الأول معرفة تخص المجتمع والإنسان. لذلك الموهبة وحدها ليست كافية، بل هناك الجهد والتصَنُّت لوجدان الناس والاحتكاك بالمحيط هو الذي يقدم لنا إبداعات كبيرة.
16- نختم بالسؤال المؤرق والذي يتجدد كل مرة عن أزمة القراءة ونحن على بعد أيام قليلة من اختتام معرض الكتاب.. ماذا تقول لنا عن القراءة وهي ممارسة يومية لك وفعالية وطقسا لا غنى عنه؟
ج-القراءة تراجعت في العالم كليه، ولكنها اتخذت عندنا أشكالا تنذر بكارثة حقيقية لا يدرك هولها إلا من يعرف أننا لا يمكن أن نعيش بتجربتنا وحدها. فحياة الإنسان قصيرة جدا، لذلك لا يمكنه أن يعيش كل التجارب ليستوعب معنى حياتهه الخاصة، فقراءته للشعر والرواية والمسرح والمذكرات وغيرها من فنون القول والفكر ليس ترفا، بل ضرورة، إنه يتعلم من خلالها كيف ينتمي إلى ثقافته وثقافة الآخرين، بل ويتعلم كيف ينتمي إلى قيم الإنسانية كلها. وهذا ما عبر عنه أومبيرتو إيكو بقولته الشهيرة : “من لا يقرأ سيعيش حياة واحده هي حياته، أما الذي يقرأ فإنه سيعيش 5 آلاف سنة”. وكان يشير بهذه الخمسة آلاف سنة إلى تاريخ الكتابة.