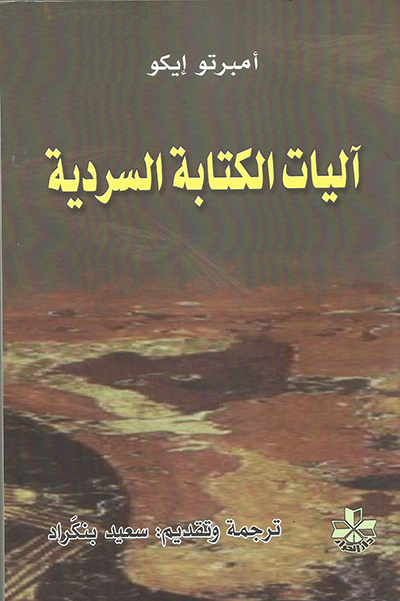س- يطالع مشاهدي مباريات كأس العالم إعلان إشهاري يصور تمثال المسيح الفادي بريو دي جانيرو وهو ينحني ويضرب الكرة. إلى أي حد حول اقتصاد الإشهار الرموز الدينية ونجوم اللعبة الأكثر شعبية في العالم إلى مجرد حوامل لترويج المنتوجات التجارية؟
ج- ما تشير إليه ليس غريبا عن آليات “التواصل” الإشهاري، فالوصلة فيه قائمة أساسا على ما يسميه أحد الباحثين في هذا الميدان “القرصنة” أو “الإقناع السري”( فانس باكار). فالإشهاري لا يضع للتداول مادة منفصلة عن السياق الاستهلاكي، فلا قيمة للمادة الاستهلاكية خارج النموذج الحياتي الذي تبشر به، والصورة في هذا الميدان لا “تستثير” انفعالات فحسب، ولا تشرح البعد اللفظي بإضافة “جزئية بصرية” تتعرف عليها العين في ما هو مودع في التسميات والتعليق المصاحب، إنها تُبلور، بالإضافة إلى ذلك، “معنى” يتخلص من خلاله المنتج من نفعيته ليصبح دالا داخل سياق ثقافي واجتماعي، وتلكم هي الطبيعة الأساسية للإشهار، ولا يمكننا أن نلومه على ذلك.
ولكن للمسألة بعد آخر، فعندما نتجاوز حدود ما يُسمى “القياس”( la mesure)، أي العتبة التي لا يمكن تخطيها دون التشكيك في قيمة الوجود الإنساني خارج الاستهلاك المادي، فإن الأمر يمكن أن يهدد وجودنا ككائنات متحضرة لا يشكل الاستهلاك في حياتها سوى بعد بسيط. وهذا بالضبط ما يتم الآن تخطيه بجرأة ووقاحة قل نظيرها عندنا وعند غيرنا، كما هو الأمر مع المثال الوارد في سؤالك. فقد لا يكون ضارا، بالمعنى الأخلاقي، أن يصرح الإشهاري أن عطرا ما قد يجعل المرأة محبوبة، أو أن مادة استهلاكية ما تعيد لها شبابها، ففي هذه الحالات لا يتجاوز الأمر مغالاة قد يسخر منها العقل ويستهجنها الحس السليم، ولكنها لا تشكل خطرا مباشرا على مكونات وجود ما.
س – أين يكمن الخطر إذن؟
ج – عندما يعمد الإشهاري بشكل ممنهج إلى تخريب الوجدان والذاكرة من خلال استعمالات كاريكاتورية للرموز التاريخية والدينية والوطنية، والعبث بأبطال التاريخ القوميين أو العالميين وأمجادهم. ففي هذه الحالة يصبح الأمر ضارا بالحرف وبالمجاز. لأن الأمر يتعلق بالتشكيك في الذاكرة القريبة والبعيدة، وتسفيه كل ما لا يدخل ضمن الاستهلاك المباشر الذي يقوم على حسية تقصي من دوائرها البعد الرمزي بمفهومه النبيل، أي كما تبلور منذ آلاف السنين، وتعويضه برمزية مزيفة بلا قيمة.
إن الإشهاري في هذه الحالة يخلط بين وضعيات تافهة وعرضية في الوجود، وبين مواقف سجلها الضمير الإنساني واحتفى بها. فأن “نحط” من رمز ديني ونحوله إلى لاعب للكرة، معناه أن نعادل بين المسيح وبين ميسي، وأن نربط كل عوالم الأم وحنانها بقنينة كوكاكولا، معناه أن نضع كل عوالم الأمومة في مقابل قنينة: وكأن الوصلة تقول : بقدر ما نحب أمنا نحب كوكا. وأن نربط “أحمر” كوكاكولا بـ”أحمر” العلم الوطني، معناه أن نمنح كوكا الحب نفسه الذي نمنحه للوطن، ذلك أننا نُصَرِّف عبر هذا اللون حالات العنف الجسدي من خلال الإحالة على حالات الانفعال التي يستثيرها حب الوطن (الوصلة المشهورة “بعد الماتش غادي نرجع نورمال”). وهذا معناه أن الوطن عارض في الوجدان، كما هو عارض العطش الذي ترويه كوكا.
فمن أجل الترويج لمنتجات، هي في أغلب الأحيان نفعية ووظيفية، يستعين الإشهاري بأحاسيس ومشاعر كونية هي جزء من إنسانية الإنسان: يُختصر الحب أحيانا في أحمر الشفاه، ويدل الحرير على الحرية، ويوحي العطر دائما بلحظة جنسية. يتعلق الأمر، كما يقول جورج بينينو بـ”تخريب فعلي للمعنى” وللوجدان. وبهذا، فإن الإشهار لا يساعد على الشراء كما يوهمنا الإشهاري بذلك، إنه يودع الوهم والاستيهام والحلم المزيف في الأشياء والكائنات التي يعرضها على المستهلك.
لذلك فهو لا يكتفي بالنيل من الأبطال الحقيقيين والتقليل من شأنهم، إنه يعوضهم بـ”أبطال” يعيشون في صور حسية يمكن استبدال بعضها ببعض بسهولة. ألا يكون، من باب الاستهتار بالفضائل الحقيقية أن ننسب معارك وملاحم إلى أبطال ليسوا في نهاية الأمر سوى “أبطال للقمامة”؟
س – ثمة في حديثك ما يكشف عن نزعة استحواذية هي ما يتحكم في عمل الإشهاري، ومن خلفه الرأسمال، ألا يلعب السياسي اللعبة نفسها مع “الحشود” حين يتماهى مع المشهد الكروي ويشارك في “الكعكة” (ميركل وهي تشجع المنتخب الألماني في المدرجات كمثال). هل يتعلق الأمر بتلميع الصورة L’image انطلاقا من هذا الحضور الدائم للسياسي في قلب الصورة la photo الاستحواذية ؟
ج – تجدر الإشارة في البداية إلى أن الإشهار لم يعد وسيلة تقنية لبيع مادة نفعية موجهة لاستهلاك مباشر. إنه اليوم يسوق كل شيء: المنتجات الاستهلاكية والأفكار وأشكال السلوك و”لوك” الرياضيين والسياسيين. لاشيء يمكن أن يفلت من سلطانه. لقد كان “الريكلام” القديم يكتفي بالترويج لمنتجات تقوم بوظائف صريحة في حياة الناس، بما فيها المبالغة والكذب والتمويه، ولكنه، شأنه في ذلك شأن البراح في الأسواق، لم يكن يكترث لسياقات البيع وسياقات الاستعمال، أو لا يفعل ذلك إلا بشكل محتشم، أما الإشهار الجديد فمن طبيعة أخرى، إنه محايد في البيع لا في الإيديولوجيا، إنه لا يبيع فقط، بل يوفر السلوك والمواقف الحاضنة لما يمكن استهلاكه أيضا.
وقد قاد سيغيلا، وهو من أكبر الإشهاريين الفرنسيين الجدد، حملة ميتران الانتخابية سنة 1981، وبعد فوز ميتران في هذه الانتخابات توجه إلى الفرنسيين قائلا : “لقد بعتكم ميتران”. انطلاقا من هذه اللحظة التاريخية سيعرف الإشهار منعطفا حاسما: أصبح التواصل في ميدان السياسة تواصلا إشهاريا وليس سياسيا فقط، تواصل تلعب فيه الفرجة والتكتيك اللفظي والحضور البصري دورا مركزيا. فلم يعد السياسي يكتفي بتقديم برنامج لكي يثق الناس فيه، يجب أن يخلق الفرجة التي ” تُجسد” هذا البرنامج، فمن خلالها تنبع “الحقيقة” التي يعتقد فيها الناس. لقد قدم سيغيلا إلى جمهور الناخبين “اللوك” السياسي، أي حضور “الرئيس” في الفضاء العمومي من خلال “لقطة لفظية” قوية، ومن خلال “صورة” بالمفهوم المزدوج للكلمة، أي بما يمكن أن يحيل على الفكرة التي يكونها الجمهور عنه، وبما يحيل على “فرجة” بصرية تُعاد من خلالها صياغة البرنامج (صُورة ميتران بلقطة جانبية ينقاد لها المتفرج من خلال لافتة لفظية ” القوة الهادئة”).
س – هل يعني هذا أن ميدان الإشهاري توسع إلى درجة التماهي مع السلطة السياسية ودوائر صنع القرار؟
ج – يجب أن يعرف الناس أن النموذج الذي أشرتُ إليه سيعمم من خلال إشهار مباشر، ومن خلال إشهار مقنع تصنعه بعض اللقطات العابرة التي تسجل حضور السياسي في الفضاء العمومي، بما فيها ملاعب كرة القدم وغيرها ، ما يسمى هادة استراتيجية التواصل. وهناك لقطات كثيرة احتفظ بها التاريخ في هذا المجال: منها “صرخة الفرح” التي عبر عنها رئيسا الدولة والحكومة في فرنسا (شيراك رئيسا للجمهورية وجوسبان رئيسا للحكومة) يوم “انتصرت” فرنسا على البرازيل سنة 1998 وحازت على كأس العالم. ومنها أيضا “فرحة ميركيل في المونديال الحالي وهي تنتفض من مكانها احتفاءً “بانتصار” ألمانيا على البرتغال. تتضمن هذه اللقطات كل شيء: فيها عودة إلى “المعتاد” الاجتماعي، وخروج من “برج” السياسة”، وفيها “فرحة” الطفولة و”عفوية” الانفعال الذي يكشف عن انتماء عميق للوطن (هو انتماء للتيار السياسي الذي يمثله في الواقع). وفي المجمل، نحن أمام دعاية إشهارية مقنعة تسوق لصورة سياسي ليس “منفصلا” عن “هموم” الشعب. وسيلتقط الناس البعد الرمزي في هذه الصورة، أكثر مما تغريهم حاجات نفعية مباشرة. لذلك سيتذكر الناس ميركيل كلما تذكروا انتصارات ألمانيا، ولو كان ذلك في مقابلة واحدة.
س-هل يعني هذا أن السياسة أصبحت قابلة للتسويق هي الأخرى؟
-نعم ، إن السياسة منتج يشبه باقي المنتجات. وفي هذا المجال أيضا لا يختلف الأمر كثيرا عن التسويق لمنتجات الحياة المادية، فنحن نربط بين فتاة ومشروب ما، بحيث كلما شربنا هذا المشروب تذكرنا تلك الفتاة، ونحن نتذكر شيراك كلما تذكرنا انتصار فرنسا في مقابلة. فمحل الزبون التجاري نضع الزبون السياسي، إننا نبيع رؤساء إلى حشود تجذبها الصور أكثر مما تغريها المفاهيم العقلانية. وفي جميع الحالات فإن الصورة الإشهارية، قصدية كانت أم عرضية، تُستخدم كحلقة وصل بين واقع سياسي أو اقتصادي، وبين رغبة “المستهلك” في أن يكون أكثر من مجرد فرد.
س – أنت من الموقعين مؤخرا على بيان حماية العربية إلى جانب ثلة من أبرز المثقفين المغاربة. كيف تقرأ هذه “اللغة الجديدة” المستعملة في الإشهارات التي تكتسح الفضاء العمومي والمكونة من دارجة مكتوبة بأحرف فرنسية؟
ج – لقد سبق أن أجبت عن هذا السؤال. فقد كتبت قبل أن يدعو الإشهاري المعروف إلى استعمال الدارجة في المدرسة مجموعة من المقالات حول اللغة، منها واحدة خصصتها لهذه القضية بالذات (الدارجة في الإشهار). وكانت الخلاصة أنه على عكس ما يصرح به الإشهاريون، فإن الغاية من استعمال الدارجة في الوصلات ليست تسهيل التواصل مع كل فئات الشعب، فهناك مجموعة كبيرة من المنتجات موجهة إلى شرائح اجتماعية نالت حظها من التعليم وتعرف القراءة والكتابة وليست في حاجة إلى أن “تتهجى” لكي تتعرف على مضمون الوصلة، بل يتعلق باستراتيجية تتجاوز حدود الإشهار والمدرسة لكي تستوعب داخلها ال تصور الذي يملكه البعض عن المواطن المغربي وحاجاته. إنهم يودون العودة به إلى الانغماس في حالات “حسية” ينجذب من خلالها المستهلك إلى اللحظة الاستهلاكية في انفصال كلي عما يمكن أن تأتي به الموحيات والتمثيلات الرمزية.
وأمر اللغة في جميع الحالات ليس ترفا، فاللغة ليست أداة يمكن استبدالها بأخرى، أو يمكن التخلص منها بعد استعمالها، إنها الوجدان والهوية والوعي وواجهة يتميز من خلالها المتعلمون عن الأميين، والمتحضرون عن المتخلفين. ولها خصوصية في ميدان الإشهار بالذات، فقد سبق أن أشرت أعلاه إلى أن الخطاب الحامل أهم من المنتج. لذلك كلما انزاحت اللغة عن الوصف والتعيين المباشر للكائنات والأشياء، تعمقت الهوة الفاصلة بين العين وما يأتيها من التمثيل البصري. فعندما تستطيع الصورة، من خلال طاقتها ومن خلال اللفظ المرافق لها، الانزياح عن المحاكاة والاستنساخ الحرْفي للمنتج، تكون دائرة التمثيل اللفظي قادرة على استيعاب ممكنات الخزان الإيحائي داخلها.
س – المسألة ليست بريئة إذن، ولا تروم تحقيق أكبر قدر من التواصل؟
ج – بالتأكيد، فالوصلة الإشهارية المُدَرَّجة لا تحتفظ سوى بالتقريري الفج والصريح والواضح للعيان. إنها تكتفي بتشخيص “فَرْحَة” الامتلاك أو الاستعمال. وهي فرحة لا تختلف في جوهرها عن فرحة الأطفال الذين يُقبلون على الشيء في ذاته، لا على صورة رمزية منه. وكنت قد شبهت هذه الحالة بما يمكن أن تحيل عليه الحكمة الشعبية: “الحر بالغمزة” و”العبد بالدبزة”. إن “الغمزة” لغة توحي وتُضمر وتُلمح، في مقابل “دبزة” تؤلم وتنبه بالقوة، “الغمزة” إيحاء ومعنى موارب وتأمل ومعان ثانية تُبْنى في الوجدان الصوفي، أما “الدبزة” فتلبية لحاجة مباشرة تَضْمن للمرء كفاف العيش وحده.
وهذا هو مضمون الاستراتيجية التي تحدثت عنها أعلاه: استهلكوا بالدارجة، وسنفكر مكانكم، وهو ما يعني وجوب فصل لغة الاستهلاك عن لغة المتعة الثقافية والمعرفة العالمة : للجموع الغفيرة لسان دارج به تأكل وبه تشبع، ولقلة من الناس لغة أو لغات أجنبية يحققون بها متعة في الروح وفي الجسد.
على الشعب إذن أن يظل جاهلا لكي يستوعب منتجات بلاده، يكفي أنه يتكلم دارجة يستطيع من خلالها التعرف على حاجاته دون وساطة الرمز والبناء الفني للوصلات، كما هو الحال في البلدان المتقدمة، فهناك لا يتوجه الإشهاري إلى مستهلكين بلا ذاكرة جمالية، بل إلى كائنات تستهويها حقائق “الفن” التي يتضمنها الاستهلاك أيضا.
س – في هذه النقطة، ما الفرق بين العقل الإشهاري الغربي (إن صح هذا التعبير) أو فيما سميته البلدان المتقدمة ونظيره هنا في المغرب؟
ج – يجب التذكير، في هذا السياق أيضا، أن نجاح وصلة إشهارية ما لا يكمن في “جماليتها”، بل في قدرتها على الدفع إلى الشراء. هذا مبدأ مركزي في آليات التسويق. ومع ذلك، فإن الإشهاري لا يتوجه إلى “مستهلك” بلا ذاكرة كما سبق أن أشرت إلى ذلك، بل يتوجه إلى مواطن يتحدد وعيه ضمن حالة حضارية تتحكم إلى حد كبير في طبيعة الوصلات التي يقدمها للمستهلك. لذلك، فإن موطن القيمة الفنية للوصلة هو المستوى الحضاري للمتلقي، وليس عبقرية الإشهاري المبدع فقط. لذلك عادة ما تنتقي الوصلة “قراءها”، أي تتوجه إلى شريحة بعينها اعتمادا على ما تعرفه عن هذه الشريحة وعن مستواها وتطلعاتها وقيمها.
وهذا ما يفسر مثلا وجود اختلافات في طبيعة “الحجج” المستعملة من أجل إقناع هذه الفئة من المستهلكين دون غيرها (نتوجه إلى الشباب بلغة لا يمكن استعمالها في التوجه إلى كبار السن، وتختلف الحجج الموجهة إلى النساء عن تلك التي نخاطب من خلالها الرجال). وهذه أيضا مبادئ مركزية في صياغة الوصلة الإشهارية.
لذلك لا وجود لوصلة إشهارية تتوجه بشكل مباشر إلى المستهلك وتقدم له منتجا محددا من خلال وظيفيته ومن خلال قدرته للاستجابة لهذه الحاجة أو تلك. إن الأمر، على العكس من ذلك، يتم داخل “الفرجة الحياتية” ووفق إكراهاتها الأخلاقية والثقافية. هناك دائما محاولة لتسريب المنتج إلى الذات المستهلكة ضمن دائرة رمزية هي المقصودة من الدعاية وليس المنتج في ذاته: يقال إن بائع الأحذية لا يبيع أحذية وإنما يبيع أقداما جميلة.
بعبارة أخرى، إن الإشهار يبشر بنمط في الوجود وبكينونة تتجاوز يقين التملك الآني لمنتج ما، أي كل ما يمكن أن يعد به المنتج. إن الإشهار “صناعة للمعنى” وليس مجرد عرض لمادة، فبدون هذا المعنى لن تختلف المواد عن بعضها بعضا. وليس غريبا أن يُقدم للمواطن الفرنسي، في أغلب الحالات، إشهارا يخفي غايته في الشعر والمرح والوضعيات الساخرة، ويقوم باستحضار بعض المواقف الإنسانية الكبرى كتلك التي تثيرها الأساطير القديمة منها والحديثة.
وعلى العكس من ذلك، فإن ما يقدمه الإشهار للمغاربة لا يتجاوز حدود منتجات لا تستثير في أغلب الحالات سوى انفعالات تُعبر عن الفرح بالامتلاك أكثر مما توحي بالرغبة في التماهي في نموذج سلوكي ما. فعادة ما يتوجه إلى المستهلك من خلال لغة فقيرة من حيث المخزون الدلالي ومن حيث الإيقاع الرمزي. إنه يفعل ذلك لأن غايته هي التمثيل للحظة استهلاكية فقيرة من حيث حاجات التماهي واستثارة أفق الحلم والشعر والتسامي. صحيح أن غاية الإشهار هي البيع، ولكن البيع ليس منفصلا عن ذات متحضرة “تحلم” باستهلاك الرمزي، ولا تكتفي بما يوضع بين يديها “حافيا”.
س – أليست هناك آليات لحماية المواطن من تجاوزات الإشهاريين الذين يبدو أن ما يملكونه من سلطة شجعهم على تخطي حدودهم وخوض مقامرة التقرير في مصائر الأجيال المتعلمة؟
ج – في حدود علمي هناك قانون اعتُمد في البرلمان أو نوقش فقط، له علاقة بتنظيم الحقل الإشهاري، ولكن ليست هناك مصلحة مستقلة مهمتها مراقبة المنتجات الإشهارية كما هو الحال في فرنسا مثلا حيث هناك ما يطلق عليه : مكتب مراقبة الإشهار ( bureau de vérification de la publicité ). والهاكا لا تتدخل إلا في “القضايا الكبرى” من قبيل الخصومات بين السياسيين ، أما وجدان المستهلك فلا قيمة له عندها في ما يبدو.
وعلى المستوى الإبداعي كانت هناك مجهودات محمودة حاولت أن تخاطب في الوجدان المغربي بعض الشحنات الجمالية من خلال بناء وصلات تخاطب المستهلك بشكل ذكي، أي توقظ الشاعر الذي يرقد داخله، بتعبير سيغيلا. ولكنها سرعان ما اختفت لتحل محلها الموجة الجديدة التي يتزعمها أصحاب الإشهار بالدارجة، وهي موجة تعيث الآن فسادا في وجدان هذه الأمة بدون رقيب أو حسيب، في غياب رقابة الهاكا ورقابة الوزارة الوصية ورقابة سلطة المثقفين والمهتمين بميدان الصورة عامة.
وهو ما لاحظناه أعلاه ونحن نتحدث عن اللغة “الحافية” الجديدة التي تبناها الإشهاريون. فهي لغة تكتفي بوصف مباشر للمنتج خارج أي بعد جمالي، وهو أمر مفهوم في تصور الإشهاريين المغاربة، أو البعض منهم على الأقل، فنحن لسنا في حاجة إلى مواطن يحلم، بل في حاجة إلى مواطن يرغب، أي يستهلك مع المنتج اللحظة الآنية خارج الحلم. إن الحلم مفتوح بطبيعته وقيمته في ما يطلقه من طاقات لا ما يمكن أن يتحقق ضمنه، أما الرغبة فعرضية وآنية، إنها مشروطة بلحظة تحققها.
ويكفي استحضار الحملات الإشهارية المتعددة حول “السلف” ومنتجات الفاعلين في ميدان الاتصالات، بل يجب أن نستحضر “خروف العيد” الذي يبني معاني استنادا إلى تركيبة لغوية تافهة من قبيل: إلا بغيتي حولي سمين شوفلك كريدي زوين. أو تلك التي تتوجه إلى شباب وتدغدغ فيهم كل مشاعر المراهقة العابرة: ديما مرغلين.
لقد سقط هذا النوع من الوصلات، وغيرها كثير، في شراك شعارات تغتصب الحشود وتشدهم إلى حاجات استهلاكية تفرضها طقوس قسرية. فكل الفضاءات والوضعيات الممثلة فيها تحيل على عوالم ضحلة بدون أي قيمة إيحائية سوى ما تتضمنه من إكراهات اجتماعية مستمدة من عقيدة مهووسة بالتشخيص (موظف يحمل فوق رأسه كبش أو يضعه أمامه على دراجته النارية).