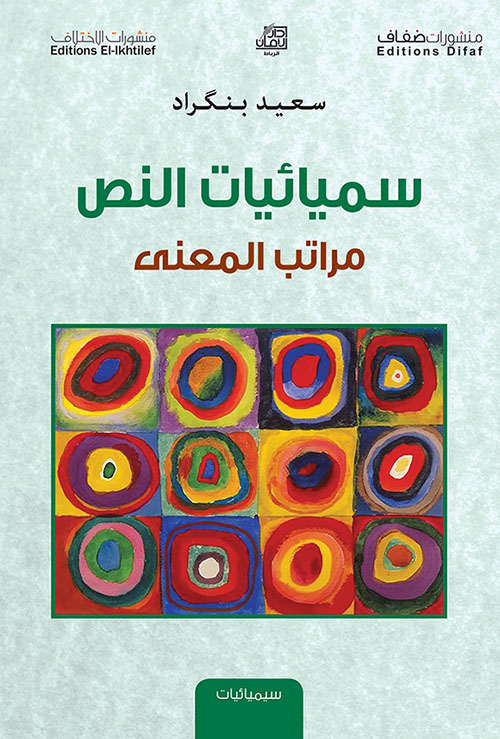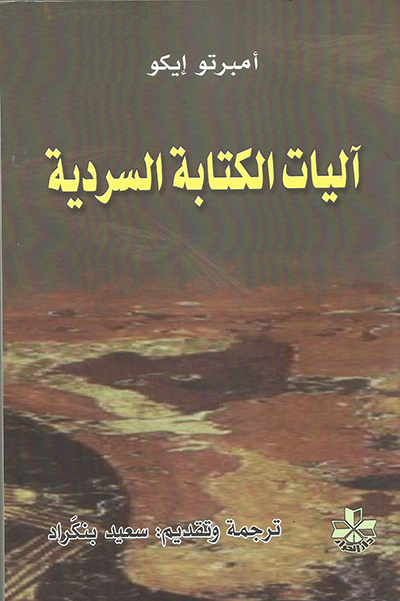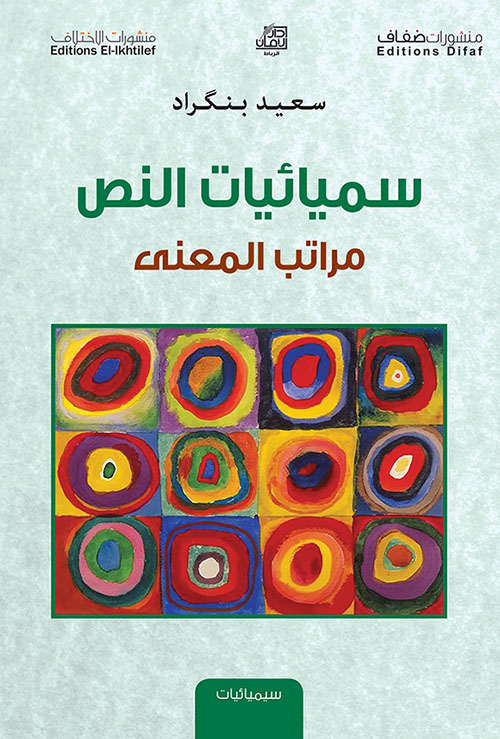
مقدمة
شكل الثلث الأخير من القرن الماضي منعطفا حاسما في تاريخ النقد الأدبي في كامل الفضاء الثقافي العربي. فقد أحس النقاد، بعد سقوط مجموعة كبيرة من المشاريع الفكرية والسياسية (الناصرية والقومية والاشتراكية )، بلا جدوى قراءة النص استنادا إلى الخطاطات النقدية القديمة التي كانت تتعامل مع النص باعتباره وثيقة سياسية أو إيديولوجية لا قيمة له إلا بما يمكن أن يكون له من مردودية في الصراع مع السلطة ومؤسساتها. وقد كانت هذه الخطاطات موزعة في الغالب على ما بشرت به بعض الممارسات النقدية التي كانت تحتمي تارة بالإيديولوجيا باعتبارها جوابا ممكنا عن قضايا اجتماعية أو سياسية، وتستعين تارة أخرى بما يمكن أن تقدمه كل المعارف المنتشرة في الموسوعة، أو تلك التي تعود إلى حياة المؤلف، فهي الكفيلة وحدها بتفسير النص.
وفي الحالتين معا، ظل النص غائبا في النقد، وإذا حضر فلا يحضر عند القارئ إلا باعتباره ذريعة لقول أشياء في السياسة أو الإيديولوجيا أو الاحتفاء بذاتية ترى في نفسها مصدرا لكل معنى. لقد كان النقاد في الغالب يصفون عوالم خارجية يستثيرها النص بموحياته المباشرة وغير المباشرة، استنادا إلى أحكام جاهزة؛ لذلك لم يكونوا في عملهم ذاك ينتجون معرفة تُغطي جزءا من أنماط حضور الناس في الحياة وفي المجتمع.
إن المخفي في النص في تصورهم ليس طاقات دلالية تقتات من الرمزي في المقام الأول، بل هو “سياسة” أو “أخلاق” أو “أحكام إيديولوجية” تُدين أو تحرض أو تحث الناس على التمرد: إن النص موقف من السلطة صريح، مناهضا كان أو مؤيدا أو ممالئا. لذلك لم نكن نعرف إلا الشيء القليل عن عوالمه، لغته ومكوناته وعلاقاته الداخلية وآليات الإنتاج والتأويل فيه. فهذه العناصر مجتمعة لم يكن لها أي قيمة، قياسا على الأهمية التي يوليها الناقد للمضمون الإيديولوجي المودع فيه.
وضمن هذا السياق المعرفي العام سيظهر التيار البنيوي الذي نظر إليه النقاد حينها باعتباره جوابا “علميا” عن كل القضايا التي يثيرها إنتاج نص ما في كل فنون القول والبصر. لقد كان الأمر يتعلق، في الغرب طبعا، بإبدال معرفي شامل عم كل الميادين المعرفية. لقد كانت البدايات الأولى من اللسانيات، فهي الأصل والمنطلق، ولكنه سرعان ما انتشر في كل الاتجاهات ليشمل علم النفس وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا والتاريخ، بل والرياضيات أيضا( تصورات روني توم ). لقد كان جوابا عاما عن سؤال أفرزته حاجات اجتماعية موزعة على كل الأبعاد الإنسانية.
وكان ذلك بمثابة التباشير الأولى للتجديد في النقد العربي، أو كما أصبح يُمارس في بلدان المغرب العربي على الأقل. لقد كانت البنيوية “معرفة” جديدة تختص بعوالم النص وحده في انفصال عن كل ما يشكل محيطا مباشرا فيه، أو محيطا بعيدا في الموسوعة. لقد كانت هي البديل الوحيد الممكن في تلك المرحلة، ولم يكن أمام النقاد، خاصة في ميدان السرد، سوى الرؤية “التقنوية” الصارمة التي بشرت بها استنادا إلى ممكنات النموذج اللساني الذي تنحدر منه. فكل التوجهات التي تبناها النقاد في تلك المرحلة كانت تتغنى بهذا النموذج، بل اعتبرته المدخل الأساس لفهم النص. لقد آمنت جميعها بقدرته على مد الناقد بما يحتاجه من مفاهيم وخطاطات تساعده على رصد العناصر التي تشكل وحدة النص وتضمن تماسكه وانسجامه. وفي هذا السياق، يمكن التذكير بما قاله بارث سنة 66 في مقاله الشهير ” عناصر السميولوجيا”، حيث اعتبر المعرفة اللسانية الأساس الذي سيقوم عليه هذا العلم الجديد. وكان هناك في الإبدال المعرفي السائد ما يفسر هذا الاختيار ويبرره :
-فمن جهة شكل اللسان نظاما قارا تُقاس عليه كل الأنظمة التواصلية الأخرى، بما فيها تلك التي تعتمد عناصر العالم الطبيعي مادة لتجليها. فهو من طبيعة خاصة لأنه النسق الوحيد الذي يسمي ويعين ويؤول غيره من الأنساق ويؤول نفسه في الوقت ذاته. لذلك ستكون اللسانيات نموذجا معرفيا أوليا تنبثق عنه كل النماذج التحليلية الأخرى المصنفة ضمن العلوم الإنسانية. فأداة التفكير المركزية هي اللسان، وأولى خطوات البحث تبدأ من مساءلة هذه الأداة.
-ويُعد، من جهة ثانية، البؤرة المركزية التي تتحدد داخلها طبيعة الوعي وطبيعة اشتغال النصوص التي تفيض عنه. فالإنسان هو اللغة ولا يعرف عن عالمه إلا ما تبيحه هي وفق تقطيعات خاصة موجودة في اللسان لا في الواقع. وهو ما يجعل التركيز على لغة هذه النصوص أولوية قصوى تُلغي من حسابها كل ما يحيل على العوالم الموجودة خارجها. ووفق هذا التصور، نُظر إلى النص باعتباره “شبكة من العلاقات التي تنتظم فيما بينها استنادا إلى قوانين بنيوية خاصة يُعد التعرف عليها شرطا رئيسا لتحديد معنى النص”، ما سميناه في هذا الكتاب: النص صناعة للمعنى.
وهوما يعني أننا لا يمكن البحث عن مضمون النص خارج لغته، فهي المرجعية الوحيدة التي تتبلور انطلاقا منها كل الأكوان الدلالية الممكنة. إن الخارج الذي يتحدث عنه البعض لا يوجد خارج اللغة، بل هو السبيل الوحيد المؤدي إليه. فنحن نبحث عن الموحيات والاستعمالات الرمزية للأشياء والكائنات والمجاز انطلاقا مما يُبنى داخل اللغة.
ومع ذلك لم يكن النموذج التحليلي الذي قدمته البنيوية يحفل بالمعنى، أي بما يمكن أن يقوله النص ضمنا. لقد صب كامل اهتمامه على العلاقات التي تكشف عن البناء النصي في انفصال عن الأبعاد الرمزية فيه. لذلك لم يحضر التأويل في أدبياته إلا باعتباره ترفا فكريا لا يشكل اقترابا علميا من النص؛ لقد عُد التأويل في البنيوية تنازلا عن التحليل أو ذريعة لقول ما تود قوله ذات تبحث عن نفسها لا عما هو مودع في النص حقا، إن النص براء من كل قصد يأتيه من خارجه : لقد “مات” المؤلف ومات معه المعنى، واختفت “الجماليات” التي يشتغل من خلالها النص باعتبار أدبيته، لا باعتبار مرجعه. لقد كان النموذج القائم على ” النحوية” الذي قدمه تشومسكي هو الأساس في قول شيء ما عن واقعة لفظية ما.
ومع ذلك، لم يكن هذا التيار فاسدا بالمطلق. لقد كان له فضل كبير في تقديم الكثير من الإضاءات الخاصة بالنص. فقد قدم خدمة كبيرة للنقد والنقاد من حيث إنه وجه الناس إلى ما يمكن أن يساعدهم على معرفة مكونات عالم رمزي مكتف بذاته، فهذه المعرفة تُعد شرطا من شروط التعرف على السيرورات التي تقودنا إلى تلمس بعض آثار المعنى فيه. ذلك أن “الداخل” النصي دال من خلال مكوناته، فالتوزيع الزماني والفضائي ونمط حضور الشخصيات والأصوات داخل النص والرؤى التي توجه الفعل السردي، وأنماط السرد والسارد، كلها مداخل ضرورية لمعرفة العوالم الدلالية التي تبنى داخل النص.
أما ما تبقى بعد ذلك فقد تكفلت به السميائيات البنيوية. لقد جعل هذا التيار من المعنى نقطة مركزية في برنامجه التحليلي وفي رؤاه المعرفية التي تُسنده. فلا يمكن الحديث عن نص خارج كونه بؤرة لمعنى، فالحياة ليست مجرد سلوكات نفعية لا يحدها أي أفق دلالي صريح أو ضمني، إنها موجودة من خلال آثار المعنى فيها، وتلك هي الخاصية المركزية التي تميز الكائن البشري عن باقي مخلوقات الكون. فعلى عكس النموذج البنيوي في صيغته الأولى الذي تَنَكَّر للمعنى، حاولت هذه السميائيات تجاوز حدود المكونات الخاصة بالنص، لكي تنظر إلى الطريقة التي ينتج النص وفقها معناه ( النص السردي خاصة).
وهنا أيضا، وعلى خلاف ما قدمه النموذج الأول الذي وجه النقاد إلى ظاهر النص والعلاقات الممكنة داخله، كان النموذج الثاني تنظيرا خالصا للسردية باعتبارها أداة توسط بين بنيات أولية من طبيعة مجردة، وبين وجه مشخص هو المدخل الظاهر للإمساك بمادة دلالية مودعة في نص مطواع يحمل قصده في ذاته. إن الأساس في النص ليس سرديته باعتبارها إحالة على تقنيات في الحكي وتصريف لأحداث من طبيعة خطية، بل باعتبارها ما يمكن أن يترتب عن التوسط الذي تقوم به. وبهذا المعنى وضع أتباع هذا التيار كامل ثقتهم في السردية فهي التي تفصل بين الحياة كقيمة وبين وجهها في سلوك مشخص. إنها بعبارة أخرى، الأداة التي يصرف من خلالها المتلفظ الكم الدلالي الذي بحوزته.
ومن هذه الزاوية عُدت هذه السميائيات، في الكثير من تصوراتها، كما أشرنا إلى ذلك في الكثير من المناسبات، تصورا وضعيا للحياة يُسلم بإمكانية وجود حقيقة لا أثر فيها للذات. فإمكانية تصور قصد يُبنى في اتصال كلي مع معطيات النص أمر مشروع، إنه حاصل التفسير وثمرة من ثماره. وبذلك كان هذا التصور، يحيل في جوهره، على إمكانية البحث عن دلالة أصلية مثواها النص وحده. ذلك أن هذا “القصد” يشكل معطى متضمنا في موضوع التحليل باعتباره كيانا يبني معانيه استنادا إلى إسقاط سلسلة من التناظرات تعتبر “مركزا” في النص تلتف حوله كل القيم المضمونية التي تختبئ في تفاصيل وجهه المشخص. إن النص “حر” في بنائه وفي مضمونه، والقارئ في حِل من أمره وهو يقرأ نصا ما، إن دوره يكمن في اكتشاف ما هو مخبأ في النص قبله لا الإسهام في إنتاجه.
وقد يكون هذا الاعتقاد هو الذي دفع بول ريكور مثلا إلى اعتبار النموذج التحليلي الذي قدمته البنيوية من خلال مجموعة من تياراتها معادلا لما يسمى في الهرموسية “التفسير”. إنه مرحلة أولى في التحليل، ولكنها ليست كافية، فنحن نتعرف فيها على بنية شكلية لنص صامت لا يمكن أن يسلم دلالاته إلا بالانتقال إلى مرحلة ثانية هي ما يشكل الفهم، وبدون هذا الفهم ستظل الممارسة النقدية “لعبة عقيمة” بدون أي أفق، ولا يمكن أن تكشف عن أي مظهر من مظاهر الوجود الإنساني على الأرض. لقد لا زمنا القلق في الأرض، فأودعناه منذ غابر الأزمان في ما نكتب ونرسم ونخط على جدران الكهوف وجلود الحيوانات والصخور. وعلى المحلل أن يكشف عن أشكال هذا القلق ( كان ريكور يعتبر تحليلات ليفي شتراوس ناقصة، لأنها تتحدث عن العلاقات التي تكون بنية الأسطورة دون أن تفتحها على الأفق الإنساني).
لقد نسي النقاد الإيديولوجيون، وهم يحاولون جعل الأدب وثيقة سياسية خالصة، معنى النص؛ وفي المقابل نسي البنيويون وهم يحتفون بالطبيعة المحايثة للنص، ذاكرة الإنسان في التاريخ. فخلاصهم كان في النص وحده. وبذلك تساوت النصوص عندهم وتشابهت إلى الحد الذي جعل الخطاطات التحليلية في الكثير من الأحيان هي الأصل وليس النص. فنحن لا نعرف عن معنى النص إلا ما يمكن أن تسمح به الخطاطات التحليلية.
وهذا المأزق هو الذي حاولت السميائيات التأويلية تجاوزه من خلال فتح النص على آفاق جديدة تجعل التأويل غاية قصوى لكل تحليل. إنها لا تستنبت المعطيات الخارجية داخل النص، وإنما تبحث عن المعرفة الدالة عليها من خلال البناء اللغوي ذاته. فقد تكون العلاقات المرئية داخل النص دالة على محكي محدود في الزمان وفي المكان، ولكنها في اللغة ممتدة خارج النص في نصوص ثقافية هي المادة التي يستمد منها العمل الفني كل إيحاءاته. إنها لا تبحث عن مركز في النص، بل تشق إليه طريقا تلعب فيه لحظة التلقي دورا مركزيا. إن المعنى ليس كما، إنه سيرورة تبنى في فرضيات القراءة.
إنها بعض الأسئلة التي حاولت نصوص هذا الكتاب الإجابة عنها. فقد حاولنا من خلال مجموع فصوله رسم بعض الحدود الخاصة بمجموعة من الرؤى التحليلية التي تخص نصوصا من كل الطبائع. كانت هذه النصوص نظرية في أغلبها، وقَصْدنا من ذلك هو مد بعض العون إلى الباحثين من أجل حثهم على استحضار تأملات المعنى في كل محاولة نقدية، وهو تأمل يختص ببناء جميع النصوص باعتبارها “صناعة للمعنى”. بعبارة أخرى، تختفي، وراء العرض الموضوعي لبعض التصورات النظرية، نظرة نقدية في جوهرها، وتلك هي السبيل نحو استنبات مُنْتَج فكري وافد ضمن تربة ثقافة عربية لها ذاكرة في التاريخ المعرفي الإنساني.
المحتويات
القسم الأول :السميائيات وقضايا النص
-السميائيات وتأويل النص الديني
-النص صناعة للمعنى
– الذات مصدرا للمعنى
-سميائيات كريماص : في الذكرى المائوية الأولى لميلاده
-ممكنات النص ومحدودية النموذج النظري
القسم الثاني : دراسات تطبيقية
-السرد سلطان الزمن
-السرد وممكنات الذات
-عن الإشاعة: السرد والحقيقة المحجوزة
-مراتب المعنى
– الأنيثة والرجيل : في سميائيات الأنوثة
– الإنسان كائن لغوي
-اللغة والقاموس
-في سميائيات التواصل السياسي