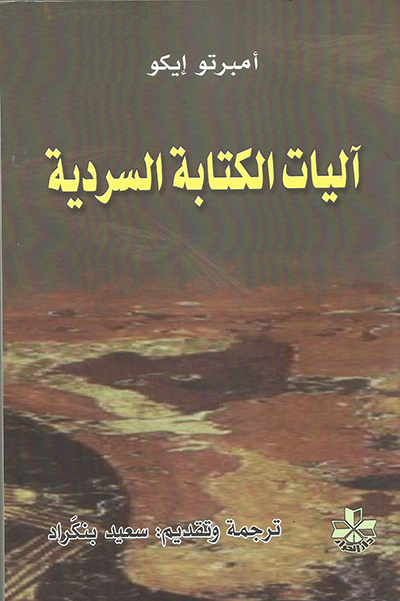سعيد بنگراد
سارع الاشتراكيون الفرنسيون الفائزون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2012 إلى إلغاء كلمة “عرق” من دستورهم، ذلك أن العرق الوحيد الممكن على الأرض في تصورهم هو “العرق الإنساني”، أما ما عداه فطبيعة صامتة لا يمكن أن تُحاسب على أفعالها. وكانوا بذلك يعترفون بما سبق أن أثْبتَه في المخابر المختصون في الطب والبيولوجيا، وما أكده الكثير من الأنتروبولوجيين قبلهم بالمعاينة الميدانية. فلا وجود في تصور هؤلاء جميعا لتفاوتات بين الناس قائمة على أصل بيولوجي يُميز ويفاضل بينهم. وهي صيغة أخرى للقول، إن الإنسان لا يعيش إنسانيته ضمن إكراهات عِرقية سابقة على وجوده في الثقافة، كما لا يحقق طبيعته ضمن “إنسانية مجردة، إنه يفعل ذلك دائما استنادا إلى ثقافات لا تستطيع ثورات التغيير أن تنال منها بشكل كلي “(1).
وهذا هو الحد الفاصل بين “الهمجية” عند الإنسان باعتبارها اختيارا “حرا”، وبين “الوحشية” عند الكائنات الأخرى، فالتوحش ليس إرثا، بل هو نمط ” بَري” في الوجود من طبيعة قَسْرية. ذلك أن الحيوانات، على عكس الإنسان، تجهل كل شيء عن التطور والنمو ومراكمة المعارف والخِبرات؛ وكل ما يصدر عنها موجود بشكل سابق في طبيعة لا حول ولا قوة لها أمامها. ودلالة ذلك أن “حياة” الحيوان تُختصر في تدبير ظرفي لانفعالات عارضة تستوعبها ردود فعل مودعة في تركيبة “بيولوجية” سابقة على كل أشكال الوجود، إنها شبيهة بالبرماج (logiciel) الذي يكتفي بمعالجة ما خُزِّن في ذاكرته خارج تأثيرات ما يأتيه من التعاقب في الزمان. إن الحيوان ليس واحدا تُشكل الغيرية جوهر كينونته، بل يستمد هويته من قطيع لا تتغير أفعاله أبدا. إنه كائن “ظرفي”، لا تمايز بينه وبين نظرائه في انتقاء ما يأكل ولا شيء يميزه عنهم في اللغة وفي واجهات الجسد.
لا وجود إذن لإنسان يعيش خارج “حد أدنى” من الثقافة، ولا وجود لحيوان يرسم مشروعا لحياته وفق نموذج ثقافي مسبق، فالثقافة مِلْك للإنسان وحده، تماما كما هي الزمنية ملكا له وحده. لذلك سيكون من الخطأ رد الهمجية إلى انتماء عرقي “وضيع” هو ما يُصنف عادة ضمن “التوحش”، وهو سلوك افتراضي يحيل على عالم حيواني يجهل كل شيء عن الأخلاق والقيم والقوانين. فالحيوانات التي تعيش حياة البراري وتقتل وتُدمر وتعيث فسادا لا تفعل ذلك عن “قصد” و”سبق إصرار” ولا تنتشي بما تفعل، إنها لا تستمد سلوكها ذاك من جينات عرقية أو رغبة في الانتقام من خصم أو عدو، وليست خارجة على ما سُنَّ في العُرْف، كما لا تَخْرِق معيارا أخلاقيا، إنها لم تكتسب في وجودها على الأرض سلوكا عدوانيا، ولم تختر نمطا في الحياة، إنها تكتفي، في عمرها الافتراضي كله، بتنفيذ ما بُرمجت للقيام به بشكل “طبيعي”، فذاك منتهى وجودها وتلك هي الغاية منه.
وليس ذاك هو قدَر الإنسان، فهو لا يتمتع بطبيعة أصلية هي هويته ومداه المطلق، ذلك أن “الوجود عنده سابق على الجوهر”، كما يقول سارتر، بل إن “إرادته أقوى من الطبيعة” ذاتها، في تصور جان جاك روسو. إنه حر و”الحرية هي الطابع المميز للإرادة الإنسانية وغاياتها” بتعبير كلود ليفي شتراوس. وهو ما يعني أن سلوكه هو حاصل اختيارات إرادة حرة في الحياة، وليس نتيجة نُمُوٍ غُفل في الطبيعة. لذلك كان دائما مصدر نفسه في الشر والخير والحب والتسامح والتشدد. وهو أيضا ما دفعه إلى الانغماس في الكثير من الممارسات الغريبة في وجوده فاكتشف الكحول والسجائر والمخدرات والانتحار، وآمن بالسحر والخرافات والأساطير وتبنى ديانات متعددة، فعل ذلك كله استباقا أو وقاية ودرءا لموت لا يُخْلِف ميعاده أبدا.
فقد يكون للطبيعة عند الكائن البشري دور في لونه وتركيبته الفسيولوجية والكثير من خصائصه البرانية الأخرى، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون مصدرا مباشرا لنوعية انفعالاته، كما لا يمكن أن تكون عنصرا حاسما في تحديد طرق التفكير والبرهنة والحجاج عنده. ففي كل حالات الوجود الإنساني على الأرض كانت الثقافة، بكل مداخلها، الأسطورية والدينية وأشكال السلوك، هي المميز الأسمى للشعوب، وهي أساس النمو والتطور والاندحار والانتكاسات أيضا. لقد خلقت الطبيعة حيوانا واحدا يعيش أسيرا لسلوك قار لا يتغير أبدا، أما الثقافة فأنتجت كائنات جديدة تتميز بتنوع أشكال حضورها في الوجود. لذلك كان الفن سمة حضارية مثلى انفرد به الإنسان وحده، ” أما خلية النحل فلم تكن سوى أثر من آثار الطبيعة ” كما يقول كانط.
بعبارة أخرى، نحن نشترك في الكثير من الأفعال والأحاسيس مصدرها في الغالب “منافذ حسية” هي بوابتنا الأصلية نحو عالم فَرَّقت بيننا وبينه أشكال رمزية من كل الطبائع، ما يُصنفه إيكو، من زاوية التطور السلوكي عند الإنسان، ضمن “الكليات الدلالية” الأولية التي كانت أساس التمدن الإنساني وتحضره، وهي التي خَلَّصت “ذلك الكائن المنعزل الذي يجهل كل ما له علاقة بالمتعة الجنسية ولذة الحوار وحب الأطفال وألم فقدان عزيز” (2)، من حميميته في الطبيعة لكي تقذف به داخل “غربة” ثقافية غيرت من شكل حضوره في الوجود. لذلك كان الإنسان “حيوانا غير سوي” في تصور روسو(3).
وهو ما يعني أن الرمزية في حياة الإنسان هي أساس تمدنه وتحضره وانفصاله عن الكائنات الأخرى، وهي أساس التداول الوظيفي لأشياء الطبيعة وكائناتها (التصرف في خيرات الطبيعة: اكتشاف الأدوات والتداوي والعلاج واستعمال حيوانات كثيرة للتنقل ونقل الأمتعة)، أما “العلامات” فهي إرث مشترك بين كل الكائنات البشرية، وهي ما يظل يُذكره بأصوله الأولى، حين كان الصراخ والإيماءات الهوجاء وسيلته الوحيدة للاستغاثة والتوسل والرغبة في حضور آخر يحميه من محيط يجهل عنه كل شيء.
وتلك الكليات هي أساس” الأخلاق الإنسانية” وهي أساس ما يُطلَق عليه في أيامنا هاته “القانون الإنساني”. فما يُوحدنا جميعا ليس ثقافة يشترك فيها كل الناس، وليس دينا تؤمن بطقوسه ساكنة المعمور قاطبة، إن ما يجمعنا حقا هو انتماؤنا جميعا إلى هذه الأحاسيس الأولية، فنحن” نمتلك جميعا فكرة مشتركة عن مقولات الفوق والتحت، ونمتلك فكرة عن اليمين واليسار، عن التوقف والحركة، عن الصحو والنوم (…) ونعرف على ما يدل الاصطدام بشيء صلب، أو اختراق مادة رخوة أو سائل، ونعرف ماذا يعني تحطيم شيء ما، وماذا يعني التطبيل والدوس وتسديد ركلات، وماذا يعني الرقص”(4). يتعلق الأمر في هذه الحالات مجتمعة بكل ما يُذَكر الناس جميعا أنهم سكان شقة واحدة هي الكوكب الأرضي.
فكيف حدث أن أصبح الإنسان، وهو نتاج ثقافات متحولة ومتنوعة، عدوانيا وهمجيا لا يكف عن القتل والتدمير ونشر الكراهية في كل مكان ؟ لقد فعل ذلك لأنه اعتقد في وجود آخر قريب منه هو ابن دينه وثقافته وحضارته هو وحده جدير بالحياة والتمتع بخيراتها. إنه الحد الذي تنتهي عنده الإنسانية، أو تنتهي عند حدود قريته، وما بعد ذلك ليس سوى التوحش والهمجية. فهو وحده “الطيب” و”النقي” و”الحسن الخلق”، بل هو الإنسان وحده، أما الآخرون فشر مطلق (5). فهذا الآخر القريب يقتسم معه كل شيء، الطقوس والمراسيم والاحتفالات الدينية، بل يتقاسم معه الحقيقة ذاتها، وهي وحيدة لا يطالها التعدد والتبدل.
بعبارة أخرى، إنه يحكم على الآخرين ويصنفهم استنادا إلى ما تبيحه ثقافته وتحرِّمه، لا إلى ما يمكن أن يكون عليه الآخرون في ثقافة أخرى لا تشبه بالضرورة ثقافته. فكل من لا يشبهه لا يمكن أن يكون “سويا”، إنه موجود خارج الإنسانية وخارج امتيازاتها. بعبارة أخرى، إن مصدر المعيار الأخلاقي عنده هو “النحن” المباشرة بكل حمولتها في اللغة والدين والثقافة، وربما الانتماء الجغرافي أيضا. إنها الحد الذي يفصل بين “التحضر” وبين “التخلف” و”الهمجية”. ذلك أن ” مقولة الإنسانية ذاتها التي تتحدث عن الناس خارج أصولهم وانتماءاتهم العرقية والحضارية لم تظهر إلا في مراحل متأخرة ” (6)، لا يتجاوز ذلك النصف الثاني من القرن العشرين ( حتى وإن كانت إرهاصاتها بدأت مع فلسفة الأنوار).
وهو ما يعني أن التعدد في الثقافات وتنوعها ليس بداهة يسلم بها كل الناس. فهي قد تكون عند الكثيرين في كل بقاع الأرض خللا في الطبيعة أو نشازا في حياة خُلقت لكي تكون واحدة في كل مكان. لذلك يُطلق البعض على كل ما لا ينتظم ضمن ثقافتهم صفات من قبيل “العادات السيئة” و”السلوك الهمجي” و” الوحشية”، “فكل ما لا يستقيم ضمن المعايير التي يعتمدونها في حياتهم يصنفونها خارج الثقافة، أي ضمن الطبيعة” (7)، أو هي بقايا حيوانية عند كائنات في حاجة إلى ترويض حضاري. وقد يكون ذاك هو مصدر ما يشعر به الناس تجاه من لا يعرفونهم أو لا يعرفون أي شيء عن أصولهم وخاصيات محيطهم. ” فالبداهة الحسية المباشرة قد تدفع الإنسان العادي إلى الإيمان بوجود أعراق مختلفة عندما يرى دفعة واحدة إفريقيا وأوروبيا وأسيويا وهنديا من أمريكا”(8). وهي البداهة ذاتها التي تدفعه إلى التوجس من الغريب والمختلف في اللغة واللباس وطريقة الأكل.
لذلك كان اعتماد معايير “النحن” للحكم على الآخرين هو مصدر الهمجية والتعصب والكثير من الأمراض التي رافقت الإنسان في وجوده الأرضي. إن “النحن” المنفصلة عن الآخرين مضللة في أغلب الأوقات، فهي تحدد المقبول والمرفوض والمحبذ والمكروه استنادا إلى ما تؤمن به في العقيدة أو السلوك الاجتماعي. وباسم هذا الإيمان تمت في كثير من مراحل التاريخ إقصاء الآخرين وإدانة سلوكهم، بل وإعلان الحرب عليهم، باسم الدين والإثنية والانتماء الطائفي أو العرقي، وباسم الشرعية الدولية أحيانا أخرى. والحال أن هذه “النحن” لا يمكن أن تتحدد باعتبار ذاتها، أي باعتبار المخزون الأخلاقي عندها، بل يجب أن تقيس أخلاقها استنادا إلى أخلاق الآخر، ذلك أن العزلة لا يمكن أن تقود إلا إلى الفاشية والتطهير بكل أنواعه. إن “أخطر ما يمكن أن يصيب أمة ما هو شعورها بالوحدة”(9)، أي امتلاكها لثقافة لا تشبه كل الثقافات.
بعبارة أخرى، إن وعي الذات لحدودها خطوة نحو التحضر وتقليص لممكنات التوحش والهمجية، ولكن هذا الحد ليس فرضية محايدة وليس قابلا للقياس الموضوعي، بل هو موجود ضمن نظام قيمي خاص، لذلك لا نعرف أحيانا متى ينتهي القتل باسم الإنسانية أو الدين، ومتى يبدأ الفتك بالناس باسم “المصالح الاقتصادية”، أي متى يكون القتل “مبررا” درءا لقتل أشد بشاعة ( كما نفعل ونحن نَحْرِم المجرم من حريته ونضعه في السجن خوفا على الناس من عنفه)، ومتى يكون ممارسة همجية تنكرت لكل ما راكمته الإنسانية من قيم: لقد مات الآلاف من قبيلة التوتسي في مجاهل إفريقيا دون أن يتحرك المجتمع الدولي ليضع حدا لما يعتبره الضمير الإنساني جريمة، ولكنه بارك قتل مئات الآلاف من العراقيين وأذكى نار كل الطائفيات في العراق بدعوى البحث عن أسلحة “قد تكون” خطرا على الإنسانية في مستقبل لا أحد يعرف بداياته.
وبالمثل ليس من حقنا أن ننعت الذين كانوا يقدمون أبناءهم قربانا للآلهة بالهمجية. فالكثير من الممارسات التي تبدو لنا اليوم مغرقة في العبثية واللامعنى لم تكن سوى ممارسة لنمط ثقافي مشترك بين كائنات لم يكن المتاح العلمي، أو المعتقد الديني نفسه قادرا على تقديم أجوبة تدفع إلى عبادة الله وتحافظ على حياة الناس في الوقت ذاته، ولكننا لن نتردد في وصف الذين يمارسون اليوم ختان الفتيات بالهمجية، فنحن نعيش في مرحلة استطاع الإنسان فيها وعي الكثير من حاجاته الأساسية ومنها الحاجة الجنسية، ووعى أيضا ضرورة المساواة بين كل الناس نساء ورجالا. إن الذين يمارسون ختان الفتيات في الألفية الثالثة باسم الدين، ليسوا أقل همجية من الذين يقطعون الرؤوس في سوريا والعراق ومجاهل إفريقيا.
لم تكن “البربرية”، التي أصبحت دالة على الهمجية والسلوك الأهوج والممارسات الرعناء في الأخلاق والأحكام عند البعض، سوى عَيِّ في النطق، أو إحالة على أقوام كانوا غرباء على سكان أثينا وروما بعدها. ومع ذلك، فإن هذا التوصيف ذاته لم يكن ليخلو من دلالة، بل من دلالات، لعل أهمها الإيمان بمركزية الأنا بلغتها وثقافتها وحقها وحدها في التصرف في المحيط الطبيعي وفي الزمنية استنادا إلى هذه المركزية اللسنية بالذات. فأن تتكلم لغة أخرى غير السائد منها، معناه خروجك عن معايير دلالية ونحوية وصوتية يراها الآخر أساس تعقل الإنسانية، والأساس الذي يقوم عليه كل التحضر. إن معاني لغتك أقل شأنا من معاني لغة شبيهة بزقزقة الطيور في الغابة( كان إرنيست رينان يرى أن اللغة الفرنسية لا يمكن أن تكون لغة للعبث).
والحال أن سيرورة الوجود في اللغة أعقد من ذلك وأشد غنى من الأحكام العنصرية. فنحن نتفق على شكل وجود الأشياء في العالم الخارجي دون أن يقودنا ذلك إلى منحها الأسماء ذاتها، وذاك أصل التنوع الثقافي ومصدر من مصادره. إنه دال على أن الأمر في اللغة لا يتعلق بتعيين محايد، أي بنقل لشيء من عالم مادي إلى عالم مجرد يعادله ويوازيه، كما يعتقد ذلك السذج من الناس، بل هو إعلان عن وجود جديد يتخذ داخله الشيء الممثل في اللغة/الذهن صيغة مفهومية لا يمكن أن تُدرك إلا ضمن تقطيع ثقافي خاص. ذلك أن كل تسمية هي استنبات لشيء داخل تربة جديدة قد لا يكون لها أي علاقة بالتربة الأصل. فنحن “نحس داخل عالم ونُعَيِّن داخل عالم آخر “(10)، لذلك لا يمنعنا التسليم بوجود الأشياء في العالم الخارجي من الاختلاف في تسمياتها. فلا فضل لهذه اللغة على تلك إلا في قدرتها على تغطية كل مناحي الحياة، وتلك قضية أخرى.
وكما كانت الأحاسيس الأولية كونية ومشتركة بين الناس وهي أساس تحضرنا، فإن الحقائق العلمية هي أيضا كونية، فلا شيء في محيطنا يجعل حديدَنا يستعصي على التمدد بالنار، ولن تكون جاذبيتنا أقوى من جاذبية الآخرين، وستظل الأمراض التي تفتك بالناس هي ذاتها في كل بقاع الأرض. والأمر ليس كذلك مع الأديان والثقافات، إن حقائقها نسبية ومتغيرة، فقد لا نستسيغ أكل الضفادع والاستمتاع بلحم الأفاعي، ولكن لا يحق لنا إدانة من يفعل ذلك، فنحن أيضا نأكل ما يراه الآخرون سلوكا غذائيا همجيا ومتخلفا. إن طريقة الأكل عندنا وعندهم سلوك ثقافي لا علاقة له في الغالب بشيء آخر غير متعة الأكل ذاتها. لذلك لا تثريب علينا في أن نقبل بما يفعله الآخرون ونتفهمه دون أن يلزمنا ذلك ممارسةَ ما يمارسون. فنحن وهم لم نخرق قانونا ولم نعتد على محرمات بعضنا بعضا.
بعبارة أخرى، إننا ننتمي إلى ثقافتنا استنادا إلى خصوصيات هي مِلْك لنا، ولكنها غير قابلة للتعميم على كل الناس. إننا نمارس طقوسا هي جزء من ديننا وتراثنا، ولكننا لا يمكن أن نحقق إنسانيتنا استنادا إلى نصوص مطلقة في الحكم والتقدير والإحالات الدلالية، إننا نستطيع فعل ذلك بالتسليم بوجود معيش يومي تتحكم فيه الكثير من الشروط، لعل أهمها الرغبة في البقاء والخوف من الجوع والتشرد وما يأتي به الزمن في غفلة منا. وهي المشاعر والأحاسيس ذاتها التي يتقاسمها معنا كل الناس. ولقد أدرك الدين نفسه، ديننا، هشاشة الكائن البشري ونسبية أحكامه فأحاط سلوكه بالكثير من ممكنات “الخرق”، فتحدث عن الضرورة والمكروه وما استُكره عليه الناس. وذاك هو أصل الثقافات وتنوعها وتلك هي الغاية منها.
——
1-Claude Levi-Strauss : Anthropologie structurale deux, édtion Plon ,1973,p.385
2-أمبيرتو إيكو : دروس في الأخلاق، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 2010 ، ص 122
3-l’homme est un animal dépravé
4- أمبيرتو إيكو : دروس في الأخلاق، ص121
5- Claude Lévi-Strauss, op cit p.384
6- Claude Lévi-Strauss, op cit p.383
7-نفسه ص 383
8-نفسه ص385
9-نفسه ص415
10- Régis Debray : Vie et mort de l’image, éd Gallimard, 1992, p.64