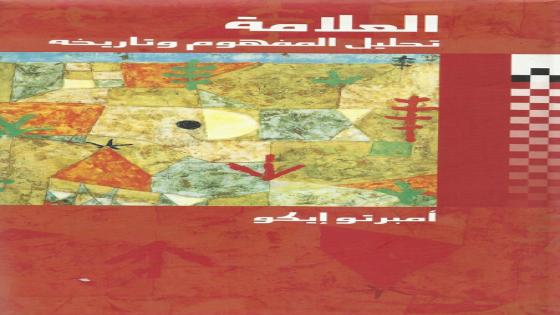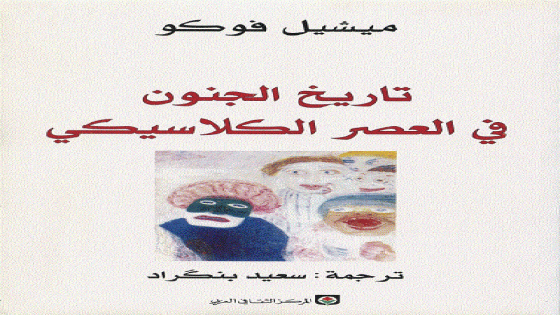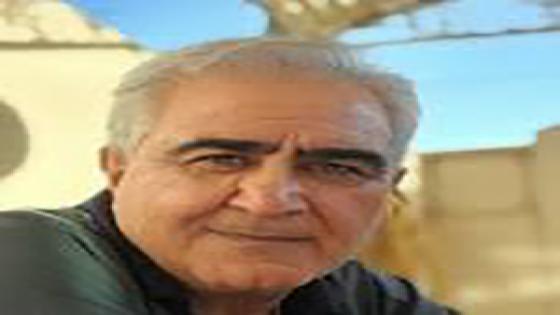مقدمة المترجم
سعيد بنگراد
موضوع الكتاب الذي نقدم ترجمته لقراء العربية هو “السيلفي”، أي الصورة العرضية والهشة التي تملأ مساحات العوالم الافتراضية ويتم تداولها داخل فضاء ” أفقي” تخلص من أبعاد “العمق” فيه ليصبح حاضنا لكل أشكال الوهم والتيه والتضليل والقليل من حقائق العلم والحياة. إنها صور لا “تنظر” إلى معطيات الواقع، بل تعيد إنتاج نسخ عابرة في العين والوجدان. وتلك إحدى خصائص “الصور المزيفة”، أو هي الشكل الوحيد الذي يمكن أن تحضر من خلاله المحاكاة الساخرة أو المضللة للواقع. فنحن نُمسك من خلالها بأشباه أشياء أو كائنات، أو ننتقي من عوالمها حقائق لا تُعمِّر في الذاكرة إلا قليلا.
وضمن حالات الزيف هاته يمكن تصنيف العوالم الافتراضية أيضا، بكل إبدالاتها الجديدة وتبعاتها على الزمان والفضاء والنسيج الاجتماعي، وتبعاتها على الذات وعلاقتها بنفسها وبالآخرين في الوقت ذاته. تدخل ضمن ذلك كل الوسائط الجديدة التي تحاكي عالم الحقيقة الواقعية من خلال سيل من الصور التي لا غاية منها سوى التمثيل ذاته. فقد تكون هذه العوالم مستودعا للكثير من المنجزات العلمية، وقد تكون وسيلة فعالة في نقل المعلومة ضمن سياقات بعينها، بل قد تكون في بعض الحالات مصدرا لصداقات حقيقية، ولكنها قلصت، في الكثير من الحالات، من دائرة الذات وحدَّت من رغبتها في الذهاب إلى ما هو أبعد من تمثيل بصري سيظل أسير رؤية تحتفي بالأشياء في صورها “العارية” خارج مداها في المتخيل وخارج مجموع الروابط الاستعارية التي نعيد من خلالها خلق الوجود والتنويع من مظاهره.
لقد أُفرغ المتخيل داخلها من مضمونه التأملي والاستشرافي وحل محله إدراك مباشر لحقائق لا يستقيم وجودها إلا من خلال صور لا تنقل واقعا، بل تنمو على هامشه في شكل استيهامات عرضية لا تُخبر عن حقيقة الذات، كما هي في اللغة ومجمل التعبيرات الرمزية المضافة، بل تقدمها اعتمادا على “رتوشات” تُحسن الأصل أو تعدله أو تغطي على جوانب النقص فيه، وذاك هو موضوع “اللايكات” و”الجيمات” في مواقع التواصل الاجتماعي. إن الذات “الحقيقية” لا قيمة لها قياسا بـــ”بديلها” الذي لا يعيش سوى في الصور وضمن سيل التعليقات التي يقدمها عن نفسه أو عن “البدائل” الأخرى. فما يُرى فيها ليس ذاتا تتحرك ضمن فضاء عمودي تستوعبه العين في كل أبعاده، بل انعكاساتها في شاشات المحمول أو اللوحة. إنها حالة من حالات الاستعراء.
وذاك عصب السلوك المراهق، فمن خاصيات المراهقة الرغبة في الكشف عن كل شيء، الكشف عن خيرات الجسد عند الإناث، والتباهي بواجهات الذات البرانية عند الذكور. وهي أيضا قول كل شيء عن النفس والآخرين. لقد اختفت الحميمية وأصبحت “الحياة الخاصة نوعا من الشذوذ”، فلا قيمة “للأصل” و” الحدائق السرية” عند الكبار والصغار. ومع ذلك، فإن هذا “الكشف” لا يخلق فيضا في الشهوة عند الرائي، إنه، على العكس من ذلك، يُـخْصي العين ويحرمها من تجسيد الرغبة في ما تخلقه هي، لا في ما يقدمه الجسد العاري. وهكذا عوض أن يكون العري حافزا على الاشتهاء، يتحول إلى نكوص استمنائي.
إننا نقول كل شيء عن أنفسنا وعن الآخرين، لم يَعُد الواقعي ملاذا تحتمي به الذاكرة وتبحث فيه عن حقائق الوجود، بل أصبح يافطة برانية تنشرها العين في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد أصبح “الأكل” و”المشي على الشاطئ”، و”السفر ” أحداثا كبيرة، كما أصبح تعليق عابر على حدث عابر “موقعة” حقيقية تنال من الجيمات واللايكات ما لم يحظ به أبطال التاريخ مجتمعين. إنه الاستعراء المعمم: فما الفرق بين كيم كاردشايان، وهي نجمة مزيفة لا تملك من المواهب سوى “فيض من اللحم ” تنشره في الفضاء الافتراضي على مدار الساعة، وبين مجموعة من “المتعلمين” الذين يقضون اليوم بأكمله يتحدثون عن تفاصيل في حياتهم كانت إلى الأمس القريب تُعد جزءا من “حميمية” يحرص الناس على حمايتها من كل أشكال التلصص. يبدو أننا وصلنا إلى حد الإدمان في ذلك، فلو اختفت شبكات التواصل الاجتماعي، لا قدر الله، لأصيب نصف العالم بالجنون والاكتئاب.
لقد أعلنت “المرآة النفسانية” قديما عن ميلاد “ذات واقعية” اكتشفت جسدها في استقلال عن “الشيء” (فرويد) واستقام وجودها خارج إكراهاته؛ أما “مرحلة السيلفي” فأعلنت ظهور كيان جديد يمكن رده إلى ” ذات افتراضية”، بتعبير المؤلفة، موطنها الأصلي ومثواها هو مساحات في “فضاء أفقي” لا يتسع سوى للحظة ضمن “المباشر المتصل”، بتعبير المؤلفة دائما. وهي لحظة لا تقود إلى الانفتاح على زمنية ممتدة في ممكنات الذاكرة، بل منكفئة على نفسها فيما يشبه حركة مكرورة بإيقاع واحد. لقد سقطت المشاريع الكبرى –في السياسة والفلسفة والقيم – ولم يبق هناك سوى لحظات تُعاش وفق إيقاع استهلاكي لا ينفتح على أفق، بل يجدد الرغبات ضمن دورة زمنية يحاصرها الحاضر من كل الجهات. وتلك أيضا تبعاتها على تصورنا للزمنية ذاتها، لقد فقد الزمن امتداداته خارج مدته في اللحظة، وتحول إلى كَمِّ يستوعب فعلا مباشرا “هنا والآن”، كما يقتضي ذلك فعل الاتصال المباشر والآني وإكراهات الرابط وضرورة “النقر” وهشاشة الصور التي تستوطن الشبكة.
إن خاصية الزمن الرئيسة كونه مصفاة لا تُقَدَّر اللحظةُ داخله إلا بما يمكن أن تراكمه أو تُغيره أو تفتح أفقا نحوه. كل شيء تغير الآن. فنحن لا نعيش اللحظة، بل نصورها، ولا نستمتع بالحسي حولنا، بل ننتشي بصور خالية من أي دفء إنساني، ولا نستحضر لحظات مشرقة أو سوداء من ماضينا، بل نتلذذ بما تهبنا الشاشات وتعرضه على العين خارج مضاف النظرة فيها. إن العين لا تبحث عن العالم في محيطها، فكل ما في هذا العالم مودع في صور “تشبه ” الواقع ولكنها لن تكونه أبدا. فنحن نتعرف الأشياء في الصورة قبل أن تراها العين عيانا. إننا نعيش في ما يشبه حالات “استعراء”، خاصية العين الأولى فيها أنها دائمة التلصص.
لقد فقد العالم ذاكرته، فلم يعد فضاء تؤثثه حكايات يرددها الناس عن الأشياء الحقيقية أو المستهامة. إنه لا يُكتَب، أي لا يسكن المجرد والمفهومي والحكايات، بل يُرى في الشاشات بكل أنواعها. لم تعد الكلمات حضنا للانفعال الذي يلتقطه الوجدان ويعيد صياغته وفق حالات النفس، لقد حلت محلها “غاجات” للتسلية (gadget)* والترفيه والتواصل السريع، هي تلك التي تمثلها مجموع “السمايلات” المنتشرة في الحواسيب والهواتف المحمولة، ما يطلق عليه الشباب اليوم “الإيموجي” emoji، وهي كلمة مستعارة من اللغة اليابانية وتدل على ما يُكتب بالصور، كما تذكر ذلك المؤلفة.
يتعلق الأمر من خلال هذه “الإيموجات” بترويض الانفعالات وإيداعها في أشكال هي أدوات التواصل بين الناس. أو هو “تنميط” للمشاعر والأحاسيس: فالقلب مستودع لكل حالات الحب نحو الأخ والصديق والأم والزوجة والابن، وهو ذاته الذي نرسله إلى امرأة نعتقد أننا نحمل لها من المشاعر ما يجعلنا نُسكنها قلبا لا نعطيه لسواها. لقد تساوت كل الانفعالات في كل الحالات ومع كل الناس. إننا نعيش في عالم مفرط في التواصل يشكو الناس داخله من الوحدانية والعزلة. “فلا أحد ينظر إلى أحد، ووحدها نظرات الرجال والنساء في الملصقات التي تزين الشوارع والمحطات تلاحقنا في كل مكان” (1).
بعبارة أخرى، إن التجربة الحياتية تتحقق الآن داخل الزمن بطريقة لم يألفها الناس. لقد وُجهت الزمنية داخلها وفق ما يشتهيه نظام اقتصادي يبيع كل شيء وليس معنيا سوى بالربح وحده. هناك إبدالات جديدة تتحكم في “صبيبه” وهي ما يحدد أشكال تَجَليه وطريقة انتشاره. فلا شيء يَلُوح في الأفق عند الناس، ولا شيء يأتيهم من الماضي، كل شيء يتم ضمن “الرغبة” باعتبارها لحظة هشة تشكو من جاذبية الأحلام ومتعتها. فما يلهث الناس وراءه ليس “أملا” أو “رجاء”، بل محاولة للإمساك بمضمون شحنة انفعالية لا تُشبَع إلا في الافتراضي وفيما يقدمه الهاتف المحمول، أو ما تُلوِّح به “جدران ” الفايسبوك التي تُعطي بسخاء وتستعيد ما أعطته حسب ما تقوله “الجيمات” ( اللايكات) أو تتجاهله بعيدا عن حقائق أو مشاعر صادقة تستوطن اليومي.
لقد “أُقصي” الزمن “الفعلي” من الفضاء العمومي وأُودع في مساحات الافتراضي ضمن ما تُبيحه الحواسيب واللوحات والهواتف المحمولة، وهي أشكال تواصلية جديدة تتحكم في وجودنا وتُوجهه وتَشْرِطه بكل ما يجب أن يقود إلى الاستهلاك وحده، ففيها أودعنا كل شيء : الرغبة والحلم والذاكرة، وإليها نَهرب من واقع لم نعد ندرك تفاصيله إلا من خلال الصور الدالة عليه. يتعلق الأمر بإشباع لرغبات يتحقق جزء كبير منها في ممارسات لَهْوٍ يقوم به الكبار والصغار في كل مكان: في البيوت المغلقة وفي المقاهي والبارات والحدائق العمومية. وقد يكون هذا ما يُفسر ظهور وحدات جديدة لقياس حجم الزمن بعيدا عن فعل يمتص جوهره ويحوله إلى “تعب” و”جهد” أو “حسرة” و”ندم” و”ترجي”، فما يؤثثه الآن حقا هو “لَهْو عابر” يتم ضمن حاضر عابر خال من الأحلام.
فما هو أساسي في الزمنية الافتراضية، أو ضمن تبعاتها، ليس الزمن في حقيقته، بل طريقة تحققه في أفعال بلا “غاية”، هي ما يشكل المعنى المستحدث للحياة. لا يتعلق الأمر بإحالة مباشرة أو ضمنية على ما يمكن أن يَنتج عنه مردود محسوس، بل بما يؤكد الطابع الاستهلاكي للنمط الحياتي السائد أو الآخذ في الانتشار، أي تحديد فضاء حسي استهلاكي هو الهوية الوحيدة التي يحضر من خلالها المواطن في الفضاء العمومي. فمن خلال هذه الحسية يعيش الناس الزمن خارج إيقاعه المعتاد، أو يعيشونه ضمن ما يمكن أن ينسيهم وجوده: فَصْل الحقائق الواقعية عن تربتها الأصلية وتحويلها إلى تمثيلات بصرية هي الحاضن للزمن الوهمي في الذات. وهو ما يعني أن الانفتاح على العالم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عزلة قاتلة: إن استهلاك الزمن لا يتحقق داخل حميمية مباشرة، بل من خلال “البلازما” الباردة، أو على أمواج أثير لا يمكن أن يكون بديلا عن لقاء فعلي.
إن الزمن جزء من إيقاع حياتي يستوعب وجود الناس، وهو ما يشكل الواجهة التي يقيسون من خلالها ما تحقق أو ما هو في طور التحقق، أما ما تقترحه الشركات الكبرى والفضاءات الافتراضية فشيء آخر، إن “زمنها” موجود على هامش الزمنية الأصلية، أو هو موجود لكي يتم استهلاكه خارج أي إيقاع عدا إيقاع الوهم الافتراضي. ولذلك وقْع على الذاكرة ذاتها، وهي “العداد” الداخلي للزمن. لقد تحول النيت إلى ذاكرة هائلة تختزن معارف الكون كله؛ وهو في ذلك وفر على الناس الجهد والبحث المضني عن المعلومة، لكنه حرمهم من ذاكراتهم أيضا. فكل شيء موضوع بين أيديهم، ولكن لا علاقة له بالذات التي تتطور وتنمو “في الشك الذي يؤسسها ومن خلاله تكبر “(2). فنحن لا نتعلم من النيت، إننا نستهلك معارف بدون مصفاة. إننا لا نراكم خبرة، بل نلتقط معرفة تقنية لتدبير سلوك مباشر، إننا ننتقل من “تقنيات ” إلى أخرى وفق ما يمكن أن تأتي به الابتكارات الجديدة خارج ما يمكن أن يكون له وقع على هويتنا. لقد داهمتنا التقنية الحديثة ونحن ما زلنا أسرى تفكير غيبي ممتد إلى الماضي.
بعبارة أخرى، إن الزمن موجود لذاته، لا من أجل استيعاب معنى الوجود عند الإنسان. وهو ما يعني أننا لا نُسرب الإرادة الإنسانية ضمن دفق الزمن من أجل توجيهه إلى آت أفضل، وبذلك نرفض ما هو سائد أو ما تحاول آليات الاستغلال تأبيده. إننا، على العكس من ذلك، نتصور الزمن باعتباره “سلة” ( زكي العايدي)، أي كَــمَّا بلا شكل لا يراكم ولا يتقدم، ولن يكون في نهاية الأمر سوى حاصل لحظات معادة تتكرر في الأشياء التي تصورها، وبذلك تكون محرومة من أي أفق تحرري. لقد أُعد هذا الزمن لكي يكون حاضنا “للإنسان/الحاضر”( زكي العايدي).
وهذا دليل على أننا نعيش الزمن “بالمباشر” الافتراضي خارج تمفصلاته الأصلية التي تجعل منه كيانا قابلا للعد. لقد تحولت الحياة الحقيقية إلى “موعد” عابر في الواقع، لحظة بسيطة مستقطعة من زمنية تُعاش في الافتراضي وحده. لقد حرمنا النيت من أن نكون وحدنا عندما أوهمنا أننا لن نكون وحدنا أبدا. وفي الحالتين معا، ضاع منا ما يشكل جزءا من ” هويتنا”، ما يعود إلى ما يأتي به الحوار الداخلي الذي نجيب فيه عما يضعه الزمن علينا من أسئلة خارج “الكلام”. لقد تحول “الإنسان من أجل الموت” ذاك الذي كان يصرف قلقه في فعل إبداعي منتج، إلى “إنسان من أجل الكلام” يصرف رغباته في عبثية صوتية بلا طائل.
لذلك أدمن الناس الكلام، في الشوارع وفي الفضاءات المغلقة وفي ظلمات الفايسبوك. لم يعد الكلام نشاطا يُعَبر عن خاصية من خاصيات الإنسان، فهو الناطق وحده دون غيره من الكائنات، بل أصبح نشاطا تُقاس مردوديته بما يمكن أن يتحقق له من وظيفة جديدة تتلخص في “الثرثرة” وحدها، فنحن نتكلم لأن في حوزتنا “زمنا” في حاجة إلى الاستهلاك. فضمن حالات الاستهلاك المعمم هاته يفقد الزمن قيمته، إنه يُفرَغ من الأحلام الممتدة في آفاقه لكي يستوعب رغبات يغطي عليها “حوار” بلا سياق ولا مقام ولا قصد. فهذا ” النشاط الكلامي” لا يلبي حاجة: حاجة التواصل أو حاجة التفكير والتعلم والتعليم، بل يُعد في ذاته وظيفة تحتاج إلى مُنْتَج موضوع للاستهلاك. لقد أصبح الناس مُدْعَوْن إلى تخصيص زمن “للكلام” يكون خاليا من أية مردودية عدا الكلامَ ذاته.
بعبارة أخرى، يتكلم الناس خارج “كلام” المعرفة، وخارج ما يقتضيه الشرط الاجتماعي في التواصل. وبذلك تبدلت أشكال حضورهم في الزمنية، فهم لا “يملئون” وقتهم بفعل منتج، بل يَبْتاعون كَمًّا زمنيا من السوق لكي لا يتوقفوا عن الكلام أبدا. وبذلك يكون الكلام، وليس الزمن، هو الدليل الوحيد على وجود مدى محسوس يفصل بين لحظة وأخرى، فلا قيمة لزمنية موجودة خارج حدود الكلام. لقد تحول هذيان السكارى في الكثير من الحالات إلى ” إبداع” يحظى بالكثير من اللايكات.
إن الاستغراق في الفعل يُعَطل التفكير، أما الاستغراق في الكلام فيُعطل التأمل والتفكير والعمل في الوقت ذاته. يُمنَح الناس أكبر قدر من الزمن لكي لا تكون لهم لحظة واحدة ليتأملوا ذواتهم أو محيطهم، ويحاصرونهم بالحاضر وحده، لكي لا يُسقطوا ما يشكل حلما في وجودهم، أو يستعيدوا لحظة من الماضي تستثير عندهم حنينا أو ندما. إن اللحظة وحدها قابلة للقياس وقابلة للتلاشي في الوقت ذاته، لأنها غير محددة بغاية بعينها غير استهلاك الكم الزمني المودع في المحمول.
وبهذه الطريقة خَلَّصَنا الكلام من الزمن الفعلي، زمن الحياة والعمل والموت والمتعة الحقيقية، لكي يجعلنا نعيش ضمن زمن افتراضي غير قابل للقياس، أو لا يُقاس إلا بفراغه. وكما يفعل فوتوشوب بصور العارضات والممثلات حين يُـخفي عيوبهن، يفعل بنا الهاتف وفضاءات التواصل الافتراضي حين يقدم لنا زمنية هادئة بسيطة تُختصر في “جيم” ( لايك) يُصَفي الواقع من طابعه المركب ويعوضه بصور صامتة تشكو من خصاص في الحميمية الإنسانية.
لقد اختفى المواطن وحل محله مستهلك يقيس حجم الزمن في حياته بكميات الأشياء التي يستهلكها. لقد انتقلنا، ضمن هذه الزمنية الجديدة، من الإنسان الفرد الذي يأتي إلى “الفضاء العمومي” يحمل قيما وأحلاما ورؤى، إلى ذات مشدودة إلى حاجات تقتضي إشباعا في “الآن وهنا” وحدهما، إنها تتصرف استنادا إلى علاقتها بموضوع استهلاكي هو الواجهة التي تحضر من خلالها في عين الآخر. انتهى الزمن التاريخي لكي يحل محله الزمن الراهن الذي لا ينتشر قبلُ ولا بعدُ، بل ينكفئ على اللحظة وحدها.
وهو ما يعني أن نفوذ الآلة وسطوتها لم يَقُودا إلى تحرير الذهن من مخلفات ماضيه “الخرافي”، وإنما أفرزا، على العكس من ذلك، عددا هائلا من الأيقونات الجديدة التي تُرمى إلى القمامة مع انتهاء صلاحيتها: “الأبطال” الرياضيون وعارضات الأزياء ونجمات التلفزيون والكثير من المهرجين والمهرجات، ولائحة أخرى لا تنتهي من الباحثين عن “شهرة” عارضة في عالم افتراضي من خصائصه أنه لا ينتقي صوره ولا يراكمها، بل يعوض بعضها ببعض. وضمن هذا “الفيض”، يجد الذهن صعوبة متزايدة في التفكير استنادا إلى ممكناته، فهو في حاجة دائما إل تشخيص وضعيات يستطيع من خلالها تحديد بعض من دلالات تتلاشى مع تلاشي الصور التي ولدتها.
أما بعد، يُعد هذا الكتاب صرخة مدوية في وجه عالم يحاصر قاطنيه بكل أشكال الزيف والتشييء والجهل المعمم. إنه لا يصف ما هو واقع فحسب، بل يحذرنا مما هو آت في المقام الأول. لقد فقدنا صلتنا بالعالم الواقعي، وتحولنا إلى أدوات في يد نظام اقتصادي يخلق كائنات موجهة للاستهلاك وحده. لقد سقطت الكثير من أحلام الإنسانية، أو تراجعت، وأصبح الناس يُعبرون في الفضاء الافتراضي عن رفضهم لكل أشكال القهر والغبن و”الحكرة” في ما يشبه حالات “إحماء” ثوري يتم تفريغه في اللايكات والجيمات الساخطة. إنهم يخوضون معارك بـ”بدائل”، في ظلمات فضاء افتراضي لا يستطيع استيعاب مشاعر لا تختفي باختفاء الجيمات أو اللايكات، ويعودون صباحا إلى مواقعهم يعيشون بحقائق هي مصدر عيشهم وشرط وجودهم الحقيقي.
—-
*- شيء مستحدث يتميز بصلاحية محدودة في الزمان وفي المكان.
1-Pierre Fresnault-Deruelle : Images fixes III, éd P U F ,1993, p 27
2- Marc Dugain , Christophe Labbé : L’homme nu, la dictature invisible du numérique, éd R Laffont Plon, 2016, p.166