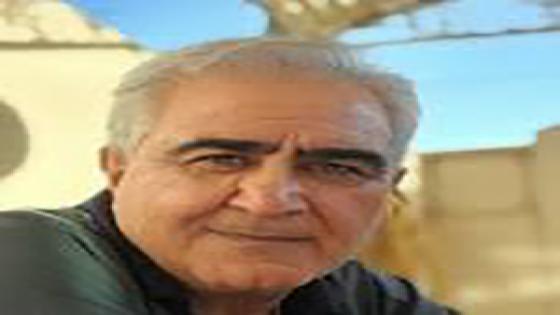مقدمة المترجم
سعيد بنگراد
تندرج الصورة وإنتاجها وأنماط تلقيها ضمن سلسلة من البداهات التي غالبا ما يحتكم إليها الحس السليم من أجل تحديد حالات التطابق أو التشابه بينها وبين ما تقوم بتمثيله. فهي في العرف جزء من طبيعة المعطى الموضوعي التواق إلى وجود مضاف يقي الأشياء والكائنات شر الدهر وصروفه. فالصورة – ضمن هذه البداهات أيضا- هي استعادة لجزئية من فضاء ممتد إلى ما لانهاية وفق معايير تلغي الزمان باعتباره مدى محسوسا أو تعاقبا في كل شيء : كل صورة هي في الأصل نفي للزمن من حيث هي تأبيد للحظة.
إن ما يأتي إلى العين، عبر العدسة والرسم واللوحة، وفق الحس السليم والرؤية الساذجة دائما، ليس شيئا آخر غير ما يمكن أن تُصَدِّق عليه معطيات واقع عنيد يثق في تجلياته، لا فيما يمكن أن تقوله عين الفنان. إن الأمر يتعلق بتشابه أو بتماثل بين لحظة في الطبيعة وأبَدٍ مطلق في الصورة. إن هذا “التشابه يربط الصورة بالواقع المدرك، إنه لا يفترض سوى توافق بين حقل الرؤية وبين صورة تحل محله” (1). إنه قاسم مشترك بين الحس السليم وبين واقعية تصويرية تدعي القدرة على استعادة العالم الممثل كليا أو جزئيا.
والحال أن الأمر على النقيض من ذلك، فالصورة شيء آخر غير استنساخ حرفي لواقع مرئي لا مراء فيه. فما يأتي إلى العين هو ” نظرة تنظر” إلى الأشياء لا الأشياء ذاتها. إنها لحظة فنية تقوم باستعادة ظلال خفية هي ما يشكل الفواصل التي لا تراها إلا نظرة تبحث في الأشياء عن جوهرها لا عن تجلياتها المباشرة. إن “صورة الهوية” ذاتها ليست، إلا في الظاهر، معادلا محايدا لأصل لا يمكن أن تنكره العين. فحيادية اللقطة و”نفعيتها” لا يمكن أن تلغيا تعبيرية النظرة كما يمكن أن تتسلل إلى وضعة هي في الأصل أسْر وترويض لانفعالات بعينها. وهو ما تُشير إليه الدلالات الممكنة للوِضعات الفوتوغرافية المشهورة: الأمامية والخلفية والجانبية.
إن العالم موضوعي في ذاته لا في وعي الذات التي تلتقطه في كليته أو في تفاصيله. فالعين ترى عبر وسائط الثقافة والمخيال والمعتقدات ( ترى العين ما تود أن تراه لا ما يمثل أمامها)، بل هي محكومة أيضا بهشاشة الإبصار ذاته ( بما فيها حالات السن والمرض والتعب). واستنادا إلى هذا، يتعلق الأمر، في محاولة تحديد العوالم المصورة، بالفصل “بين ما ينتمي إلى التخيل القادر على استثارة صور من الواقع، وبين ما ينتمي إلى تجربة النظرة. إن الحقيقي ليس بالضرورة محتملا. وفي المقابل، يمكن للتخييل أن يكون محتملا” (2). “فالعوالم الممكنة”، باعتبارها بناءات ثقافية، تستقي صورها من واقع مرئي، ولكنها تنزاح عنه من خلال الإضافة والحذف والتعديل ( العفريت شبيه في بنيته العامة ببنية الإنسان، ولكنه يختلف عنه من حيث إن له ذيلا وقرنين، كما تعلمنا ذلك في كتب “اقرأ” منذ أن كنا صغارا).
فما تستوعبه النظرة ليس واقعا بل معرفة بهذا الواقع، معرفة مصدرها النظرة ولا شيء سواها. “لقد تخلت ” تفاحة ” سيزان، وهي تتسلل إلى اللوحة، عن كينونتها لكي تصبح ظاهرا في عين تتأمله. وهذا الانفتاح على الظاهر هو ما تعبر عنه الألوان والنور ولعبة التركيب في اللوحة” (3). وهذه الأشكال والألوان ذاتها ليست، في نهاية الأمر وبدايته، سوى معطى طبيعي استُنْبِت في ذاكرة رمزية منها يستمد اللون والشكل قيمته التعبيرية دونما اهتمام بوظائفه الأخرى، بما فيها الوظيفة الزخرفية، كما قد توحي بذلك مظاهر الأشياء.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن أن يكون موضوع الصورة “واقعا “مباشرا تدركه العين دون وسائط، فالمعطى موجود خارج الصورة وخارج العين التي تصوغها. إنها، على العكس من ذلك، تستثير، فيما وراء المرئي المباشر، سلسلة من الانفعالات التي تهرب من الملموس لتختبئ في الرمزي الذي يستعصي عادة على ضوابط العقل ومنطقه. وتلك حالة كل الانفعالات، فهي “مشروطة في وجودها بغياب الخطاب…. فالانفعال والتعليق لا يحتكمان للعصب نفسه” (4). إن الخطاب يعلق على الأشياء من خارجها، أما الانفعال فطاقة تعبيرية تجاهد الكلمات على ترويضها. إحساس غامض في هذا الجانب، وضبط مفهومي يعزل ويفصل ويصنف في جانب آخر.
إن غاية كل تواصل بصري هي استنفار لكَمٍ هائل من الأحاسيس التي تتوسل بالنظرة أكثر مما تستدعي اللفظي لإدراك مداها. إنها مبثوثة في الحجم واللون والشكل والامتداد. لذلك، فإن “اللوحة تحرمنا من الكلام لكي تعلمنا فن النظرة” (5). وكما أن الإغراء طاقة انفعالية تستوعبها دوائر الرمزي (6)، فإن الفن ذاته لن يكون سوى”تدمير رمزي لكل أشكال السلط “(7)، بما فيها سلطة الوجود العيني للأشياء.
وهذا أمر دال على ممكنات التعبير الهائلة التي يتوفر عليها الإنسان. فالحواس عنده ليست منافذ محايدة مفتوحة على عالم مادي فحسب، إنها بالإضافة إلى ذلك، وربما في المقام الأول، أدوات تعبيرية، شأنها في ذلك شأن المفاهيم التي يختص بها اللفظي وحده.”فالإنسان يتواصل، في البث والاستقبال، عبر جسده، أي من خلال إيماءاته ونظرته وأدوات اللمس والسمع عنده، ويقوم بذلك أيضا من خلال الصراخ والرقص والميم (mime)، إن كل أعضائه قابلة لأن تتحول إلى أدوات للتواصل” (8). إنها طاقة الإيحاء وقدرته على نقل العضو والحاسة من بعدهما النفعي إلى ما يشكل دوائر المتعة حيث يحل الرقص والمداعبة والإنصات والنظرة محل المشي واللمس والسمع والبصر. لذلك، فالصورة لا تكتفي بالتمثيل “الصادق” لتجربتنا، إنها تكملها، إنها تكشف عن الكامن داخلنا.
إن الفن، من هذه الزاوية، والصورة ضمنه، لا يستنسخ الواقع ولا يعيد إنتاجه، ولكنه “يأتي بما يغطي على النقص فيه”، على حد تعبير كاندينسكي. إنه أسر لقوى مخيالية تستوطن الأشياء والكائنات بأشكالها وألوانها. فاللوحة لا تتكلم، فهي” تتحكم بيسر في الانفعالات أكثر من تحكمها في المفاهيم” (9). فالمفاهيم شأن لفظي غايتها تعميم تجارب العين والحد من مغامراتها، لذلك فهي تميل إلى الكوني. أما الصورة فتمثيل لا يستند إلا إلى خصوصية النظرة. لذلك تصنف عادة ضمن الأدوات التعبيرية المولدة للأحاسيس والانفعالات والتداعيات، إنها وسيلة للاستثارة لا إحالة على مقولات. إنها ليست عقلا، بل ما يسهم في تحييده.
إن العين تروض وتضفي طابع الألفة على كل ما يحيط بها. إنها تلتقط كيانا في خصوصيته وتحوله إلى خطاطة استنادا إليها تتعرف استقبالا على نسخه. وهذا ما يفسر، في جزء كبير منه، الرفض القاطع لفئة عريضة من المسلمين ( السنة) تشخيص النبي وصحابته الأقربين. فالتشخيص “ألفة” و”مماثلة ” ( لا يجب أن يكون الرسول ممثلا من خلال صورة، فذاك يقلص من واجهات حضوره في ذهن المسلم). إن الأمر في حالة التشخيص يتعلق بنشاط إدراكي، والإدراك يفرض الشيء على الذاكرة، إنه يقلص من ممكنات التمثل داخلها من حيث كونه يفرض على العين نسخة. والحال أن الشكل الذي يحضر من خلاله هؤلاء في الذهن هي “صورة ذهنية”، والصورة الذهنية “مطاطية” و”حمالة أوجه” ولا يمكن أن تتجسد في نسخة وحيدة. لقد رفض المسلمون الأصنام لأنها مرئية، كما رفض إبراهيم من قبل الكوكب والشمس والقمر آلهة، لأنها تظهر وتختفي، والله لا يختفي لأنه أكبر من أن يحيط به بصر إنساني ( كان القديس توماس الأكويني يقول إننا لا يمكن أن نعرف الله من خلال حدود مألوفة).
وللنظرة في عالم الصورة موقع خاص، فلا وجود لهاته دون تلك. فخلف الممثَل تختبئ الرؤى التي تسْتَلُها العين من جوهر الأشياء وتودعها في وضعيات لا تثير شبهة الرائي. فاللقطة الفوتوغرافية ( وكذلك خطوط الرسم وتقطيعات الرشيمات وأشكال اللوحة وألوانها) ليست سوى تجسيد لما يمكن أن تأتي به أفعال العين. لذلك، فإن تاريخ الصورة هو تاريخ النظرة ذاتها. إن النظرة لا ” تَرى” ولا تلتقط الشيء كي تضيفه إلى ما يؤثث أشياء الذاكرة، إنها مضاف طارئ حوَّل العين إلى نافذة تلتقط الثقافي في الطبيعي وتصنفه ضمن العوالم الرمزية.
فالحديث في الظلام ناقص دائما، لأن الأذن لا تغني عن العين وليس للسماع قوة النظر. وهذا ما يفسر أن أغلب الناس ( إن لم يكونوا جميعهم) لا يستحسنون حوارا في الظلام،” (…) فلو كان استماع الأذن غنيا عن مقابلة العين لما تكلف القائل ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه” (10).
إن الإبلاغ البصري ( بأبعاده وأنماط تحققه) هو خلاف طاقات الكلام. فالعين في هذا المجال “لا ينظر إليها باعتبارها عضوا للبصر، إنها في المقام الأول سند لنظرة ” (11). إنها، من خلال وظيفتها تلك، بؤرة تنتهي عندها كل أشكال التحديدات الدالة على جوهر الإنسان وكينونته. ولقد أودع الإنسان في هذه النظرة كل طاقاته الانفعالية كما يمكن أن تتحقق في علاقته بذاته وبالآخرين، بما فيها علاقته بعالم الأشياء. لذلك لا حدود في واقع الأمر لهذه الطاقة، رغم كل المحاولات المضنية التي يقوم بها البعد اللفظي من أجل تسييج بعضها ضمن أحكام احتفظت بها الذاكرة الشعبية في بعدها التصويري واستخدمتها في بلورة سلسلة لا متناهية من الأحكام الاجتماعية.
فاستنادا إلى شكل العين أو هيئة النظرة، أو انطلاقا من التصنيفات الدلالية المسبقة المودعة في العين والذاكرة ( النظرة الحادة والقاسية والماكرة والمتوسلة والمتوعدة الخ ) يمكن تحديد التفاعل الممكن بين الذوات ضمن وقائع الإبلاغ الفردي أو الجماعي على حد سواء: تقول شخصية من شخصيات روايات نجيب محفوظ :”نظر إليها نظرة لو تحولت إلى كلمات لوقعت تحت طائلة القانون”؛ فالعين تقول ما تهاب الكلمات التعبير عنه. إن النظرة، من هذه الزاوية، هي ” نظام رمزي يختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن فئة اجتماعية إلى أخرى” (12).
ولنا في جسد الإنسان سند لذلك، “فالإنسان وحده اختص بالوجه، فالله الذي فوق الناس جميعا لا وجه له” (13). فلا شيء في تعبيرية الجسد لا يمكن ألا يرد إلى ما يشكل مادة للتذكر وسبيلا من سبل التعرف. إن الهوية وجه، فهو ما تلتقطه العين وما تحتفظ به الذاكرة، وما تحتفظ به أرشيفات أجهزة الأمن في كل أصقاع المعمور. إنه “موطن اللغة وزمنها، وموطن نظام رمزي يستعيد، في الحياة اليومية، امتداداته في كل الأعضاء الأخرى” (14). لذلك فهو مادة رمزية لا تنضب ( وجه الله والوجهة والوجيه والواجهة والوجاهة والمواجهة وماء الوجه ووجوه القوم…).
إلا أن الوجه ذاته ليس سوى ممر نحو ما يشكل النقطة التي تنتهي عندها كل صفات الهوية. إن الأمر يتعلق بالعينين، فبإمكاننا من خلال سلسلة من التبسيطات المتتالية أن نختصر الكائن البشري في شكل عينيه بكل الطاقات التعبيرية فيهما: إنها النظرة، ما يشكل “الإنساني” في الإنسان وحده. لذلك، فإن موقع الإنسان في هذا الكون فريد جدا، “فهو يشكل، أكثر من غيره، بنية مألوفة ( الكل يعرف كيف يرسم “شخصا”)؛ وذاك ما تؤكده الخبرة الإنسانية في مجال التعرف على الآخر. إن الإنسان الماثل أمام العين لحظة التواصل، هو في المقام الأول وجه، بنية أخرى مألوفة، فُضلت داخله بعض السمات على حساب أخرى، وخاصة العينين. فالعينان على هذا الأساس، هما، بمعنى ما، “مركز” ينتظم حوله ما تبقى” (15). و”ما يتبقى” بعد ذلك يصنف ضمن الوظائف البيولوجية المرتبطة بالنفعي في الإنسان.
وكأن البعد البصري في الإنسان أقوى من كل الحواس، فالعين تردع وتتوسل وتنذر وتمكر وتتوعد، إنها خزان كبير لصور ممكنة، أو هي القدرة عندها على تقطيع “المدرك البصري” استنادا إلى قيم دلالية مسبقة وفقها يأتي المدرك إلى العين في شكل مواقف لا في شكل أشياء.
وهذا ما تؤكده ذاكرة الإنسان القديم ذاتها، وتؤكده لقى الحفريات أيضا. فمنذ أن بدأ يعي ذاته في انفصال عن محيطه، تحولت العين عنده من الإبصار إلى النظرة. حينها فقط بدأ “يكتب” انفعالاته على جدران الكهوف ( أولى أشكال الحميمية عنده ) ويصممها على هيئة دمى وأدوات يستلها من طين الحقول، لعلها تحميه من شر الخوارق في الطبيعة أو في الكائنات التي كانت تقتسم معه البراري الممتدة في كل الآفاق. لقد انتزع هذا المحيط بقوة من الدفق الزمني ليودعه في “ثبات” الصورة: تلك أولى انتصارات الإنسان على زمن لا يتوقف. لقد كف الإنسان عن”الرؤية” ليصبح “ناظرا”. والرائي خلاف الناظر، إن الرؤية تشد إلى الشيء بحكم وجوده الموضوعي لا غير، أما النظرة فتخلق الأشياء خلقا. إن الرائي يعاين ما يمثل أمام العين، أما الناظر فيلتفت إلى “الحجم الإنساني” فيه.
لقد رأت عينا الإنسان القديم آلاف الحيوانات فألفت وجودها، لقد كانت هناك أمامه منذ آلاف السنين، ولكنه لم يدرك وجودها الرمزي إلا عندما تعلم كيف”ينظر”، أي كيف “يتحايل” و”يمكر”، وتعلم أيضا الاستعمال الرمزي لموضوعات محيطه. لقد بدأ يلتقط الأشكال والألوان في الشيء لا الشيء ذاته. حينها منح الوجود شكلا مضافا، فجسد أشكال الحيوانات وحجمها ولونها، بل جسد أشكالا لحيوانات أخرى هي من صنع خياله الذي أرهقته هواجس مصدرها المجهول في الطبيعة والعلاقات الاجتماعية. ولم يكن ذلك، في جميع تحققاته، استنساخا لموجود واقعي كما يتوهم البعض، بل هي حالات تجريد لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إسقاط التصويري ذاته.
وهذا ما أثبتته أبحاث المختصين في مرحلة ماقبل التاريخ.”فالشيء المؤكد عندهم أن الغرافيزم ( التعبير بالرسم) بدأ من خلال التجريد لا من خلال التمثيلات الساذجة للواقع ” (16)، وأدرك الباحثون سريعا زيف هذه الفكرة وردوا الاهتمامات ذات الطابع السحري الديني إلى الفن ” التشخيصي” للعهد الرابع (17). إن الملموس في العين ممر ضروري نحو المجرد في الوعي. فالمدرك ( بكل أشكاله) يحضر في الذهن من خلال تحيزه في الفضاء وتعاقبه في الزمان، ولا وجود له خارج هذين البعدين. ولذلك لا يمكن الحديث عن التجريد في الرسم إلا من باب المجاز، فما تقدمه الصورة شيئا ملموسا، ولكنه هو وحده القادر على فتح أبواب التمثيل الرمزي المجرد.
إن العلامات ( الصورة ضمنها ) هي الأساس الذي تقوم عليه رمزية الإنسان. إنها الأداة التي مكنته من التخلص من العرضي والمتنافر والمتعدد واستعادته على شكل مفاهيم مجردة تكشف عن انسجامه ومعقوليته. إنها الأشكال الرمزية ( كاسيرير)، التوسط الإلزامي في حالاته القصوى بين المرئي والرائي.” فنحن نتحكم في الأشياء عبر العلامات، أو بواسطة أشياء نحولها إلى علامات” (18). إننا نُخضع العالم لتقطيعات النظرة ( كما نخضعه للتقطيع المفهومي اللفظي) لنستطيع بعد ذلك انتقاء العلامات التي تمكننا من الإفلات من إكراهاته.
وهذا أمر بالغ الأهمية ودال على مفارقات ليست كذلك إلا في الظاهر. فالإمساك بجوهر التجريد لا يمكن أن يتم إلا من خلال إسقاط حالات الملموس التي تقود إليه، فأشد العوالم رمزية إنما تتحقق في أشياء محسوسة. لذلك، فإن كل “الإرساليات البصرية التي تنحو نحو التجريد لا تخلو بدورها من ميل إلى الاستعانة بتوسط موضوعات العالم الخارجي” (19). فالعالم لا يحضر في الذهن إلا من خلال وظيفة التمثيل، “وكل تفكير يفترض وجود سند ملموس هو ما يجسد في نهاية الأمر فكرة المجرد”، على حد تعبير أرسطو (20).
لهذا السبب، لم تكن غاية الإنسان القديم وهو يرسم حيوانات محيطه إعادة إنتاج نسخة منها، فذاك عمل لا طائل من ورائه، ولكنه كان يطمح إلى رؤيتها كما تأتي إلى عينيه عبر منافذ القلق في ذاته. وتلك قصته مع السحر ( هل هناك حقا فواصل بين ممارسات السحر وبين عوالم الفن ؟ أوليس الفنان ساحرا بالكلمات والألوان أيضا ؟). لم تكن ممارسة السحر عنده استجابة لرغبة في الكشف عن المخبأ وراء اللامرئي، إنها على العكس من ذلك، تعبير عن إرادة تدفعه إلى محاولة التحكم في المحيط المباشر : ترويض للأشياء والظواهر والكائنات. ولقد”استعان في مسعاه ذاك بالعلامات في المقام الأول. لقد كانت هي وسيلته في تمييز القوى السحرية التي يرغب في السيطرة عليها وتوجيهها. إن الأمر يتعلق بالسحر من خلال المحاكاة، فمن خلال هذه العلامات يعيد إنتاج حركات الحيوان، أو يرسم صورته على جدار المغارة، لكي يراقب الطريدة التي يريد قنصها” (21). فالصورة ملموس مرئي للتعبير عن مجرد لا تدركه العين المجردة.
والصورة أداة سحرية وموضوع للسحر أيضا. إنها امتلاك أبدي لموضوع عرضي ( كائن أو شيء)، وهي بديل يمكن من خلاله التحكم في ما يدل عليه ( تمزيق صورة شخص هو تعبير صريح عن عدوانية تجاهه). وما زالت عرافات العالم وساحراته إلى الآن يستعضن عن الموضوع المسحور بصورته:” فإذا رَمَد عدو أو ظالم فخذ شمع كرة وصوِّر فيه تمثالا على صفة من تريد وارسم عليه الخاتم مع اسم المطلوب وأمه وافقأ التمثال بشوكتين ” (22).
إن الذات التي تتأمل تلتقط صورا وتستبطن أخرى، وتستبدل هذه بتلك ضمن تعاقب لا ينتهي. لذلك، فإن الخلاص لا يمكن أن يأتي من الأشياء، بل مثواه صور هي من صنع العين لا هبة من واقع عرضي. واشتغال الصورة دال على ذلك، فهي لا تطمئن للممثل الموضوعي، “إنها تحفر في المرئي وتقلق النظرة وتسائل الوعي الساذج وتشكك في الثقة المطلقة الني توضع في الإدراك” (23). إنها في ذلك شبيهة بالطريقة التي يشتغل من خلالها الحلم، فالحالم “يفكر بالصورة” ولا مكان للمجرد فيما يؤثث الحلم ويبني عوالمه. لذلك، فإن الصور وحدها قادرة على الكشف عن ميولات “أنا” تحاصرها الممنوعات والإحباطات من كل الجهات. لذلك، لا مردودية للكلمات في الحلم، فصور “المضمون الظاهر” وحدها ممر يقود إلى صور “المضمون الكامن”، كما ألح على ذلك فرويد وأتباعه. وتلك هي طبيعة العلاقات بين الصورة وبين الشيء الذي تقوم بتمثيله، “فهي لا تحاكي وجوده، بل تحاكي غيابه” (24). إنها شكل مرئي لجوهر من طبيعة تجريدية.
وهناك من صاغ هذه الفكرة بطريقة قطعت الشك باليقين وحولت “تجارة العلامات” إلى ضابط وحيد لكل ما يحضر من خلال التصويري، في استقلال عن الواقع أو ضدا عليه في الكثير من الحالات. فقد أكد موريس دونيز ذلك عندما أعلن أن ” وراء كل لوحة تشخيصية لوحة مجردة، ولا تشكل الأولى سوى ذريعة للمرور إلى الثانية” (25). إن ما يثيرنا هو الحزن في العينين لا لونهما.
فلا حاجة لنا إلى التساؤل عن درجة الوفاء للواقع أو الانزياح عنه، فما هو أساسي في عمل الصورة هو الاستعمالات الرمزية الممكنة التي تفتح وحدها الصورة على محيطها القريب والبعيد على حد سواء. فالمعنى (المعاني) في الصورة ليس شيئا آخر سوى العلاقات الخفية التي تربط بين ما يؤثثها. وبعبارة أخرى، إن ما يشكل لغة الصورة هو ما يقود إلى إنتاج المعاني داخلها أيضا. فالوجود الإنساني ( الوضعات ومجمل المواقف وأشكال السلوك المحتملة) والألوان والأشكال والخطوط والإضاءة والإعداد الفضائي والظلال، كلها مداخل أساسية لاستيعاب ممكنات التدليل داخل الصورة.
استنادا إلى ذلك تم الفصل في الصورة بين سجلين مختلفين من حيث الوجود ومن حيث الاشتغال. إنه التمييز بين ما ينتمي إلى التجربة المشتركة في التمثيل والإدراك، وبين ما ينزاح عنها باعتباره مضافا ثقافيا لا يمكن تحديد مداه إلا من خلال ضبط دقيق للسياقات. والسياقات ذاتها ليست سوى ذاكرة لامرئية للصورة، وما يتحكم في هذه الذاكرة هو الموسوعة، أي مجموع السجلات الثقافية التي تعلمت منها العين كيف تنظر وتحملق وتحدق وتحدج…. وكل تنشيط لهذه الذاكرة يقود إلى إسقاط المضمر والضمني والموحى به عبر التناظر أو الإيحاء أو التداعيات الحرة، أو عبر التصنيفات الدلالية المسبقة التي يخضع لها تقطيع المدرك البصري. فلا وجود لصورة تدل فقط على ما تقدمه للعين بشكل مباشر. فالعين “أمارة بالتأويل” دائما، ولا شيء في الكون يمنعها من أن تنتشي بمعان قد يهتز لها من في القبور.
هل كان فرانسوا ميتران يريد من خلال بورتريهاته المتعددة، أن يتعرف جمهور الناخبين على “شخصه”، أم كان يريد التعبير عن فرنسا كما يمكن أن تتحقق في هذا “الشخص” الممثل في الصورة بهذه الطريقة ووفق هذه التقاليد التصويرية وليس غيرها؟ ما قدمه المحللون في هذا المجال يغني عن كل جواب. فهناك من رأى فيها كل شيء، الإيديولوجيا والسياسة والتمثيل البصري للزمن ذاته (26).
لذلك هناك على الأقل مستويان في الصورة: يحدد الأول ما يشير إلى “الموضوعي” فيها، أي ما يوجد خارج العين وسابق على وجودها. ويشير الثاني إلى سلسلة المعاني التي لا يمكن أن توجد إلا في الذات الناظرة وقدرتها على الكشف عن سياقات جديدة هي أصل التمثيل وغايته الأولى. يتكفل المعنى الأول بوصف المعطى الظاهر من خلال سند الصورة ذاتها، أما المعنى الثاني فهو نتاج التأليفات الجديدة التي تعد، في واقع الأمر، قصديات مسقطة هي من صلب النظرة وحاصلها. ولا وجود لفواصل قطعية بين الأول والثاني ( المعاني الثانية). فالوصف ذاته لا يمكن أن يتم إلا من خلال حدود تشتمل هي ذاتها على تصنيفات مسبقة، كما هو حال كل كلمات اللسان.
إن عمل الصورة يتوقف على قدرتها على استيعاب واستعادة مجمل الأحكام والتصنيفات الاجتماعية كما هي مودعة في الأشياء والكائنات. وبعبارة أخرى، يتوقف “الغنى الدلالي” داخلها على قدرتها على الاستعانة بالخبرة الإنسانية في كل أبعادها الرمزية. فالمعنى ليس معطى سابقا ولا محايثا لما يتم تمثيله في الصورة، إنه وليد ما خلفته الممارسة الإنسانية في محيطها بأشيائه وكائناته ومظاهره، وتلك طبيعة كل الفنون التي تصنف ضمن “النمط المحاكي”.”فالنسق الإيحائي يتشكل داخلها إما من رمزية كونية، وإما من بلاغة خاصة بمرحلة بعينها. إنه يتشكل عامة من خزان من المسكوكات القبلية ( الشيم والألوان والغرافيزم والإيماءات والتعابير” (27).
ويستمد هذا الحكم كامل مبرراته من طبيعة الإيحاء ذاته “فالسنن الدال عليه ليس لا “طبيعيا” ولا “مصطنعا”، إنه تاريخي، أو إن شئنا، إنه ثقافي؛ فالعلامات داخله هي إيماءات ومواقف وتعابير وألوان وآثار تتمتع “بمعنى” استنادا إلى الاستعمال الاجتماعي” (28)، لا إلى وجودها المادي. فليس غاية الصخرة أن تدل على الصلابة أو القسوة، ولم يخلق الحرير لكي يكون رمزا للنعومة، بل هي رغبة الذات الإنسانية في أن تسقط جزءا منها فيما هو موجود خارجها واستعادته بعد ذلك وقد “تأنسن” واستوطن مواقع داخل التبادل الاجتماعي.
وتأويلات هايدغر مشهورة في مجال الفنون التشكيلية. فقد أراد من خلال قراءته الهرموسية للوحة لفان غوغ Van Gogh ( تمثل حذاء) الكشف عن “كينونة المنتج” من خلال ظاهره، كما يتسلل إلى اللوحة ( الصورة عامة) لا كما هو موجود في الواقع. وهذا التحول في هوية الشيء لا يمكن أن يقوم بها سوى الفن. “فالفن عنده لا يمثل شيئا، بل “يرشدنا إلى حقيقته”، فاللوحة في هذه الحالة لا تستنسخ الحذاء ولا تمثله في نوعيته، إنها “تقول لنا” الجوهر الاستعمالي للشيء، حقيقة كينونته (….)، وتشكل هذه الحقيقة الأفق الهرموسي الذي يندرج ضمنه المُنْتج، وهذا الأفق الهرموسي هو عالم الفلاحين” (29). والصورة الإشهارية تعرف ذلك جيدا : فالمنتج لا يمكن فصله عن الخطاب الحامل له، والخطاب هنا هو الآليات التي تشتغل من خلالها الصورة وليس شيئا آخر (30).
وهناك من حاول الذهاب إلى ما هو أبعد من تصنيف ثنائي للمعنى، جانب إخباري يصف ما تمثله الصور، وآخر رمزي يدرج الموصوف ضمن سجلات غير مرئية في الظاهر. وهي ثنائية يعتمدها الكثيرون في تحليلاتهم بعد أن أشاعها بارث من خلال قراءاته في السرد والصورة: الموضة والإشهار والقصة. وبارث نفسه هو من حاول التشكيك في هذه الثنائية التقليصية من خلال الإشارة إلى “معنى ثالث”. فالوجه الأول للصورة دال على الإخبار، وهو ما يمكن أن تلتقطه العين المبصرة خارج كل المقاصد الممكنة؛ أما الوجه الثاني، فيحتضن الرمزي بكل امتداداته، ويتعلق الأمر بمحاولة إدراج الممثل ضمن سياقات تشيدها النظرة المؤولة؛ ثم هناك مستوى ثالث، هو نقيض الأول، ولكنه ينزاح عن الثاني أيضا. ويدل على معنى من طبيعة خاصة. إنه يختفي في جزئيات الأشياء والكائنات، في وجوهها وهيئتها ونظراتها. إنها عناصر تفلت من العين العادية ولا تلتقطها سوى العاشقة من العيون. إن هذا المعنى شبيه بما يمكن أن تحيل عليه “العلامات النوعية” التي تحدث عنها شارل سندرس بورس في سميائياته حيث يمكن لنوعية ما ( أحمر يكسو هذا البلاط، أو صرخة تمزق سكون الليل ولا نستطيع تحديد مصدرها ) أن تشتغل باعتبارها علامة، أي حاملة لانفعال يؤول باعتباره معنى مضافا يتجاوز الصرخة ذاتها. إنها انفعالات لآثار غير قارة، أو انفعالات لا يمكن تحديد مصدرها.
لذلك ليس هناك في تصور بارث ما يصَدِّق على هذا المعنى، وليس هناك ما يدل عليه، وليس هناك مدلول بعينه، ولكنه موجود، ويشكل أفقا لسيرورة تأويلية لا يمكن للعين أن تتجاهلها أو تتنكر لها. وهي حالة الصورة التي تمثل للقيصر إيفان الرهيب والوصيفان يصبان عليه أكياس الذهب في فيلم إزنشتاين الذي يحمل الاسم ذاته عنوانا له (31).
والأصل في هذا التمييز بين المدرك وبين ظلاله الدلالية هو ما أشرنا إليه أعلاه. فلغة الصورة ليست شيئا آخر غير ما يمكن أن يكشف عنه الممثل داخلها. فهي تلتقط “الاستعمالات الرمزية” للأشياء والكائنات، وتستعين بدلالات الشكل واللون والخط والتركيب والإضاءة، وهي كلها عناصر مدرجة ضمن جزئية فضائية محكومة بمبادئ المنظور والمجال وعمقه، ومحكومة بكل الدلالات المكتسبة أيضا.
بل إن الوجود الإنساني ذاته ليس سوى مجموعة من المواقف والوضعات والإيماءات التي برمجتها الثقافة وحولتها إلى سلسلة من الأسنن نؤول وفقها حالات الإنسان ووجدانه. إن هذه العناصر مجتمعة تأتي إلى الصورة محملة بدلالات لا تقوم الصورة إلا بالتأليف بينها من أجل بلورة وحدتها وانسجام أكوانها الدلالية. وفي هذا السياق يتحدث بارث عن “وضعة الأشياء” (32) لا عن وضعة الإنسان فقط، فلا خلاص للأشياء خارج دوائر الإنساني: التسمية والتصنيف والأفق الرمزي. فنحن في جميع الحالات “نتحدث داخل عالم، ولكننا نبصر داخل آخر، فالصورة رمزية، ولكنها لا تمتلك الخصائص الدلالية للغة، إنها تشكل طفولة العلامة. إن طابعها الأصيل هذا يمنحها قوة تواصلية لا مثيل لها “(33). وهو ما يقوم هذا الكتاب بتفصيل القول فيه.
********
لا يناقش هذا الكتاب كل الأفكار الواردة في هذه المقدمة، ولا يتناول كل القضايا التي أشرنا إليها في ثناياها، لقد أردنا من خلالها أن نضع الكتاب ضمن سياق عام يشمل التقنيات التصويرية (أدوات إنتاج المعنى)، وهي القضايا التي توقف عندها المؤلف مطولا، ويشمل قضايا الإدراك كما يمكن أن تتحقق من خلال البصري بكل تنويعاته. وهي السياقات التي لا يمكن لأي دارس للصورة أن يتفاداها أو يقول شيئا خارجها.
إن الصورة هي في المقام الأول أداة تعبيرية، ولا تختلف في ذلك عن باقي أدوات التمثيل الرمزي التي يتوفر عليها الإنسان. ولكنها لا يمكن أن تنفصل أيضا عن كل العمليات التي تقود إلى استنساخ واقع أو إعادة إنتاجه أو التمويه عليه من خلال المضاف التقني، بما فيها صناعة المشهد والوضعة وزاوية الرؤية، بل قد يصل بها الوهم إلى التصريح بإمكانية استعادة هذا الواقع كما هو، استنادا إلى رؤية “وفية”، كما ألحت على ذلك كل التيارات “الواقعية” التي جاهدت لكي تجعل الصورة أداة للتعبير عن واقع- كما تراه- وترويضه وتوجيهه وفق غايات إيديولوجية مسبقة ( الفصل 10 من الكتاب).
ولكنها تعد أيضا موضوعا للحلم ( الحلم الفرويدي ونمط بنائه للمضمون الظاهر في علاقته بالمضمون الكامن)، أو موضوعا للاستيهامات التي تنزاح عن المألوف، وهي الصور التي تستقي مادتها من العجائبي والديني والوهم والعصاب وصور منبعثة من الداخل لا تحتكم لقوانين الفضاء والزمان ( الفصلان 14 و20) ( صور الشياطين والعفاريت، أو صور الأولياء الصالحين، ” علي ابن أبي طالب يقتل رأس الغول”).
لذلك، فإن التحليلات الواردة في هذا الكتاب تقود بالضرورة إلى استحضار مجمل القضايا التي أشرنا إليها في هذه المقدمة. فالكتاب يتوقف عند قضايا تبدو تقنية في الظاهر، لكنها تحيل في العمق على التصورات التي صاغتها الثقافة حول الفضاء والزمان والأشكال والألوان والخطوط، وكل العناصر التي تستعيدها الصورة من أجل بناء عوالمها الدلالية. فالمعنى في الصورة، وفي كل الأدوات التعبيرية البصرية يستند إلى معرفة سابقة، هي الدلالات التي منحتها الثقافة للأشياء وهيئات الإنسان وكذا عوالم التشكيل. إن الأمر يتعلق بدلالات مكتسبة تجاهد الصورة انتشالها، من خلال التمثيل التشخيصي، من بنيتها الأصلية وإدراجها ضمن بنية أخرى تمنحها خصوصية وتغني من أبعادها.
ولقد توقف الكاتب مطولا عند عنصرين يعدان، في مجال التعبير البصري، دعامتين يمكن من خلالهما قراءة الصورة وتحديد طبيعة الفضاءات الممثلة داخلها، ويمكن أيضا من خلالهما تحديد تاريخ الصورة والتأثيرات التي كانت مصادرها الدين والثقافة والإيديولوجيا: العمق والمنظور. ولم يتوقف المؤلف عندهما لكي يحلل أبعادهما في التشخيص وإنتاج المعنى فقط، إنه فعل ذلك لكي يبرز الاختلافات الحضارية بين نمطين في التعاطي مع التعبير الأيقوني: تصور الشرق ( الصين واليابان أساسا ) الذي لا يكترث للمنظور ويتعامل مع العمق استنادا إلى تصنيفات اجتماعية تثمن الشخص المصور وفق انتمائه الاجتماعي لا استنادا إلى موقعه في الصورة؛ وتصور الحضارة الغربية التي تبنت المنظور وصاغت وفقه تصورها للفضاء والكائنات، واعتبرته معطى موضوعيا من طبيعة كونية. وبذلك كانت، كعادتها، تنتقل من المحلي إلى الكوني استنادا إلى هوس داخلها يميل إلى تعميم كل القوانين التي أفرزتها سياقاتها التاريخية والثقافية تلبية لحاجات محلية وفرضها بجميع الوسائل على الآخرين باعتبارها تنتمي إلى حقل “الكوني”، كما يقول المؤلف.
لذلك، فإن حالة الصورة، كما حاولنا رسم بعض مفاصلها، تاريخها ووضعها وموقعها في الذاكرة والوجدان، تقتضي تحديد آليات اشتغالها وإنتاجها لمعانيها وطرقها في الإقناع والتضليل أيضا. فدراسة الصورة هي في واقع الأمر محاولة “للكشف عن الأسنن اللامرئية التي تتحكم في المرئي” (34)، أي الكشف عما يحدد مجمل آليات التمثيل والنقل الفني من عالم الأشياء إلى عالم النظرة. وبعبارة أخرى، يجب تحديد الروابط الممكنة بين البصري والمرئي، أي بين الصورة وبين ما يلج عوالمها لا باعتباره تمثيلا لشيء، وإنما باعتباره أداة تعبيرية تقود إلى الكشف عن الدلالات لا عن وضع الأشياء. وهو ما قدم الكتاب في شأنه سبلا تحليلية ومقترحات نظرية، ومعرفة تخص مكونات الصورة، كما تخص الثقافة التي يجب أن يتوفر عليها القارئ لكي يكشف عن الوجه المخبأ في الصورة: الفضاء والزمان في مرحلة أولى ( الجزء الأول)، ونظرة تاريخية تحليلية تحاول الاستفادة من العلوم المجاورة ومنها اللسانيات والأنتروبولوجيا والتحليل النفسي، والسميائيات في المقام الأول ( الجزء الثاني).
لقد كان هذا التصور يعني عند المؤلف التخلص من بعض الإكراهات، ومنها ضرورة استبعاد الروابط الممكنة بين البصري واللفظي، فاللفظي ليس حاضرا في الصورة إلا لحظة الاستقبال حيث يقتضي فك التسنين الاستعانة بنسق يحول مضامين أيقونية وتشكيلية إلى معادلاتها اللفظية الممكنة ( الموقع المميز للسان داخل وقائع الإبلاغ الإنساني). وهو أمر لا يستنفد كامل ممكنات الصورة، فما يتسرب إلى الوجدان لا يمكن، إلا من باب التقريب، إفراغه في نسق ليس من طبيعة الصورة، ولا يشتغل وفق قوانينها، على الرغم من “أن الإدراك لا يمكن أبدا أن يتم دون مفهمة مباشرة ” (35).
والأمر ذاته يصدق على الروابط الممكنة بين الصورة والواقع. فالحديث عن هذه الروابط لا يقود إلا إلى طرح قضايا خاصة بأنطولوجيات الأشياء والكائنات، ما دام التشابه أو المماثلة أو الاستنساخ لا يمكن أن تتحقق جميعها إلا من باب التوسل بأداة ( الواقع) هي ما تحاول الصورة تجاوزها. فما نبحث عنه في الصورة ليس واقعا، فالواقع في نهاية الأمر بين أيدينا وأعيننا، بل نروم الإمساك بسلسلة من الدلالات التي لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال التعرف على اللغة البصرية وطريقتها في التأليف بين الوحدات المكونة للصورة. فللصورة مداخلها ومخارجها أيضا، رغم أن تنظيمها الفضائي يوهم بتزامنية في التلقي والإدراك. وقد قدم الكتاب في هذا السياق دراسات غنية وعميقة لبعض الصور، كما يمكن أن تحيل على معانيها وكما يمكن أن تدرك في علاقتها بصور أخرى تنتمي إلى الثيمة ذاتها ( ما يطلق عليه لوحة النوع) (الفصل 11).
لذلك يمكن القول إن الكتاب هو، بشكل من الأشكال، إجابة وافية عن السؤال الذي طرحه بارث في الستينيات من القرن الماضي: كيف يأتي المعنى إلى الصورة ؟ لقد كان جوابه آنذاك ناقصا، ( محدودية الجواب الذي قدمه تعكس محدودية التصور الذي انطلق منه في تلك المرحلة، فلم تلتفت السميولوجيا إلى الجانب التشكيلي إلا في العشرية الأخيرة من القرن العشرين ) (36). ومن هذه الزاوية، يعد هذا الكتاب مساهمة نوعية يمكن تقدير مردوديتها من خلال الأسئلة التي تطرحها لا استنادا إلى كمية الأجوبة التي تقدمها. فلم يعد ممكنا أن يقف التحليل عند رصد دلالة الأشياء والكائنات وممكنات التأليف بينها، كما لم يعد إسقاط الحلول “اللسانية” كافيا للدفع بالصورة إلى تسليم كل مفاتيح قراءتها. لقد أصبح للمستوى التشكيلي دور هام يهدي، بطريقته ووفق قوانينه، إلى تلمس الدلالات المتنوعة في الصورة. إنه إحالة على كل ما يشير إلى الآثار التي تركتها الممارسة الإنسانية في المظاهر التي تحضر من خلالها الأشياء في العين والنظرة (الفصول 15 و 16 و 17 مخصصة لدراسة الأشكال والخطوط).
كما لم يفت الكتاب الالتفات إلى القضايا الخاصة بالدور الدعائي ( الإشهاري) الذي تقوم به الصورة. وفي هذا السياق تناول المؤلف خصوصيات صورة الموضة: خصوصية المشهد، وخصوصية الديكور وخصوصية الوضعة. وهي عناصر تبدو في الظاهر تقنية لا تخص سوى وضع الصورة، في حين أن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق، إنه يحيل على وضع المرأة في المجتمع والسيرورات العسيرة التي قادت إلى تحررها وانعتاقها من المسبقات الاجتماعية. “فكما كان مطلوبا من موديل 1911 الدلالة على الثبات والتحفظ الذي يميز بعض صور المرأة في بداية القرن، أصبح مطلوبا من موديل 1981 الدلالة على الحرية وانطلاق امرأة نهاية القرن “( الفصل 12 ). فما يتم تمثيله في الصورة ليس امرأة، بل سلسلة من المواقف وكل أشكال السلوك الإيمائي ( طريقة حضور الجسد في الصورة دال على حالة من حالات الوعي الاجتماعي).
وفي السياق ذاته يشير المؤلف إلى نمط بناء الصورة الإشهارية وطرق حضورها في العين. فالنموذج الممثل وكذا الإطار الطبيعي المحيط به لا يمكن فصلهما عن الغايات التجارية. لذلك، فإن الصورة الإشهارية، على عكس اللوحة أو الصورة الفوتوغرافية أو حتى بعض حالات الصورة الصحفية، لا تقدم نموذجا يجب التوقف عنده، فالنموذج عندها يجب أن يظل مجهولا، إنها لا تقول لك: تأمل جمال هذه المرأة، بل تقول لك: تعال عندنا، “فالزبون المحتمل الذي يتوقف عند جاذبية النموذج يمكن أن يكون زبونا سيئا للمؤسسة واختارت هذه الصورة غلافا لكاتالوغها” ( الفصل 11).
وليس غريبا أن تكون الصورة، استنادا إلى كل التحديدات السابقة، أداة للتحكم والتضليل والتوجيه. فكما يمكن أن تكون نافذة تطل من خلالها الذات على عوالمها الأكثر إيغالا في القدم، يمكن أن تكون أداة لكل أشكال “الإقناع القسري” الذي يحدد للذات أشكال ردود أفعالها. ويكفي أن نشير هنا إلى الصورة الإشهارية وآلياتها في الإقناع وفي خلق حاجات للاستهلاك بشكليه الفعلي والرمزي.
ويمكن القول في الختام إن هذا الكتاب يعد إضافة نوعية إلى كل الكتب التي تناولت الصورة. فهو لا يكتفي بالتأريخ للصورة، ولا يكتفي بتحديد الدور التربوي أو التعليمي أو التوضيحي الذي يمكن أن تضطلع به، إنه، بالإضافة إلى ذلك كله، يقدم لكل المهتمين بالميدان البصري السبل التي تساعدهم على فهم لغة الصورة ووسائل الإقناع عندها. إنه يعلمنا كيف نقرأ الصورة، ويعلمنا كيف نلجها ونحدد مجمل مسارات التأويل داخلها.
ونتمنى أن نكون، بهذه الترجمة، قد أسهمنا، من موقعنا، في مد قراء العربية بما يساعدهم على فهم لغة العصر الجديدة، وهي لغة لا تستأذن القارئ ولا تستشيره، ولا يمكنه من جهته أن يتجاهلها، فكل ما يحيط به تسكنه الصورة، وكل ما يأتي إلى عينيه ليس سوى صور صريحة أو مقنعة. لقد استطاعوا بالصورة وحدها، أي بألوانها وأشكالها، أن يستثيروا فينا بقايا الأسلاف من الحيوانات، فرد فعلنا تجاه المثيرات البصرية ليس غريبا عما تستشعره مجمل الكائنات الأخرى غير العاقلة. فالصورة كما حاول المؤلف إثبات ذلك، هي مصدر الانفعالات بامتياز. لذلك فإن المقاومة لا تبدأ بالرفض، بل بالتعرف على طاقات الإقناع والتضليل داخلها. وهي مقاومة لا يمكن أن تتم إلا من خلال معرفة لغة الصورة.
——
هوامش
1- Guy Gauthier : Vingt leçons sur l’image et le sens , éd Médiathèque, 1982, 186
2- نفسه، ص 84
3- Lavaud.Laurent: L’image, éd Flammarion, 1999, p14
4- Régis Debray : Vie et mort de l’image, éd Folio, Paris 1992, p.66
5- نفسه ص67
6- Jean Baudrillard : De la séduction , éd Galilée, Paris 1979, p.19
7- Régis Debray ,p.71
8- نفسه ص63
9- Guy Gauthier : Vingt leçons sur, p.110
10- ابن جني : الخصائص، دار الكتاب العربي، الجزء الأول، ص 247
11- David Le Breton : Des visages, éd Métailié, Paris 2003, p 149
12- David Le Breton : Des visages, p. 150
13- نفسه ص 15
14- نفسه ص 104
15-, p.171 Guy Gauthier : Vingt leçons sur
16- André Leroi-Gourhan M Le geste et la parole ,I Technique et langage, éd Albin Michel, 1964, p 263
17- نفسه ص 263- 264
17- أومبيرتو إيكو : العلامة، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 2007، ص206.
19- نفسه ص 206.
20- Lavaud.Laurent: L’image, éd Flammarion, 1999, p88
21- إيكو نفسه ص 206.
22- النص مأخوذ من كتاب حول السحر ذكره : إدمون دوطي : السحر والدين في إفريقيا الشمالية، ترجمة فريد الزاهي، منشورات مرسم، 2008، ص 53.
23- Lavaud.Laurent: L’image, p.16
24- Lavaud.Laurent: L’image, p.16
25- Group µ : Traité du signes visuel, pour un rhétorique de l’image, éd Seuil, 1992,p.23
26- Pierre Fresnault-Deruelle : L’éloquence des images, Images fixes III,éd P U F , 1993, p.104
27- Roland Barthes : L’obvie et l’obtus, Essais critiques III, éd Seuil , p.11
28-نفسه ص20
29- Jean-Marie Schaeffer : L’image précaire, Du dispositif photographique, éd Seuil,1987, p196
30- انظر كتابنا : الصورة الإشهارية : آليات الإقناع والدلالة، المركز الثقافي العربي، 2009.
31- Barthes , op cit , pp43-44
32- pose des objets بارث المرجع السابق ص 16
33- Régis Debray : Vie et mort de l’image, p 60
34- Régis Debray : Vie et mort de l’image, p 28
35- بارث المرجع السابق ص 21.
36- انظر كتاب جماعة مو المشار إليه أعلاه.