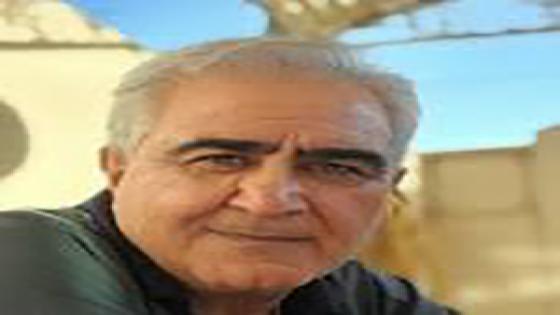سعيد بنگراد
يشير جان جاك روسو في كتابه ” قول في أصل اللغات” إلى فكرة تداولها الكثيرون بعده، مفادها أن الحاجات النفعية عند الإنسان هي التي كانت وراء تشكل الإيماءات وتطورها، أما أصواته فهي إفراز خالص للأهواء (1). وهو فصل يجعل اللغة شرطا للوجود ومدخلا مركزيا للكشف عن كل شيء في حياة الإنسان، فعالمه لا يمكن أن يُرى إلا في الكلمات التي تسمي موجوداته وتصفها، وهي بذلك شرط التأنسن والتمدن وابتداع الثقافة وتداول الخبرات ونقلها. فنحن نحس وننفعل قبل أن نفكر ونتأمل.
ودليله في هذا أن عبقرية اللغات الشرقية تتجسد أساسا في كونها تعج بالمحسنات والتشبيهات والصور الاستعارية وغيرها من الصيغ المجازية التي تميل إلى تشخيص الفكرة وتصوير مقاماتها الحقيقية والمحتملة (الصور كيانات انفعالية أما المفاهيم فتمثيل مجرد للكون).
وهي صيغة أخرى للقول، إننا لا نتوقف عن “الاصطدام بالعالم”، أي أننا نحس به ونتعرف على كائناته وأشيائه عبر المنافذ الحسية في المقام الأول، نفعل ذلك باللمس والذوق والشم والسمع والبصر، وذاك ما يشكل الشرط الأدنى في الوجود، إننا نمتلكه ونروضه ونودعه جزءا من انفعالاتنا، ولكننا لا يمكن أن نستحضره في الذاكرة إلا من خلال اللغة، أي في المعنى. “لذلك كانت أكثر الخطابات قدرة على التأثير هي تلك التي تتضمن أكبر قدر من الصور، وكانت طاقة الأصوات كبيرة عندما امتلكت وقع الألوان على النفس” (2). وأمر ذلك بيِّن، “فأشد الانفعالات قوة وعنفا هي تلك التي تكون العين مصدرها” ( أندري فيليبيان).
ومكمن ذلك في طبيعة الأهواء ذاتها، فهي، في تصوره، “تُقرب بين الناس، أما الحاجات فتفصل بينهم. فالحب والكراهية والشفقة والغضب هي التي أنطقت الناس، وليس إحساسهم بالجوع أو العطش. فمن أجل استمالة قلب يافع واستثارة الشوق فيه أو التصدي لعدوان غاشم تمدنا الطبيعة بوسائل من أجل القيام بذلك، إننا نصرخ ونئن ونتأوه ونستشيط غضبا. وتلك كانت أولى الكلمات التي ابتدعها الإنسان، وذاك هو السبب في أن اللغات الأولى كانت غنائية” (3). فما تقوم به الإيماءات هو رصد للعالم من خارجه، أما الأهواء فتستبطن كل حالاته. “إن الطفل يثير انتباه الراشدين بالصراخ أولا، وبعدها يدرك أن التواصل بها أمر ضروري”(4).
وهي الفكرة ذاتها التي عبر عنها هيردر بوضوح حين أعلن أن ” الإنسان كان يتمتع بلغة حتى وهو في مرحلته الحيوانية. فقد كان يعبر عن كافة مشاعر جسده الجامحة العنيفة وكذلك كل أشواق روحه العارمة تعبيرا مباشرا عن طريق الصيحات والنداءات وعن طريق الأصوات الوحشية المبهمة”(5). وهي الصيحات والصرخات التي لازمتنا إلى اليوم. فنحن في لحظات الغضب لا نتكلم فقط، بل نصرخ ونولول، بل إن الصراخ ذاته ليس سوى نداء أو استغاثة أو احتجاج. فاللغة لا تسمي وتصف وتفصل بين الأشياء فقط، بل هي أداة لترويض الانفعالات والحد من جبروتها من خلال تسميتها، وعندما نسمي العالم نمتلكه.
استنادا إلى ذلك لن يكون البكاء أو الضحك سوى شكل من أشكال لغة ينطقها الإنسان بالنخير والشهقات أو القهقهات وحدها. وهو أمر يجسده التقابل بين تجريدية المفهمة والطاقة الهووية في الذات، فضمن هذا التقابل تندحر المفاهيم وتتلاشى لصالح حالات وجدانية متحررة من كل تدبير عقلاني للأشياء. فمادة الإحساس هي معطى خالص يتلقاه الرائي خارج كل الوسائط. فكلما تقلصت المساحات التي تغطيها المفاهيم أو انتفت، تناسلت في النفس صور هي في الأصل كتل انفعالية تستعصي على الفهم أو لا تأويها الألفاظ: فلا أحد أوحى إلينا بالضحك، فذاك رد فعل غريزي فينا، ولكن الثقافة هي التي علمتنا الابتسامة. إن الضحك انفعال عارض أما الابتسامة فوَعْد.
وهو ما يعني أن الحاجة محدودة، أما الهوى فبلا ضفاف، إن الجوع لحظي وعابر في الزمن، أما الأهواء فجزء من وجودنا على الأرض وشكل من أشكال تصريف مواقفنا ومداراة القلق الكامن فينا. يتعلق الأمر بسلوك أولي يُمكننا من التحكم في “الفائض الانفعالي” الذي يغطي عليه العقل أو يصده. وهي صيغة أخرى للقول إن النفعي لا يُمثل سوى أكثر المناطق فقرا في الملكوت الإنساني، وما يتبقى بعد ذلك تؤثثه حاجات أخرى هي أصل التحضر والدافع إلى انفصال الإنسان عن محيط طبيعي أخرس. إن المتعة، لا الحاجة، هي الفاصل بيننا وبين نظرائنا من الكائنات الصامتة.
استنادا إلى ذلك، لن تكون الأهواء سوى ما يمكن تسريبه إلى مناطق جديدة تقتات من المضاف الانفعالي وطاقاته. يتعلق الأمر بـما يأتي به “سحر البيان” وتكشف عنه “غواية الكلمات” وما يستثيره “الإبداع الشعري”، أو يتعلق، فيما هو أبعد من ذلك، بصيغ مجازية نستعيد من خلالها ما ضاع من زمنية لا نعرف عنها أي شيء. هناك الكثير من الأساطير والحكايات التي أرخت لنشأة الكون، ولكنها لم تكن، في حقيقتها، سوى تشخيص مفصل لاستعارات هووية أفرزتها لغة الإنسان نفسه، وذلك دليل آخر على رغبته في استعادة ما خفي عنه وما غطى عليه الدهر، أو ما استعصى على المفهمة وخرج عن طوع التجريد.
وتلك هي كل حالات “الاستهواء”، فجزء كبير من الطاقة التعبيرية للكلمات مستمد من الانفعالات التي ترافقها ( النبر مثلا). لذلك لا يمكن أن نتكلم دون الاستعانة بالحسية الجسدية، بل إن المخاطب نفسه يبحث في هذه الحسية بالذات عن نصيب الصدق في ما تقوله الكلمات أو توحي به. إن الخطيب ( السياسي) لا يُقنع بالكلمات وحدها، بل بالإيماءات المصاحبة لكلماته، ويفعل ذلك بما يأتي من الطاقة الصوتية أيضا، فجزء من المعنى مودع فيها.
وتلك هي ميزة الخطاب الشفهي الذي يروم التأثير في مخاطب لا يكتفي بالاستماع، بل يود الاستمتاع بالفرجة الخطابية الماثلة أمامه ( المقام التواصلي المشخص): إنه خطاب لا يقدم مضمونا فحسب، بل يحرض ويحث ويستنكر وينفي ويثبت بقوة الصوت وانفعالات الجسد. ” فنحن نعرف كيف نتحدث إلى العين أكثر مما نفعله مع الأذن” (6). وذاك هو أصل الشعر أيضا، إنه ليس فكرا، بل هو تشخيص لساني لانفعالات لا تستقيم في الوجدان إلا من خلال صور تستنفر الطاقات الحسية فيها، لذلك لا نقرؤه فقط، بل نتغنى به، تماما مثلما لا نكتفي بتلاوة القرآن وإنما نرتله أيضا.
وقد يشمل الأمر التعرف على الأشياء والكائنات من خلال الصفات أو من خلال ما يصدر عنها (نستعير من الموصوف ما يؤكد وصفه). وقد أشار هيردر في هذا السياق إلى الغنى الذي تتميز به العربية مجسدا في كثرة الأسماء المسندة إلى الكائنات والأشياء من قبيل الأسد والسيف والثعبان وغيرهم، وذاك في تصوره دليل على أن العربية لم تكن في تلك المرحلة قد استكملت تركيزها في تجريدات”(7).
لا يتعلق الأمر في هذه التسميات بطاقة هووية صريحة، كما توهم بذلك فكرة الترادف، ومع ذلك تُعد نوعا من “الحسية” التي نُمسك داخلها بالكون من خلال محمولات وصفات هي السبيل إلى إجلاء جوهر الموجود والكشف عن ماهيته. سواء تعلق الأمر بتحديد للظاهر فيها أو ما عاد إلى حالات النفس عندها.
ووفق هذا التصور لن تكون الحاجات الأولية هي ما دفع الإنسان إلى التحكم في الأصوات وتحويلها إلى أداة رمزية للتعرف على الأشياء والكائنات، وهي ما سيقوم مقامها لاحقا، فالإيماءات وتعبيرات الوجه وكل الطاقات المودعة في الجسد قادرة على تلبية الكثير من متطلبات المعيش النفعي والتواصل مع الآخرين في الوقت ذاته. فلن يموت المرء جوعا أو عطشا، ولن يعرى ولن تأكله الذئاب في بلاد يجهل ما يقوله لسانُ قومها، ولكنه لن يستطيع أبدا تكثيف انفعالاته الأكثر تجريدا وقوة والكشف عنها وتبليغها اعتمادا على ما تقوله هذه الإيماءات فقط.
ذلك أن “الاستهواء”، أي “الطاقة الحسية الأولية” (كريماص)، سابق في الوجود على التجريد المفهومي، إنه يشكل مادة الانفعالات اللاحقة التي لن يستقيم وجودها إلا باللغة. لذلك “لا تشرح الاستعارات ولا تترجم”(8)، إن مثواها في هوى يستعصي في الكثير من الحالات على التحديد المفهومي.
وهذا معناه أن الإيماءة لا تملك قدرة كافية للتنويع من الانفعالات والتمييز بين درجاتها وأشكال وقعها في النفس. فلا وجود لمعادل إيمائي لجملة من قبيل:” رأيت في عينيك شلالات تسقط من أعلى، وكنت في عينيك رذاذا”. فهذا مضمون هووي لا يستقيم إلا من خلال لغة تشخصه في الكلمات. إننا نأكل بالطريقة ذاتها ( أو تقريبا) ولكننا نحب بطرق تتعدد بتعدد حالات الهوى، فالحب في العربية شغف وصبوة وهوى وعشق وكلف وهيام ووجد وتتيم وجوى وصبابة وحالات أخرى لا نعرفها. وفي كل هذه الحالات يحضر المحبوب في القلب من خلال كم انفعالي مخصوص، لا يتعلق الأمر بعشق بلا ضفاف، بل بسبيل يمكن أن يقود إليه.
لذلك لن تستطيع روافد الجسد وحدها تبليغ ما يمكن أن تقوله الأهواء، ولن تكون ممرا إلى فكر تجلوه المفاهيم وتكشف عن مضمونه. ستظل اللغة في كل حالات الانفعال الفردي وفي حالات الاجتماع الإنساني وسيلتنا الوحيدة من أجل الكشف عن كل ما يمكن أن يقوله الجسد الحاس. فلا شيء فينا وفي العالم يمكن أن يُستبطن أو يطفو خارج لفظها وتركيبها ودلالاتها؛ ولا شيء يمكن أن يُدرك أو يُكشف عنه في الوجود خارج تقطيعاتها المفهومية. إنها، في كل حالاتها، ومن خلال مستوياتها، نظام يُفرض على ما يمْثُل أمام الحواس سديميا متعددا وموجودا خارج تصنيفاتها.
بعبارة أخرى، إن اللغة وحدها تجعل الإنسان إنسانا، فإذا كانت الانفعالات هي أصل وجودها، فإنها هي التي مكنتنا من التحكم في صبيب هذه الانفعالات وترويضها. إن التسمية ليست تعيينا فحسب، إنها، بالإضافة إلى ذلك، فصل وتمييز، وهي وسيلتنا أيضا في الإحاطة مما نقوم بوصفه أو تعيينه.
لذلك كانت هذه الحسية الهووية عصب الفن وطاقته الأولى، فليست الحساسية مجرد كتلة من الانفعالات الغامضة، إنها قد تكون هي الأخرى مصدرا من مصادر الحقيقة، فهي لا تستطيع الكشف عن نفسها إلا من خلال ما يمكن أن تقوله المفاهيم عنها.
وتلك هي قوة اللغة وذاك سلطانها، إنها هي ما يروض الوجود الطبيعي، وهي ما يوجه الحواس ويؤنسنها ويميز بين حالاتها؛ إنها حاضرة في مدار الرؤية، وفي ما يحدد مناطق السمع والشم واللمس والذوق. وهي حاضرة كذلك في صياغة كل الانفعالات التي يجب أن تُترجم لفظا لكي توجد ويتميز من خلالها هذا الحس عن ذاك. ودونها لن يكون الحسي سوى منافذ خرساء لا تعي ولا تُدرك إلا ما يأتي إليها بعيدا عن كل الوسائط.
بعبارة أخرى، يستطيع الإنسان، داخل اللغة وحدها، تنظيم جنسه ونسله وأقاربه وحياته وموته، ومن خلالها يحكم ويصنف ويرفض ويقبل أيضا. فنحن في جميع هذه الحالات منتجات لغة لا شيء يمكن أن يستقيم خارج حدودها بما فيها كينونتنا. استنادا إلى ذلك ستكون هي المصفاة التي يتسرب من خلالها الإدراك الحسي إلى الذهن لكي يستوطن المفاهيم المجردة.
—–
1-J . J . Rousseau : Essai sur l’origine des langues , éd Folio , p.66
2-نفسه ص62
3-نفسه ص 67
4-A Kibedi Varga : Discours, récit, image, éd Margaga bruxelles , 1989, p.7
5-ذكره إرنست فيتشر : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، ص 38
6-روسو نفسه ص 62
7-فيتشر ص39
8-محمد الولي : “الاستعارة بهويات متعددة” مجلة علامات العدد 53 ، 2020، ص 23