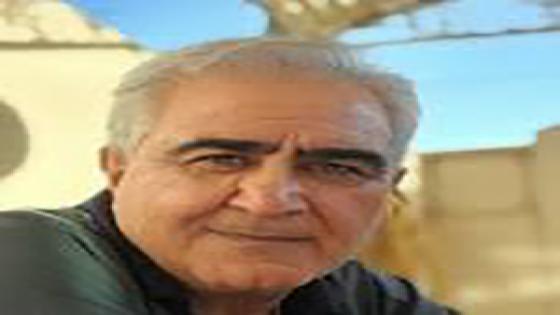سعيد بنگراد
هناك تفاوت كبير بين التقدير التحليلي للعمل الفني وبين الحكم الانطباعي عليه( جون دوي)، فالثاني انفعال خالص يقود إلى اللذة العرضية وحدها، أما الأول فيحاول ترجمة المتعة إلى مفاهيم تُجرد المشخص وتُجلي مضمونه، ذلك أن وجود التجربة لا يستقيم إلا إذا كانت قابلة للتعميم، وذاك شرط من شروط انتشار الذات في ما هو أبعد من ملكوتها الخاص. فقد يكون الانفعال فرديا دائما، وهو كذلك حقا، ولكنه لن يستقيم إلا إذا استمد مضمونه من صيغ انفعالية مجردة يشترك فيها جميع الناس.
لذلك قد يكون بمقدور الفرد الاستمتاع بلوحة تعُج بالأشكال والألوان دون إدراك مسبق لدلالات ما يُكوِّنها، وقد يكون بإمكانه الطرب لقطعة موسيقية ليست سوى استعادة فنية لما يزخر به الوجود من طاقة “هوائية” خالصة، ولكنه إذا أراد أن “يحلل”، أي أن يبحث عن سر الانفعال وكنهه، فإنه سيكون مضطرا في الحالتين معا لتَدَبُّر أمر الدلالات في الأولى، وتحديد طبيعة العلاقات الممكنة بين كل العناصر المسؤولة عن تحول “الهواء” إلى إيقاع تستمتع به الأذن، في الثانية. فقد يتلذذ الإنسان بطاقة انفعالية حدسية لا حدود لها، ومع ذلك لن يكون بإمكانه، في غياب معرفة تقود إلى التعرف على الشكل التجريدي للخبرة، مراكمةَ خبرة جمالية قابلة للتداول بين جميع الناس.
تلك في ما يبدو هي الحدود الفاصلة بين ما يُصنف ضمن وعي جمالي يضع الفن خارج كل الدوائر سوى دائرة المتعة ذاتها، وبين النظر إليه باعتباره مصدرا من مصادر الحقيقة، أي بين من يرد الفن إلى الفن ذاته، خارج كل الوظائف، وبين من يجعله أداة لإنتاج الحقائق وتداولها (غادامير). فليس هناك سبيلا واحدا إلى الحقيقة، هناك سبل متعدد تقود إليها، ومنها سبيل الفن ذاته؛ بل إن ما يأتي من الفن قد يكون أعمق بكثير مما يمكن أن تفرزه المخابر العلمية. ذلك أن الفن ليس تجربة علمية “باردة” تتم بعيدا عن دفء الحياة وتعدد واجهاتها وتنوعها، بل هو خبرة إنسانية عامة يمكن تلمس وجودها في كل ما ينتجه الفرد ويتقاسمه مع غيره خارج قواعد الإبلاغ النفعي وإكراهاته.
نحن مشدودون إلى ما يأتينا من الطبيعة أو ما يفرزه وجودنا داخلها. وفي حالات الفن وحده نستطيع، من خلال الشكل الجمالي الخالص، خلق حالة تقودنا إلى امتلاك ما يَمْثُل أمام العين “حافيا” بلا تداعيات سوى تداعيات الوجود المادي ذاته، إنها حالة خاصة تشير إلى تماس مباشر مع الأشياء، ما كان يسميه هيجل ” العيان العيني وتمثل الروح المطلقة في ذاتها باعتبارها المثل الأعلى”، أو ما يطلق عليه كانط ” الإحساس الذي يُعد معطى خالصا يُنظر إليه كما يمكن أن يتلقاه الرائي خارج كل الوسائط”، أو هو ” عرض للكمال الحسي ” ذاته، كما يقول شنايدر. يتعلق الأمر في هذه الحالات مجتمعة، بما يشبه “التجربة الحية” التي تتحقق في الانفعال والمتعة والنشوة، وكل ما يقود إلى الضياع أو التلاشي في لحظة تتحقق خارج الزمنية المألوفة: إننا نضع، في الفن، الحسيَ في مقابل الحسي خارج وساطة المفاهيم.
فكل عمل فني هو في الأصل “خرق للقواعد الرمزية التي تحتكم إليها التجربة الواقعية من حيث هي امتثال لقواعد تفكير عقلي خالص. فقوى المخيال تكمن، ظاهريا على الأقل، في استعادة التجربة الواقعية وإعادة صياغتها وفق أشكال لا تكترث للضوابط التي تقيمها العلاقات المنطقية بين الأشياء” (1)، إنها العودة إلى الحسي قبل أن يخضع للتنميط، وعودة إلى الانفعال قبل أن تمسك به اللغة وتحنطه في صيغ محددة ستكون هي الحاجز بيننا وبين الأشياء، كما هي قبل أن تخضع للتحديد الرمزي: “إن المخيال هو حالة رغبة جامحة لا تعرف موضوعها. إنها تريد كل شيء في الحال وبشكل مباشر لا يقبل التأجيل”(2).
بعبارة أخرى، نستطيع من خلال الفن أن نعيد إلى النفس طاقتها الإبداعية الأولى كما يمكن أن تتحقق من خلال الحسي فيها. ففي البصري، وفي كل المنافذ الحسية أيضا، نضع الذات في مقابل ما يأتيها من خارجها في استقلال عما يمكن أن تقوله اللغة أو توحي به. فالعين تذهب إلى موضوع نظرتها متحررة من كل أغطية الوجود سوى غطاء النظرة فيها. ومع ذلك، لا يمكننا أن نصف هذه التجربة إلا من خلال العودة بها إلى ما يرسم حدودها ضمن شبكة رمزية جديدة تتحقق وتُتداول داخلها. تمكننا هذه الحركة من تقديم تصورات جديدة عن البعد الواقعي في العين، أو إن شئتم، إن معرفتنا بالواقعي تزداد غنى، وتتسع دائرة القواعد الرمزية المنظمة للتجربة الواقعية.
وهو ما يعني أن الفن لن يكون مجرد أداة الغاية منها إطلاق العنان لطاقات هوَوَية تعوزها الضوابط المرجعية، ومنها مرجعية الفضيلة والحقيقة. إنه في الأصل إحالة على موضوع جمالي يمكن استيعابه داخل ممكنات تجربتنا الحياتية، فخارج هذه التجربة ستضيع الحقيقة وتتساوى كل المعاني. فكما نُهذب الوجود من خلال صبه في مفاهيم اللغة، فإننا نُهذب الحواس من خلال التصرف في معطيات الطبيعة، مصدر الانفعال والأحاسيس الأولية، وتحويلها إلى موضوع جمالي خالص. إننا نمتص من الحسي ذاته صورة عن طاقة فنية تخلص العين من حسيتها. فالعين لا ترى في هذه الحالة، إنها تبحث عن الفن في ما ترى.
لذلك، لا نكتفي بالاستمتاع بالجمالي في الوجود، بل نتعلم من خلاله، بالإضافة إلى ذلك، أشياء جديدة هي ما تكشف عنه التجربة الفنية وتصف حدوده داخل الانفعالات وحدها. فأواني الفخار والتماثيل الصغيرة وبقايا الرسوم على جدران الكهوف شاهد على مضافات الإنسان للطبيعة، لا مجرد جزء من وجود الإنسان على الأرض، أي كشف عن حقيقة وجدانه وهو يحاول رسم أحاسيس لا يمكن أن تستقيم إلا في حضن عناصر الطبيعة ذاتها. تماما كما هو “سحر البيان” و”طاقات الألوان” و”جماليات الأشكال”، إنها جميعها مستودعات لحقيقة روحية لا تسلم أسرارها إلا من خلال طاقات التعبير داخلها.
إن الفن، استنادا إلى ذلك، ليس إحالة على ذاتية منفلتة من عقالها لا تهتم سوى بما يفرز انفعالات محدودة في الزمان وفي المكان، إنه تجربة إنسانية عامة، ولا تشكل الذاتية داخله سوى جزء بسيط هو ما يعود إلى مهارة المبدع وقدرته على التنويع ضمن ما تختزنه أشكال كونية تبلورت ونمت داخل سقف حضاري إنساني مرتبط بالكينونة ذاتها. وهو ما تكشف عنه كل التجارب الفنية بكل أسنادها التعبيرية، لقد تعلمنا معنى الجوع والجريمة والعقاب والنفي والتسلط من نصوص استوطنت ذاكرتنا وسربت إليها نماذج سلوكية لم يكن بإمكاننا إدراك فحواها لولا هذه التجربة. ذلك أن التخييل” يوحي إلينا بأن الرؤية التي نكونها عن العالم الواقعي قد تكون هي الأخرى ناقصة، تماما كنقصان الرؤية التي تملكها شخصيات التخييل عن العالم الذي تتحرك داخله. ولهذا السبب، عادة ما تصبح الشخصيات التخييلية الكبرى نماذج للشرط الإنساني “الواقعي””(3).
بل أدركنا سر الانطلاق والاندفاع إلى أمام كلي كما يمكن أن يستثيره “القلق” الذي يسكننا ويقودنا دوما إلى المستقبل الحاضن لفنائنا الحتمي، حيث انكماش الجسد وضموره وتراجع القوة فينا، وحيث الموت والنهاية في وجودنا لا في الزمن. فهَمُّ الحياة وهم الموت وكل هموم الوجود لا تتسرب إلى النفس ضمن ما تقدمه التجربة الانفعالية المباشرة دائما، بل تستوطن في الكثير من الحالات صورا شتى تحيل على عوالم يصعب عادة تحديد فحواها خارج تجربة الفن.
وهو أمر ينسحب على ما يشكل حالات الأهواء عندنا أيضا، فنحن ندرك فحوى هذه الانفعالات انطلاقا من “كلمات” بسيطة تصف العاشق والمعشوق والحاقد والحاسد والبخيل والغيور دون أن نكون بالضرورة واحدا من هؤلاء أو نكون جميعهم. مواقف كثيرة في التاريخ مازال الناس يرددونها دلالة على وحدة الخبرة الإنسانية وقدرتها على الهجرة من سياق ثقافي إلى آخر. فمازال الذين ذاقوا مرارة الغدر يرددون كلمات جول سيزار، وهو يقول لبروتوس، أحد أصفيائه، وقد طعنه طعنة قاتلة :”حتى أنت يا بروتوس”، وما زال الناس يتغنون بقصص العشاق قي كل بقاع الأرض(4).
وهي صيغة أخرى للقول، إن الفن خبرة قابلة للتعميم استنادا إلى ما كان يسميه غادامير “الحس المشترك”، ذلك الإرث اللامرئي الذي يجمع بين كل الكائنات التي خرجت عن طوع الطبيعة لتكتب تاريخها الخاص. إن محدودية الإنسان وتاريخيته تجعل تجربة الفن ضرورة حياتية، لأنها هي ما يمكنه من استيعاب كل التجارب الممكنة من خلال تجربة واحدة. إننا من خلاله نستعيد حريتنا ونتخلص من إكراهات هي من صلب وجودنا الواقعي. فنحن لا نكترث كثيرا لعبثية المضمون الظاهر للأسطورة، ونحن نتيه داخل وقائعها ونُعجب بصور أبطالها الذي لا يقهرون، ذلك أن المضمون المشخص فيها ليس سوى ممر نحو “حقيقة” تتبلور في الرمز وفي كل التمثيلات الاستعارية.
لا يتعلق الأمر، في جميع هذه الحالات، بتجربة تستنسخ حياة جاهزة، بل تتوقع الآتي وتحث عليه أو تحذر منه. بعبارة أخرى، إن الفن لا يقف عند حدود “استنساخ واقع، إنه يغطي على مظاهر النقص فيه”، كما يعبر عن ذلك كاندينسكي. فهناك دائما “في تجربة الفن تقابل بين ما يشير إلى الانصهار في الواقع، وبين ما يُعتبر سيطرة عليه في الوقت ذاته” ( إرنست فيشر). فلا شيء يمكن أن يقود إلى كمال في الروح سوى تجربة الفن. “لذلك لا يتجاوز حكم السلطة مدارات الواقع، في حين يتحكم المخيال في كل ما تنتجه التجربة الرمزية” (5).
—-
1-Nicole Everaert-Desmedt: Le processus interpretative, Introduction a la sémiotique de c S Peirce, éd Mardaga éditeur,1990,p.104
2-نفسه ص 104
3-أومبيرتو إيكو : اعترافات روائي ناشئ، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 2014، ص 133
4-انظر كتابنا: سيرورات التأويل، من الهرموسية إلى السميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012
5-Jean Baudrillard : De la séduction,éd Galié,1979,p.19