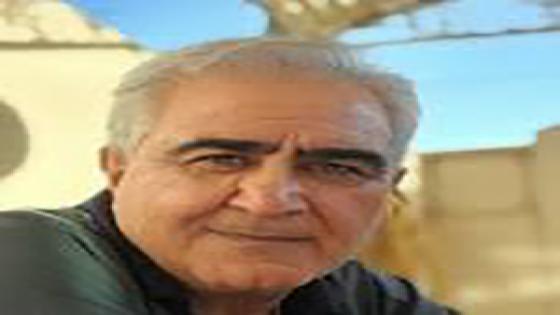4- وماذا يمكن أن تقول عن نزوعات “التدريج” فيما يتعلق بالمقررات المدرسية؟
ج-لا أريد أن أفصل القول في هذه القضية، فقد كتب فيها الشيء الكثير وسبق أن كتبت فيها مجموعة من المقالات وسيظهر قريبا كتاب يتناول هذه القضية بالكثير من الدقة (العربية ورهانات التدريج). وفي جميع الحالات، فإن الداعين إلى الدارجة إما يجهلون أسرار اللغات وطرق اشتغالها، وهذا وارد عند الكثيرين، وإما ينتصرون لما أسميه “النموذج الجاهز”. فعندما تفتقر الدولة إلى مشروع حضارى يُبنى وفق ممكناتها في اللغة والثقافة، فإنها تكون ميالة إلى استيراد كل شيء: السيارات والطائرات والقطارات، وبطبيعة الحال استيراد لغة “جاهزة” يمكن استنباتها في أي تربة دونما اعتبار للثقافة التي تسندها، بما فيها إنتاجها الفكري والأدبي. وهذا يصدق على كل المجالات، بما فيها إصلاح التعليم. فقد ارتبط هذا الإصلاح دائما بوجود نماذج تعليمية جاهزة يمكن استيرادها من بريطانيا أو فرنسا دونما اعتبار لحقائق التاريخ واللغة والعمق الحضاري للوطن. وحالة المؤسسات الخاصة لا تشذ عن ذلك. إنها تخرج تقنيين يجيدون بعض تخصصاتهم، ولكنها لم تنتج أبدا مواطنين جددا يمكن أن يسهموا في بناء صرح حضاري يستمد مضمونه من التربة المحلية.
والتاريخ شاهد على ذلك، فلم تسهم اللغات المستوردة في إفريقيا في إلغاء “حدود” القبائل في الأذهان والمتخيل وفي الصراعات السياسية، والتداول على السلطة. لقد ظل هناك دائما نوع من الولاء للغة الدولة المستعمرة، وهناك في المقابل انتماء قَبَلِي تعبر عنه اللغات المحلية. وهذا الوضع الغريب هو ما يحاول البعض استنساخه في ما تبقى من بلدان إفريقيا، الدول المغاربية تحديدا، فما لم يتحقق بمنطق التاريخ وقوانينه، يمكن أن يُفرض بالإرادة السياسية وحدها.
5- تعني أن مشكلة اللغة هي مشكلة إرادة سياسية أولا وأخيرا؟
ج- ….بطبيعة الحال، فالعربية أُخرجت من الفضاء العمومي بقرار سياسي، صحيح أن هذا الإقصاء لم يتم بصيغة قانونية، ولكنه فُرض بالممارسة، حيث اليافطات والواجهات تبحث في ذاكرة أخرى عما يغري ويشد الانتباه بلغات أجنبية. وإما بدراجة يعتقد البعض أنها تطمئن الناس والجمهور العريض في وضعهم الدوني ككائنات فقدت مواطنتها وتحولت إلى مستهلكين يعيشون من أجل البقاء حده. لذلك لن تستعيد العربية موقعا في الفضاء العمومي إلا بقرار سياسي، ويجب أن يتحقق هذه المرة بقانون يصالح المواطنين مع دستورهم الذي جعل العربية لغة رسمية.
6-يلاحظ من خلال أعمالك محاولتك لفتح الدرس الأكاديمي على قضايا راهنة، نجد هذا في قراءتك لتأثيرات الرقمية وفي تحليلك للإشهار المغربي، والنصوص المدرسية، والخطاب السياسي وحتى قراءتك للدستور المغربي، هل هذا نابع من تصور ما لدور الجامعة والمثقف عموما في ظل طغيان السياسي على المشهد؟
ج-لم تكن المعرفة الأكاديمية منفصلة في يوم من الأيام عن هموم الإنسان في السياسة والاقتصاد والاجتماع. فنحن جزء من السياسة، بل نحن الخلفية المركزية لكل فعل إنساني يسهم في تطور وجود الناس. وسبق أن قال توكفيل عن الذين قاموا بالثورة في فرنسا إنهم لم يكونوا سوى تلاميذ تركوا مدارسهم ونزلوا إلى الشارع. وكان يقصد بذلك أن بسطاء الناس قد يكونون هم وقود الثورات، ولكن المفكرين هم الذين يخلقون التربة التي تحتضن العوالم الجديدة التي تبشر بها. لذلك لم أنظر إلى السميائيات باعتبارها مجرد تأملات، وهي كذلك في جانب منها، بل أيضا باعتبارها أداة للهدم والتقويض وتفكيك الأنساق التي تختفي فيها الإيديولوجيات التي تتحكم في سلوك الناس وتوجهها. فدراستي للإشهار ليست منفصلة عن رغبتي في التصدي لكل أشكال التضليل والتمويه التي تصاغ ضمنها الوصلة الإشهارية، ودراستي للدستور لم تتناول التشريعات والقوانين المنظمة، بل انصبت على النصوص المضمرة التي تحكمت بعد ذلك في كل أشكال التنزيل. إن الأكاديمي ليس مهتما بالسياسة، بمفهومها الحزبي، وليس معنيا بالحقائق التي تروج لها الأحزاب، ولكنه معني بالسياسة حين تكون خلفية يتحدد من خلالها الشرط الإنساني. لذلك يخطئ السياسيون كثيرا عندما يعتقدون أن الفعل السياسي مفصول عن “متاهات” التأمل الأكاديمي. فالتعددية في المعنى ليست مفصولة عن التعددية في الرؤى وفي القيم وفي السياسة أيضا. فعندما نقر أن النص/ الواقعة لا يمكن أن يكون مصدرا لمعنى واحد، فإننا نقر أيضا أن الوجود لا يمكن أن يستقيم من خلال رأي واحد. إن حياة “الجسد الاجتماعي” تكمن في تنوعه لا في وحدانية النشأة. وهذا ما قلته في مقدمة كتابي “وهج المعاني”، بل ربما هذا هو الذي يجعل السياسي ينظر بريبة وحذر إلى المثقف.
7- على ذكر أشكال التضليل والتمويه في الوصلات الإشهارية، ماتعليقك على الإشهارات التي باتت تحتل حيزا كبيرا من حياتنا اليومية؟ وهل المواطن البسيط محصن ضد هذه الألاعيب ويمكن أن نستحضر هنا ما وقع مؤخرا في عملية النصب الكبيرة المعروفة بقضية “باب دارنا” وفيها وقع مئات الناس ضحية لإشهارات مشاريع وهمية؟
ج-في العموم لا يتمتع المغاربة بحماية كافية من ألاعيب الإشهار، ولا وجود لمؤسسة مهمتها مراقبة ما يعرض على المواطنين من إشهار على غرار ما هو موجود في فرنسا ( مكتب مراقبة الإشهار). قد تكون هناك تشريعات في هذا الباب، ولكن لا وجود لمؤسسة تسهر على تفعيلها تابعة للهاكا مثلا يلجأ إليها المستهلكون من أجل حمايتهم. ومع ذلك، فإن قضية “باب دارنا” ليست مرتبطة بلصوصية إشهارية، بل لها علاقة بلصوص حقيقيين سرقوا مالا حقيقيا قد لا يتحمل الإشهاريون أي مسؤولية في ذلك. فالمؤسسة الإشهارية ليست معنية باقتناء الأرض وتجيهيزها وجمع المال وتوزيع القطع، بل معنية فقط بتسويق منتج، وهو تسويق مؤدى عنه. فلا تتحمل المؤسسة الإشهارية مسؤولية حليب فاسد بل الشركة التي توزعه.
8- هذا واضح، لكن نتساءل هنا عن ما يتعلق بقراءة الصورة وفهم أوهامها. ألا ترى أن هناك حاجة لإدماج التربية على التعامل مع الصورة في المناهج المدرسية والجامعية مادام أغلب ما نستهلكه يمر عبر الصورة او المرئي عموما؟
ج-المدرسة المغربية متخلفة، وكذلك الجامعة في برامجها ورؤاها، كما هي كل قطاعات البلاد، بل ليس هناك تفكير جدي في إعادة النظر في المنظومة التعليمية استنادا إلى حاجاتنا نحن، كما يمكن أن تتحقق في اللغة والحضارة والمشترك المحلي. لست ضد الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، ولكن لا يمكن استنساخ تجارب واستنباتها بالقوة في تربة لا تتسع لها أو لا تقبلها أو غير قابلة للتحقق استنادا إلى إمكانات محدودة. ومن هذه الزاوية لا أحد يفكر في الصورة ولا أحد يعتبرها جزءا من آليات التفكير والبرهنة والإقناع، رغم كل ما تقوله المظاهر الخارجية. فلا يمكن أن نتعامل مع الصورة في المحيط إذا كنا لا نعرف طبيعتها ولغتها وقوانينها في إنتاج المعنى وفي تداوله بين الناس. هناك أمية بصرية مُعمَّمَة، ولكنها لا تثير اهتمام أحد، فقد ألِف الجميع العيش داخل صورة توهمهم أنها الحقيقة، كما يفعل ذلك التلاميذ والطلبة والعامة من الناس في المقاهي وهم يعبثون بهواتفهم أو لوحاتهم، ولكن القليل من هؤلاء يدرك طبيعة الصورة وقدرتها على التشويش على الواقع أو تشويهه. فهل ندعو إلى إدخال الصورة إلى البرامج منذ السنوات الأولى في المدرسة؟ وإذا دعونا إلى ذلك هل سيسمعنا أحد؟ لا أعتقد.